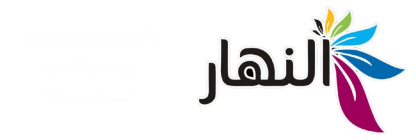واقع المرأة والرجل في رواية “لعبة الدوائر الفارغة” لعلي لفتة سعيد.
قراءة / عبد الرحيم التدلاوي
تنبيه قبل الدخول إلى الرواية:
لا تسعى هذه القراءة إلى تقديم تأويلٍ نهائي لرواية “لعبة الدوائر الفارغة”، بل تقترح الدخول في فضائها بوصفها تجربةً حسّيةً متشظّيةً لا تقبل الترويض التحليلي الكامل. لقد تمّ التعامل مع الرواية كنصّ يتحرّك في عتمة الأسئلة، لا في وضوح الأجوبة، نصّ يتفكّك من داخله، ويستعصي على الاصطفاف داخل البنية التقليدية.
ومن هذا المنطلق، لم أقارب القراءة الرواية من الخارج، بل واكبتها من الداخل أو هكذا أظن ، محاولًا أن أصغي لبلاغة الجسد حين ينوب عن اللغة، وللضمير السردي حين ينقسم، وللزمن حين يتآكل داخل التكرار. كما تنبهت إلى وظيفة الغلاف والعنوان بوصفهما امتدادًا للنص، لا مجرّد إطار له، وإلى استعمال التكرار والانمحاء والتشظّي باعتبارها تقنيات مضمونية، لا زخارف شكلية.
إن الرؤية النقدية هنا لم تنطلق من تصنيف الرواية، بل من الإقامة المؤقّتة داخلها، كمن يسير في متاهةٍ يدرك أنها لا تفضي إلى مركز، لكنها تتيح نوعًا آخر من الإدراك: إدراك القلق، والارتباك، والفراغ الممتلئ بحواسه.
ومن هنا فإن هذه القراءة هي بداية ومرافقة. وكل قارئ يجرّب الدخول إلى هذه الدوائر، سيصوغ تأويله الخاص داخل فراغها، وسيفهم – ربما – أن اللعبة الحقيقية ليست داخل الرواية، بل فينا.
فيما يشبه التقديم:
صارت الحكاية في مسار الرواية العربية الحداثية، مختبراً لانهيار الأشكال، وتجريب الحواف، واختبار المساحات المتروكة في اللغة والهوية والزمن. تنمو الرواية تنمو كبنية، وتتسرّب كهاجس. وحيث تروى الحوادث لترتبك. ولعلّ ما قاله الناقد المغربي محمد برادة في كتابه “الرواية العربية ورهان التجديد” يؤكّد هذا التحوّل حين أشار إلى أن الرواية العربية في أيامنا شهدت بعض التطور في أساليبها السردية، باعتماد السرد المفتوح والمختلط وغير القابل للتصنيف الأجناسي ، في إحالة واضحة إلى مشروع لا يسعى إلى الحكي، بل إلى كشف قلق الحكي ذاته، حيث تتداخل الشذرات، وتتهدم العلاقات، وينكفئ الزمن على نفسه.
مصاحبة الرواية:
في هذا السياق، تنبثق رواية “لعبة الدوائر الفارغة” للعراقي علي لفتة سعيد كعملٍ يتقصّى انهيار المعنى من خلال بلاغة الجسد، وعنف اللغة، وتفكّك الزمان. الرواية تحدّق وهي تسرد، تحكي، وهي ترسم دوائرها في هواءٍ مشّبعٍ باللايقين، وتفكّك الحكاية كما لو أنها تدوّن صمتًا أعلى من اللغة. ليست الحوادث ما يُبنى، بل الحافات والانهيارات.
ومن بين أبرز العناصر التي تنفرد بها الرواية، يبرز التوظيف الذكي للجسد كعلامةٍ سردية، لا كعنصرٍ بيولوجي، وقد حضرت الإيروتيكية بوصفها أداة تمرّدٍ على النسق الاجتماعي والديني والسياسي. وكما يشير الناقد مهدي هندو الوزني، فإن الإيروتيكا في الرواية “ليست جديدة على الأدب السردي العربي، لكنها هنا تشكّل بنية أساسية في النسيج الروائي”، حيث تتحوّل الشخصيات النسائية الثلاث إلى محاور لعب جسدي ورمزي، يفضح المسكوت عنه في علاقات السلطة والجنس والدين”.
وقد سعت الرواية، كما تشير بديعة النعيمي، إلى تعرية المسكوت عنه من داخل المجتمع العراقي ما بعد 2003، إذ تتجاوز مجرّد توصيفٍ الواقع إلى فضح آلياته وتشريح أمراضه. حضور التابو السياسي والديني والجسدي لم يكن توظيفًا مجانيًا، بل نابعًا من رغبة واعية في “كسر الصمت، واختراق الساكن، وفضح المستور”، عبر توثيق مأساة العراق الجديدة بلغة سردية متحررة”.
أما أمل رفعت، فتلاحظ أن “لعبة الدوائر الفارغة” تستبطن دلالاتٍ عميقةً ترتبط بتكرار العنف، وانحناء المصير، ودوائر السلطة التي لا تنتهي، فيما يتقاطع الزمن الكوروني مع تفكك المجتمع وانهيار علاقاته الداخلية، وتكشف الرواية من خلاله عن أقنعة متداخلة من الخوف، والرغبة، والخيانة.
أما طالب عمران المعموري، في مقاله “آلية اللعب”، فقد أضاء العنوان حيث رأى أن المفردات الثلاث: “لعبة/الدوائر/الفارغة” تشكل ثلاث مفاتيح تأويلية، حيث “اللعبة” تُمثل التجريب السردي، و”الدوائر” هي بنية الزمن المغلق، و”الفارغة” تمثل الفجوة بين القول والمعنى، بين الشكل والمضمون، في إشارة إلى هشاشة السرديات المهيمنة.
ويشير إبراهيم رسول إلى تميز الرواية في توظيف تقنية التضمين السردي، حيث لا تروى قصةً واحدة، بل تتداخل الحكايات المتناظرة والتاريخية، في سرد يمتزج فيه المعيش بالرمزي، دون أن يضحي ببنية الحبكة أو بمتعة التلقي. تدخل الكاتب هنا ليس فرضًا على السرد، بل لعبة ماهرة تتيح للشخصيات أن تتكلم، وللمتلقي أن يتورّط.
عتبة الغلاف:
يتقدّم الغلاف الخارجي للرواية بوصفه العتبة البصرية الأولى إذ يقوم بوظيفة الإغراء التسويقي، وفي الآن نفسه ينهض بالوظيفة التأويلية التي توازي ما يقترحه المتن من اضطراب وجودي وتجريد هوياتي. فالوجه الذي يتصدّر الغلاف لا يبدو مكتمل الملامح، بل مائع التكوين، كما لو أنه يوشك على الانمحاء، مرسوم بألوان مائية شاحبة وخطوطٍ متداخلة، تُحيل إلى التباس داخلي يتجاوز الجسد ليتعلّق بماهية الإنسان نفسه. في خلفية هذا الوجه، تظهر ورقة قديمة تُذكّر بزمنٍ هشّ، بذاكرةٍ موشومةٍ بالفقد، وكأن الرواية تكتب على سطح الذاكرة لا من داخلها. حتى صورة المؤلّف المضمّنة في الغلاف تأتي من جهةٍ كتوقيعٍ ذاتيّ محايد، ومن جهةٍ ثانية كجزءٍ من هذا التكوين البصري الذي يصرّ على تحويل الرواية إلى مرآة بين القارئ والكاتب، بين التجربة الشخصية والاحتمال التخييلي.
عتبة العنوان:
كتب العنوان على الغلاف بوصفه مفتاحًا لقراءة المتن: فـ”لعبة الدوائر الفارغة” توليفة تنطوي على مفارقة بين الفعل الطفولي والانخراط الوجودي. فـ”اللعبة” توحي بالخفة، بالحركة، بالتكرار الممتع، بينما “الدوائر الفارغة” تحيل إلى دوران عقيم وجهنّمي مشمول بالعودة المكررة والرتيبة إلى طقوس لا تنتهي، إلى مجازٍ عن العيش داخل نمط لا يقود إلى اكتمال. الشكل الدائري نفسه، برمزيته الثقافية المتّصلة بالديمومة والوحدة، يفرّغ هنا من محتواه، ويعاد تقديمه كحلقة مفرغة من التحقق. وهكذا، تتعاضد دلالة العنوان مع رمزية الغلاف لتقديم الرواية نفسها كحالة استدراج إلى لعب لا ينتهي، إلى زمن دائري لا يمضي، أو إلى سؤال لا يجاب عليه.
وبهذا فان نص الرواية لا يتبع القواعد التقليدية للحكي، بل يشتغل على هشاشة الواقع العراقي المعاصر، محوّلًا السرد إلى مختبر يفكك فيه الكاتب البنى الاجتماعية والنفسية. فهو لا يقدم قصة متسلسلة، بل يغوص في أعماق شخصياتها المأزومة، مستخدمًا الجسد والزمن واللغة كأدوات لفضح المكبوت والمسكوت عنه. إنها رواية تقوم على طرح الأسئلة الملحة حول الإنسان العراقي الذي يرزح تحت وطأة الصراعات، وحول هشاشة الهوية في زمن تتآكل فيه القيم، وتتخذ من عنوانها “لعبة الدوائر الفارغة” استعارة مركزية لحالة من العبث الوجودي.
…………………………………………………………
واقع المرأة والرجل في رواية “لعبة الدوائر الفارغة” لعلي لفتة سعيد. (2-3)
عبد الرحيم التدلاوي
رمزية الستارة:
تحمل الستارة دلالة رمزية مضاعفة وعميقة في الرواية، إذ نجدها تتجاوز وظيفتها المادية كحاجز، لتتحوّل إلى رمزٍ للفصل بين العوالم والوعي. ترمز الستارة في البداية إلى الحاجز النفسي والواقعي الذي يفصل الشخصيات عن العالم الخارجي. ففي زمن “كورونا”، حيث يسيطر الخوف والعبوس، كانت الستارة تحجب ضوء النهار، وتخلق جوًا من الظلمة الداخلية. هكذا، نجد الرواية تصف كيف أن ضوء الظهيرة كان “يتسرب من حافة الستارة وما تبقى من زجاج النافذة الذي أخفته الستارة” ص9.
وهذا ما يؤكّد دورها في حجب الرؤية الكاملة والواقع المليء بالحركة والحياة. وحينما تزيح ساجدة الستارة، فإنها لا تسمح للضوء بالدخول فحسب، بل تسمح أيضًا بدخول حفيف الأشجار وصوت البلبل، مما يمثل رغبتها في التحرّر من العزلة واليأس الذي فرضه الوباء والعودة إلى عالم طبيعي وحقيقي. والحقيقة أن هذا الفعل مارسناه حين كنّا محتجزين بدعوى الحماية من العدوى القاتلة، فكنّا نزيح الستارة لتتدفّق الحياة إلى دواخلنا، حيث كنّا نبحث عما يريحنا من الاختناق، ويبعد عنا الملل، كنا نتابع بدقّةٍ تحليق الطيور وننتششي بتغريدها، ونتابع سير السحب في السماء، وننتشي بزخات المطر، كانت كل الجزئيات التي ما أعرناها اهتماما فيما قبل ذات قيمة كبرى ومنها تعلمنا معنى الحياة واكتساب القدرة على المقاومة.
ومع توالي الأحداث نجد أن الستارة تتوسّع رمزيتها لتشمل معنى الخداع والإخفاء، أليس معنى الستارة هو الحجب والاستتار؟ إن الأفعال التي تجري بالداخل ينبغي ألا ترى من الخارج، ينبغي أن تحافظ على حميميتها، وعلى أسرارها، والجميل أن الأسرار تتجانس والستارة. فالستارة لا تفصل بين الداخل والخارج فحسب، بل تحجب أيضًا الحقائق وتخلق الأوهام. يعكس هذا المعنى بشكل رمزي ما جاء في صفحة 18، حيث تصف الرواية أنها “تتحرّك الستارة بلونها الأزرق الذي يشبه سماء ملبّدة بغيوم سود على شكل نقاط غير مرئية ” ، مما يشي بأن الستارة هنا هي رمز للحقيقة المحجوبة، أو ربما للزيف الذي يختبئ وراء المظهر الخارجي. إن تحريك الستارة أو إزاحتها في الرواية يصبح فعلًا رمزيًا يكشف عن حقائق كانت مخفية، سواء كانت حقائق عن الشخصيات نفسها أو عن واقعها المؤلم. وهذا يؤكد أن الستارة في الرواية هي مرآة تعكس حالة الشخصيات النفسية ورغبتها في الكشف أو الإخفاء، وأن إزاحتها هي خطوة نحو المواجهة والتحرر من الأوهام التي تحيط بهم.
بعد الجسد:
يشكّل الجسد في الرواية فضاءً مركزيًا للصراع والمقاومة، فبدلاً من أن يكون مجرّد وعاءٍ للشخصية، يصبح أداةً للتعبير عن الذات في مواجهة القمع الاجتماعي. فالنص يركز على الملابس “الشفافة” التي ترتديها الشخصيات النسائية، مما يجعلها تبدو “نصف عارية”؛ وهذا ليس للإثارة، بل هو إعلان عن حقّ المرأة في امتلاك جسدها والتعبير عنه خارجًا عن المعايير التقليدية. وفي سياق جائحة كورونا التي تشكّل خلفية للأحداث، يتّخذ الجسد بعدًا آخر من الصراع، حيث يصبح اللمس فعلًا محفوفًا بالخطر، كما تتجلّى هذه الفلسفة في قول إحدى الشخصيات: “المرض الوحيد الذي ينتقل باللمس.. كأنه صار ضدنا نحن من نعيش على اللمس” ص9. هذه الجملة تكثف الصراع بين حاجة الإنسان للتواصل الجسدي والقمع الاجتماعي الذي يفرضه واقع الخوف.
كما تعكس الرواية بشكلٍ رمزيّ آثار الصراعات التي عاشها العراق على مدى عقود، من خلال رسمها لشخصية الرجل المنكسر. فالرجال في الرواية لا يمثّلون قوّة أو سلطة، بل يمثلون انهزامًا وانسحابًا أمام قسوة الواقع. إنهم رجال فقدوا رجولتهم بالمعنى التقليدي، فهم لا يسيطرون على مصيرهم ولا على مصير من حولهم. هذا الانكسار يتجلّى في الحوارات التي تضع الرجولة في موضع المساءلة، ففي موضع يقول أحد الرجال: «هذا البياض أشرف من سوادكم… وأنتم تنامون في الصحراء مثل عقارب سامة” ص64، مما يظهر كيف أن مفهوم الرجولة أصبح محصورًا في صراعات أخلاقية ورمزية لا طائل منها. إن هذا الانكسار الذكوري يمثل انكسارًا لأمة بأكملها، فقدت بوصلتها وتوازنها.
ارتكاب المحرم وصراع الأهواء:
تتشابك خيوط التحليل لتنسج صورةً معقّدةً عن الإنسان في مواجهة أزمة وجودية. يظهر ارتكاب المحرّم كفعلٍ محوري، ليس بالضرورة جريمة كبرى، بل هو تجاوز للذات نفسها، كما يتجسد في شخصية ساجدة. إن قرارها كما لو كان بخلع رداء العزلة، وترك منزلها في ظلّ قيود الحظر، هو محرّم في سياق نفسي واجتماعي خاص، ينطوي على صراعٍ داخلي هائلٍ بين الالتزام بالواقع والخضوع للخوف، والبحث عن الحقيقة الشخصية. هذا الفعل هو لحظة “خلق سلبي” تهدّم فيها صورة الذات التي قبلت بالعزلة، لتبني على أنقاضها هوية جديدة تسعى للتحرّر. هذا التمرّد لا يمنحها سلامًا فوريًا، بل يلقي بها في متاهة من المشاعر المختلطة، حيث يختلط فيها الخوف من المجهول بنشوة التحرر، مما يبرهن على أن المحرّم هو نزاع داخلي بين ما هو أخلاقي وما هو حقيقي.
في مقابل هذا الانشقاق الفردي، تبرز الرواية أهمية التماسك الجماعي، خاصةً في مشهد التحام أجساد النسوة. يحمل ضم ساجدة لصديقتها وارتماء الثالثة فوقهما دلالات رمزية عميقة تتجاوز التواصل الجسدي. إنه عودة إلى الأرض والأصل، هروبًا من الواقع المادي المعقد إلى أبسط أشكال الوجود، وبحثًا عن الأمان في أحضان الطبيعة. هذا المشهد يمثل أيضًا رفضًا قاطعًا للعزلة التي فرضها الوباء، حيث يصبح التماس الجسدي رمزًا قويًا للتضامن والوحدة في عالم أصبح فيه التباعد الاجتماعي قاعدة. هذا الاحتضان ليس مجرّد ضم أجساد، بل هو ضم أرواح، تعبير صامت عن فهم مشترك ودفء متبادل، وكأنهم يقتسمون حميمية لم يعد العالم يترك لهم مساحة لها، في لحظة فارقة تتكسر فيها “الدوائر الفارغة” وتُملأ بالفهم والتعاطف.
وفي هذا السياق، يتجلّى صراع الأهواء كعنصرٍ محوريّ في بناء الشخصيات. هذا الصراع ليس خارجيًا، بل هو داخلي عميق، حيث تتصارع رغبات الشخصيات وأشواقها مع القيود الاجتماعية والنفسية. يتجسّد هذا الصراع في عدة مظاهر، منها صراع العزلة والرغبة في التواصل، حيث تشعر ساجدة بضغط العزلة الشديد وتصف الرواية هذا الشعور بما يمكن اعتباره صرخة من اجل أتحرر من هذا القيد الذي يكبل الروح. كما يتضح في صراع الخوف والأمل، حيث تعيش الشخصيات في حالة خوف مستمر من المجهول، لكنها تتشبث بالأمل في غد أفضل، مما يدفعها لاتخاذ قرارات غير تقليدية. أخيرًا، يظهر صراع الحقيقة والوهم، “- لنجعل هذا المكان مكان التفكير ولنلعب لعبة الاعتراف” ص101، مما يعكس صراعًا عميقًا بين قبول الواقع كما هو والسعي لاكتشاف حقيقة أخرى.
……………………………………………………………………….
واقع المرأة والرجل في رواية “لعبة الدوائر الفارغة” لعلي لفتة سعيد.
عبد الرحيم التدلاوي
واقع الرجال:
وفي المقابل، يتم تقديم واقع الرجال في الرواية من خلال تفاعله مع عالم النساء. بينما يمثل أبو عدنان الرجل المتمرّد والرافض للقيود، الذي يؤمن بأن الحياة لا يجب أن تتوقف بقوله: ” أنا خسرت كل شيء لأني كنت وطنيا في زمن الخوف
لم أحصل إلّا على الفراغ، والذين كانوا مع النظام هم الآن قوّاد هذا البلد. وقد عرفوا اللّعبة تماما ” ص186، تُقدم الرواية صورًا أخرى للرجل الغائب والمؤثر. يمكن أن يكون هذا الرجل الأب أو الزوج السابق، وغيابه يترك فراغًا في حياة الشخصيات النسائية، ويصبح المحرك الأساسي لبعض دوافعهن وأهوائهن. ويُبرز هذا أيضًا الرجل الذي يمثل الخضوع والاستسلام، والذي يتم إظهاره من خلال غيابه أو خضوعه الكامل للظروف. هذا النوع من الرجال يمثل صورة معكوسة للرجولة التقليدية، حيث يُنظر إليهم على أنهم فقدوا قدرتهم على التأثير أو الفعل، ويُفسّر هذا الخضوع كنوع من “العجز” الروحي والنفسي عن مواجهة الحياة. إن هذا التعدد في صور الرجال يثري الرواية، ويظهر أن تأثيرهم لا يقتصر على وجودهم المباشر، بل يتعداه إلى وجودهم في الذاكرة والوعي، مما يترك أثرًا عميقًا في “الدوائر الفارغة” لحياة الشخصيات.
عناصر الطبيعة في الرواية:
ليس من الممكن فهم رمزية الرواية بزعمي دون النظر إلى تفكيك عناصر الطبيعة فيها، حيث الماء والهواء والأرض والنار تحضر كأقنعة عبثية، ورموز كونية:
لا تحمل العناصر الأربعة للحياة دلالاتها المألوفة، بل تتحوّل إلى أقنعةٍ عبثيةٍ تعكس انهيار المعنى. فالماء، الذي يُفترض به أن يكون مصدرًا للحياة، يغدو “فراغًا من ماء” تُسير عليه الشخصيات في شعورها بالعدم، بينما الهواء، الذي يُعد متنفسًا للروح، يتحول إلى مصدر للاختناق في ظل القيود والخوف. أما الأرض، فهي لا تنبت سوى الصمت الثقيل، صمت يعكس عزلة الأرواح وانفصالها، وتفقد بذلك رمزيتها كأصل وجذر. وفي خضم هذا العبث، لا تضيء النار الطريق ولا تُدفئ، بل تحترق بها الكلمات، فتتحول إلى رمز للعواطف المكبوتة والغضب الذي يلتهم فرص الحوار والتواصل، تاركًا خلفه رمادًا من اليأس. هكذا، تنسج الرواية عالمًا حيث العناصر الأساسية للوجود تتخلى عن طبيعتها، لتؤكّد على فراغ الوعي الذي تعيشه شخصياتها.
هذا التوتر بين الشكل والمعنى لا يتوقف عند العتبات، بل ينسحب إلى النسيج السردي برمّته. فالرواية لا تتقدّم على نحو خطّي، وإنما تنزلق في زمنٍ يشبه الماء، زمن لا يترك أثرًا، ولا يسمح بترتيب الأحداث ترتيبًا سببيًا. تتداخل الأزمنة في الرواية كما تتداخل الصور في الحلم، وتمتزج اللحظات في الذاكرة.
تفكيك الزمن:
ولا يكتفي النص بتفكيك الجسد والرجولة، بل يمتد إلى تفكيك الزمن. فزمن الرواية ليس خطيًا، بل دائريًا مغلقًا يلتهم ماضيه وحاضره ومن هنا يأتي بعض من العنوان: الدوائر الفارغة. فبدلاً من التقدّم، تدور الشخصيات في فلك حياتها دون أن تتقدم، وكأنها حبيسة لحظة واحدة تتكرر في أشكال مختلفة. وتتجسّد هذه الفكرة في استعارة بصرية معبرة: ” تبدو السعفة التائهة راقصة بعشوائية ريح تمر ثم تختفي”ص10. هذه السعفة هي رمز للشخصيات التي تتحرك بلا غاية، وكأنها مجرد أداة في يد قوى أكبر منها، مما يؤكد شعورها بالضياع والعبث الوجودي.
إن “لعبة الدوائر الفارغة” تأمّل فلسفي في معنى الوجود في زمن العبث. إنها دعوة للتفكير في “الفراغ” الذي يحيط بنا، ليس كعدم، بل كمساحةٍ مليئةٍ بالأسئلة التي لا نجرؤ على طرحها. فالدوائر الفارغة ليست في النص، بل في دواخلنا، وفي طريقة فهمنا للعالم الذي ينهار حولنا. الرواية بهذا المعنى هي مرآة تعكس هشاشة هويتنا، وتأكيد على أن البحث عن الخلاص في عالم من الدوائر المفرغة قد يكون هو نفسه العبث بعينه.
ما الذي تنطوي عليه الخاتمة؟
تأتي خاتمة “لعبة الدوائر الفارغة” متفجّرة، إذ تجسد التناقض الصارخ بين عالمين متوازيين، عالم الرجال الذي ينتهي بالدمار، وعالم النساء الذي يحقّق انسجامه الخاص. إن مشهد عودة الرجال إلى بدائية الصراع واقتتالهم، يمثل ذروة الفشل في مواجهة الأزمة، وإثباتًا على أن العزلة التي فرضها الوباء لم تكن كافية لتهذيب أهواء العنف الكامنة في دواخلهم. فبدلاً من أن توحدهم المحنة، فرقتهم، ودفعهم الخوف إلى تدمير بعضهم البعض، وكأنهم يمثلون صورة معكوسة للرجولة التي عجزت عن الصمود أمام اليأس. في المقابل، تُقدم الرواية عالم النساء الذي تجاوز هذا الفشل من خلال الانسجام والوحدة، حيث يتمكّن من بناء دائرة من التضامن، تعبيرًا عن انتصار غريزة الحياة على غريزة الموت. لكن هذا النصر ليس مطلقًا، إذ يصطدم هذا الانسجام المفاجئ بالواقع المدمر الذي خلفه الرجال، مما يترك النساء في حالة من خيبة الأمل. هذه الخيبة ليست مجرد حزن على ما جرى، بل هي إدراك مرير بأن انسجامهن الخاص لا يكفي لإنقاذ العالم الخارجي، وأن دائرة اليأس التي حاولن كسرها قد عادت لتكتمل بدائرة عنف جديدة، مما يجعل الخاتمة رسالة قوية حول طبيعة الأزمة الإنسانية، حيث لا يمكن لأي انتصار فردي أن ينجو من الدمار الجماعي.
أما بعد:
لا تهدف هذه القراءة إلى تأويل مغلق للرواية، بل إلى الدخول في لعبتها الدائرية، حيث الجسد واللغة والزمن تشكّل مثلثًا يتقاطع عند نقطة الفراغ الممتلئ بأسئلة بلا إجابات. جرأة الرواية، خصوصًا عبر شخصياتها النسائية، ليست غايةً في ذاتها، بل وسيلةً لاختراق البنى الاجتماعية والسياسية وكشف هشاشتها. “لعبة الدوائر الفارغة” بهذا المعنى نصّ مفتوح، لا يكتمل إلا بتأويل قارئه، الذي قد يكتشف أن الدائرة الفارغة في النهاية ليست في النص، بل فينا.