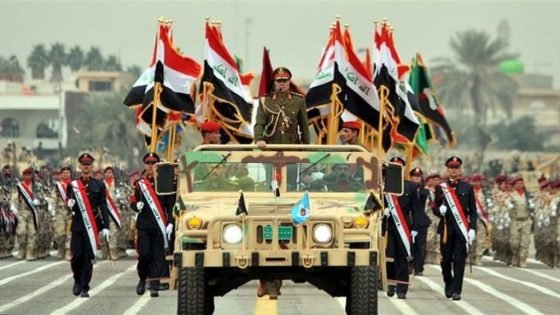وفد دبلوماسي رفيع تقوده المسؤولة الثانية في وزارة الخارجية الفرنسية يبدأ زيارة إلى الجزائر بعد أيام قليلة من عودة الكاتب إلى باريس
تُعتبر زيارة ديكوست المسؤولة الثانية في الخارجية الفرنسية دليلاً على جدّية باريس في استئناف التواصل على أعلى المستويات
أرسلت الجزائر خلال الآونة الأخيرة إشارات واضحة تؤكد استعدادها للحوار مع فرنسا بما يفضي إلى تبريد الأزمة مدفوعة برغبتها في تخفيف عزلتها على الساحة الأوروبية
أُطلق سراح صنصال في 12 شرين الثاني بفضل وساطة ألمانية وبعد أقل من أسبوع من وصوله إلى برلين قادمًا من الجزائر العاصمة
الجزائر / النهار
بدأ وفد دبلوماسي رفيع تقوده آن ماري ديكوست الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، زيارة إلى الجزائر، ما يشير إلى انفراج في الأزمة التي وضعت البلدين على حافة القطيعة، فيما تأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من عودة الكاتب الفرنسي من أصل جزائري بوعلام صنصال إلى باريس.
وتُعتبر زيارة ديكوست، المسؤولة الثانية في الخارجية الفرنسية، دليلاً على جدّية باريس في استئناف التواصل على أعلى المستويات، ما يمثل اعترافاً بأهمية العلاقة مع الجزائر ورغبة في معالجة القضايا العالقة بعمق.
وأرسلت الجزائر خلال الآونة الأخيرة إشارات واضحة تؤكد استعدادها للحوار مع فرنسا بما يفضي إلى تبريد الأزمة مدفوعة برغبتها في تخفيف عزلتها على الساحة الأوروبية والتي باتت تهدد مصالحها الاقتصادية.
ويُنظر إلى عودة صنصال إلى باريس على أنها بادرة إنسانية من الجانب الجزائري، هدفها تهيئة المناخ الإيجابي للحوار، كما تؤكد مرونة وقدرة على الفصل بين القضايا السياسية المعقدة والملفات الإنسانية.
واختارت الجزائر أن تجعل الإفراج استجابة لطلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، بدلاً من الاستجابة مباشرة لفرنسا، وهذا سمح لها بتحقيق هدفين: تقديم بادرة حسن نية تخدم التهدئة الشاملة والحفاظ على ماء الوجه والرد على ما اعتبرته “غطرسة” فرنسية، وإبقاء باريس على الهامش في التفاوض المباشر حول الملف.
وتحول بقاء كاتب حائز على الجنسية الفرنسية والألمانية وله ثقل أدبي في السجن إلى عبء سياسي على الجزائر، مما أضر بصورتها الدولية، خاصة مع رغبتها في تنويع شركائها.
ولم يكن فتح باب التهدئة مجرد تنازل، بل كان خياراً براغماتياً مدفوعاً بحسابات الكلفة السياسية والاقتصادية لاستمرار القطيعة. واستخدمت الجزائر ورقة إنسانية كجسر للعبور نحو الحوار، مستفيدة من وساطة طرف ثالث (ألمانيا)، بهدف كبح الخسائر الجيوسياسية واستعادة التوازن في علاقاتها الخارجية المتصدعة مع أكثر من دولة.
وكان لخروج وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، والذي كان هدفاً لانتقادات الجزائر، من الحكومة، عاملاً حاسماً في إزالة إحدى العقبات الرئيسية التي كانت ترفض الجزائر تقديم أي تنازلات في وجودها.
وبعد عام من الاحتجاز في الجزائر، أُطلق سراح صنصال في 12 نوفمبر/شرين الثاني بفضل وساطة ألمانية. وبعد أقل من أسبوع من وصوله إلى برلين قادمًا من الجزائر العاصمة، وصل الكاتب الفرنسي من أصل الجزائري إلى باريس يوم الثلاثاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث استقبله الرئيس إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه، وأشاد بـ”كرامته ” و”صلابته المعنوية” و”شجاعته ” ، واصفًا إياها بأنها “مثالية”، وفق صحيفة “لوموند” الفرنسية.
وتلا ذلك لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الذي أكد لعائلة صنصال أن خدماته “ستبقى تحت تصرفهم بالكامل”، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية.
وتفادت باريس إثارة أي ضجة إعلامية لهذا التكريم، إذ يميل الإعلام الرسمي والسياسي في فترات الانفراج إلى تخفيف لهجة التصعيد، مما يعكس توجهاً من القيادتين نحو ضبط الأجواء العامة لتمكين المسار الدبلوماسي من العمل بهدوء.
ويمثل هذا التطور ضرورة واقعية تمليها المصالح الاستراتيجية المتبادلة والأمن الإقليمي، ويفتح الباب أمام حوار صريح لمعالجة الخلافات العميقة. وأكد ماكرون خلال الآونة الأخيرة استعداده للحوار مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، معبرا عن الرغبة في التهدئة وطي صفحة الأزمة مع شريك تاريخي.
وعلى الرغم من أن العلاقات بين البلدين لم تغادر مربع التوتر على امتداد الأعوام الماضية، تظل هناك مصالح مشتركة وحيوية تدفعهما إلى العودة للمباحثات، ومن أبرزها الأمن الإقليمي، حيث تتعاون الجزائر وفرنسا في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، وهذا التنسيق لا يمكن أن يستمر بفاعلية في ظل قطيعة دبلوماسية.
كما تعتبر باريس شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً للجزائر، لا سيما في قطاعات الطاقة (في سياق الأزمة الأوروبية للطاقة) والاستثمارات، بالإضافة إلى وجود جالية جزائرية كبيرة في فرنسا يجعل من الضروري وجود تنسيق قنصلي وسياسي دائم، خاصة فيما يتعلق بملفات الهجرة والتنقل.
ولا يزال ملف الذاكرة المتعلق بالفترة الاستعمارية يمثل نقطة خلاف حساسة وجذرية، ويتطلب الحوار الجاد والمستمر للوصول إلى تفاهمات ومقاربات مشتركة. وتصر الجزائر على مبدأ الندّية في علاقاتها مع فرنسا، وترفض أي تدخل أو انتقاد لشؤونها الداخلية.
وتتجه الجزائر إلى إقرار زيادة في الحد الأدنى للأجور والرفع في منحة البطالة ضمن مساعيها لتحسين القدرة الشرائية المتدهورة في ظل التضخم المتزايد، وتهدئة الجبهة الاجتماعية المشتعلة، في وقت تتصاعد فيه الانتقادات لتوجهات الدولة الاقتصادية وإخفاقاتها في إحداث تحول هيكلي وعجزها عن تطوير البنية التحتية المتآكلة، ما حد من قدرة البلاد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تعد من أهم الحلول لمعالجة معضلة البطالة.
ويشمل مشروع قانون موازنة عام 2026، التي وُصفت بأنّها الأكبر في تاريخ الجزائر، زيادة كتلة الأجور بنسبة 1.4 بالمئة لتبلغ نحو 45 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلث الميزانية، وفق مواقع محلية.
وينتظر أن يشمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور جميع العاملين، وسط توقعات بالترفيع في منحة البطالة إلى 20 ألف دينار شهرياً.
ويمكن اعتبار هذه الإجراءات بمثابة إطفاء مؤقت لنار السخط الشعبي المتصاعد. فمن خلال تحسين الدخل، تسعى الحكومة إلى امتصاص الغضب وتجنب اندلاع حركات احتجاجية واسعة على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من الجزائريين.
ويمثل تقديم الدعم المالي المباشر عبر الزيادات حلاً سريعًا وله تأثير فوري وملموس على حياة الناس، مما قد يحول الانتباه جزئيًا عن معضلة عدم تنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة تضمن نموًا مستدامًا ومشغلاً.
ويرى خبراء أن هذا التوجه لا يعالج جذور المشكلة الاقتصادية التي تتمثل في ضعف البيئة الاستثمارية، والبيروقراطية، والاعتماد المفرط على عائدات النفط والغاز. ولا يمكن لمنحة البطالة أن تحل محل وظائف مستدامة تخلقها مشاريع استثمارية حقيقية.
وينتظر أن تؤدي الترفيع في الأجور والمنح إلى تفاقم الضغوط التضخمية في حال لم يقابلها زيادة في الإنتاج والخدمات، مما قد يعيد تآكل القوة الشرائية مجددًا.
ويرى العديد من الجزائريين أن الحكومات المتعاقبة أخفقت في وضع إسترايتيجات تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات الرائدة، رغم أن البلد النفطي، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول، لا تعوزه الإمكانيات.
وركزت الجزائر بشكل واضح على الإنفاق الاجتماعي كآلية رئيسية وسريعة لامتصاص الاحتقان وتهدئة الجبهة الاجتماعية، متجاوزة أو مؤجلة بذلك معالجة الجذور الهيكلية لأزماتها الاقتصادية المتعددة. وتعرف هذه الاستراتيجية بـ”شراء السلم الاجتماعي”.
وتعتمد هذه الآلية على توجيه فوائض عائدات الطاقة، التي ارتفعت بفعل التقلبات الجيوسياسية العالمية، نحو برامج ذات تأثير فوري وملموس على معيشة المواطنين. ووصلت الزيادات في الأجور في بعض الأحيان إلى نسب كبيرة على مدى عدة سنوات (مثل 47 بالمئة بين 2022 و2024).
كما أدمجت الحكومة أعدادا كبيرة من المتعاقدين والموظفين المؤقتين، خاصة في قطاعات التعليم والإدارة، في مناصب دائمة، مما يضمن الاستقرار الوظيفي لفئة واسعة.
وتعتمد الموازنات العامة على أسعار نفط مستقرة نسبياً، لكن النفقات الاجتماعية الهائلة (كلفة الزيادات والمنح) تؤدي إلى عجز مالي كبير (قد يصل إلى 54 بالمئة من إجمالي النفقات في بعض التقديرات)، مما يفتح الباب أمام الاستدانة الداخلية وربما العودة إلى خيارات غير تقليدية مثل التمويل الاستثنائي (طباعة النقود) الأمر الذي يغذي التضخم لاحقاً.
وتتهيأ الحياة السياسية في الجزائر لمرحلة جديدة، مع إعلان عدد من أحزاب المعارضة عودتها إلى السباق التشريعي المرتقب مطلع عام 2026، في ثاني انتخابات برلمانية تُنظّم منذ انطلاق الحراك الشعبي عام 2019، بينما تمثل هذه العودة محاولة لإعادة الفعل السياسي إلى الواجهة بعد فترة غابت خلالها التشكيلات المعارضة عن المشهد البرلماني، باستثناء حركة مجتمع السلم (حمس) المحسوبة على تيار الاخوان المسلمين.
ولم تنجح الأحزاب الإسلامية في الجزائر في انتزاع موقع متقدم في المشهد السياسي مثقلة بإرث العشرية السوداء التي شهدت موجة أعمال إرهابية ومواجهة دموية بين أتابع الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الفيس) والسلطات على إثر الغاء الجيش نتائج الانتخابات التشريعية في تسعينات القرن الماضي والتي فاز فيها الإسلاميون.
وفي العقود القليلة الماضية كانت حركة مجتمع السلم ضمن أحزاب الموالاة وتصرفت بمنطق قدم في المعارضة وأخرى في سفينة السلطة. وحين أدركت في 2019 أن نظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة على وشك السقوط قفزت من سفينة الموالاة وانضمت للحراك الشعبي في اللحظة الأخيرة شأنها شأن أحزاب معارضة ركبت موجة الحراك الشعبي.
وأبرز الأحزاب التي أعلنت مشاركتها هي جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في البلاد، إلى جانب حزب العمال ذي التوجه اليساري. في المقابل، لا يزال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية يدرس موقفه النهائي، ما يعكس مستوى من التردد داخل المعارضة وعدم وضوح الرؤية الموحدة للمستقبل السياسي.
وأدى غياب المعارضة في الدورة البرلمانية الماضية إلى فقدان البرلمان لتعدد الأصوات الذي شكّل سابقًا مساحة جدلية حيوية أثرت في النقاشات المتعلقة بالسياسات العامة ومشاريع القوانين.
وبحسب القيادي في جبهة القوى الاشتراكية، وليد زعنابي، فقد جاءت مقاطعة انتخابات 2021 في سياق اتسم بـ”تضييق النقاش العام وتقييد الحريات”، وهو ما يشير إلى الصعوبات البنيوية التي واجهت المعارضة في مواكبة العمل السياسي الفعلي.
ويؤكد زعنابي أن المشاركة المقبلة تهدف إلى “إعادة الاعتبار للفعل السياسي، والدفاع عن الحريات الدستورية، وتوسيع فضاءات الحوار الوطني”، مشيرًا إلى أن الجبهة تسعى لتجديد حضورها في مختلف ولايات البلاد، بما فيها منطقة القبائل التي تعد إحدى قلاعها التاريخية. ويرى أن عزوف الناخبين خلال السنوات الماضية ظاهرة مقلقة ينبغي معالجتها عبر إجراءات تهدئة سياسية واقتصادية.
من جهته، يرى القيادي في حزب العمال جلول جودي، أن قرار المشاركة جاء بعد نقاش داخلي معمق، معتبرًا أن الوضع الراهن يتطلب “تحمّل المسؤولية دفاعًا عن الحقوق والحريات، والعمل من أجل بناء اقتصاد قوي غير هش”، مشيرا إلى أن حزبه سيدفع نحو سياسات اجتماعية تهدف إلى مكافحة البطالة، ودعم التعليم والثقافة، ومحاربة أشكال العنف والتمييز.
وتبدو هذه الرسائل في ظاهرها فعلا ديمقراطيا إيجابيا يكرس منطق المشاركة واحداث توازن سياسي في مشهد يهيمن عليه الحزب الحاكم منذ الاستقلال، حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان)، لكن بين خطاب الدعاية أو الرسائل الوردية، تظهر الصورة الأكثر قتامة لمشهد خلا من الفعل السياسي الوازن والقدرة على تشكيل جبهة قادرة على منازعة الحزب الحاكم.
فرغم هذه المبادرات، يبقى التشرذم والانقسامات داخل المعارضة أبرز التحديات التي تواجه قدرتها على التأثير، فالتشتت التنظيمي والخلافات حول استراتيجيات المشاركة، وتفاوت قدرة الأحزاب على التعبئة الشعبية، يضعف من فرصها في خلق توازن سياسي أمام الحزب الحاكم، الذي يظل رغم بعض الانقسامات الداخلية، القوة الأبرز في المشهد السياسي.
كما أن غياب تنسيق فعّال بين أحزاب المعارضة يجعل من الصعب تشكيل جبهة موحدة قادرة على الضغط والمحاسبة، أو التأثير في صياغة السياسات العامة.
ويمكن القول إن قدرة أحزاب المعارضة على إحداث توازن سياسي أمام ‘الأفلان’ ما زالت محدودة، فهي تواجه تحديات هيكلية وتنظيمية، منها ضعف الوحدة الداخلية، وانقسام الرؤى الاستراتيجية، وعدم قدرة بعض الأحزاب على استعادة مصداقيتها أمام المواطنين. ومع ذلك، تمثل العودة إلى الانتخابات فرصة لإعادة بناء حضور المعارضة وتجديد الفعل السياسي، خصوصًا إذا نجحت في توحيد الصفوف وإعادة ثقة الناخبين.
ويبقى الشارع الجزائري أبعد ما يكون عن الاقتناع بقدرتها على إحداث التغيير أو خلق توازن سياسي ينهي هيمنة الحزب الحاكم على المشهد، فسنوات من الإخفاقات، والانقسامات الداخلية، والمواقف المتذبذبة خلال محطات سياسية حاسمة، جعلت كثيرًا من الجزائريين ينظرون إلى المعارضة بوصفها جزءًا من الأزمة، لا أداة للخروج منها. ويتجلى ذلك في معدلات العزوف الانتخابي المتزايدة، وفي إحساس عام بأن التنافس الحزبي لا يفضي إلى تحول فعلي داخل مؤسسات الدولة.
ومع غياب مبادرات قوية تستعيد الثقة، ومع استمرار الفجوة بين الخطاب السياسي وواقع المواطنين، تجد المعارضة نفسها أمام تحدٍّ صعب: إقناع الشارع أولًا بجدوى المشاركة قبل السعي إلى مواجهة هيمنة ‘الأفلان’ أو تغيير ميزان القوى داخل البرلمان المقبل.
ويشهد المشهد السياسي الجزائري تحولات مستمرة منذ الانتخابات الرئاسية في سبتمبر/ايلول 2024، وسط تحديات إقليمية متصاعدة تتعلق بتوترات الساحل الإفريقي والتموضع الدولي في المنطقة.
وفي هذا السياق، تبرز المعارضة كمكون أساسي لإعادة التوازن السياسي، لكن فعاليتها تبقى مرتبطة بقدرتها على تجاوز الانقسامات الداخلية، وتقديم برامج واضحة وجاذبة، واستعادة الثقة الشعبية. إذا نجحت في ذلك، يمكن أن تتحول الانتخابات المقبلة إلى فرصة حقيقية لإعادة إشراك المواطنين في العملية السياسية، وإحداث تحول ملموس في معادلة القوى بين الأحزاب المعارضة والحزب الحاكم.
لكن المشهد بتجلياته الراهنة وبناء على شواهد سابقة لا يوحي بأن المعارضة الجزائرية يممكن أن تستعيد زمام المبادرة في مواجهة الآلة الدعائية للحزب الحاكم وقدرته على تسخير موارد الدولة في الدعاية السياسية وتوجيه الراي العام.
ولم يسبق للمعارضة الجزائرية أن وقفت موقفا حازما إزاء تجاوزات سياسية مقلقة بداية بتضييق الخناق على الحريات وصولا إلى ملفات الفساد الحارقة التي جعلت من دولة نفطية بحجم الجزائر، عاجزة عن تحقيق طفرة نمو أو معالجة القضايا الاجتماعية الملحة.
وباختصار يبدو أن الشعب والمعارضة يقفان أمام معضلة مع تحول الدولة من دولة الشعب إلى دولة الحزب الواحد.