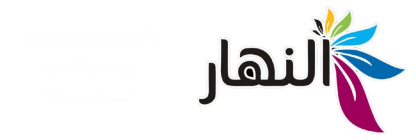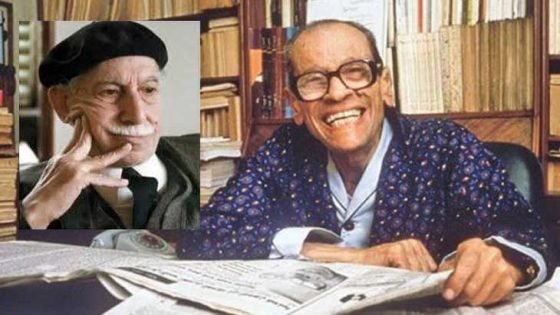لا أخفي سرًّا إن قلتُ إنني من المتابعين المتأملين لكتابات الشاعرة إنعام الحمداني، ممن يطاردون كلماتها، لا ليُمسكوا بها، بل ليغوصوا في أعماقها، باحثين عمّا يتوارى خلف الظاهر من الحرف.
في شعرها أبعادٌ وجدانية وجمالية تتجاوز بنية اللغة إلى ارتعاشة الروح.
قرأتُ قصيدتها “هلوساتُ حرفٍ” أكثر من مرة، وكنتُ كلما انتهيتُ من قراءتها، شعرت أني لم أبلغ قاعها بعد، فهي مشبعة بالخَشية، لا تخاف من الاعتراف بالانطفاء، بل تمجّده بصمت مهيب.
إنعام الحمداني، في هذا النص، لا تكتب من موقع “المعنى الجاهز”، بل تمارس الكتابة من ما يُسمى نقديًا بـ “الضفّة الأخرى للمعنى”، حيث لا تسعى الكلمات لإيضاح ما هو واضح، بل لتقليب المسكوت عنه، والتعبير عن أزمة اللغة ذاتها.
ما معنى “الضفّة الأخرى للمعنى”؟
هي كتابة لا تنشد الوضوح أو إيصال رسالة مباشرة، بل تسكن في الظلال والهوامش.
تبتعد عن السرد الخطيّ والبنية المغلقة، وتدفع القارئ لأن يصنع المعنى بنفسه، من خلال التأمل والتأويل والاندهاش.
في هذا النوع من الشعر، الكلمات لا “تُقال”، بل “تُقترح”، وتُرمى كالحصى في ماء الوعي لتُحدث تموّجات فكرية وعاطفية.
تفكيك مغاليق النصّ:
“حرفٌ تجاوز المائة عام”:
يشير إلى حرف عجوز، لغة منهكة، أو كتابة أُثقلت بالزمن، باتت عاجزة عن الولادة. صورة مجازية عن انطفاء الإلهام وتعب الحروف من أداء دورها.
“ينتظر الربيع عامًا بعد عام… بلا فائدة”:
الربيع هو الأمل، التجدد، لكن الانتظار أصبح عبثيًا. هنا تُلمّح الشاعرة إلى خسارة المعنى في زمن لا يمنح الشعر فرصةً للحياة.
“ذاكرته بدأت تتضاءل… أوراق مصفرة… أضاع الفهرس”:
استعارات من عالَم الاضطراب العقلي (الزهايمر، النسيان، ضياع الفهرسة) تعكس تفكك البنية الداخلية للذات وللخطاب الشعري.
“كوابيس تمتطي صهوة مناماتي”:
الحلم هنا لم يعد هروبًا من الواقع، بل هو نفسه ساحة قتال نفسية، حيث يركب الكابوس منام الشاعرة، في فعل عدواني صادم.
“خوارزميات سيئة الفهم تحذف أعشار الإحساس”:
دلالة ذكية على هيمنة التكنولوجيا والذكاء الصناعي، الذي لا يفهم الإنسان، بل يعيد تشكيله ببرود. إحالة صريحة إلى معضلة الروح في عصر التقنية.
“نُحرت القصيدة على مذابح العقول”:
قمة المفارقة: القتل هنا لم يتم على يد الجهل، بل على أيدي العقول – العقلانية الجامدة، التحليلية، التي تغتال الحسّ لصالح المعادلة. الشعر يُذبح حين يُطلب منه أن يُفسَّر منطقيًا.
بُنية الأسلوب:
القصيدة تخلّت عن القافية والإيقاع التقليدي، واعتمدت على الإيقاع الداخلي النفسي.تتوالى فيها الجمل الاسمية المتقطعة، لتعكس الجمود، السكون، والتيه.الصور متكاثفة، متأملة، لا تُسلَّم بسهولة بل تُقاوِم التفسير.
من زاوية التفكيك:
إذا أردنا تطبيق مقولات جاك دريدا في التفكيك، فإن النص:
لا ينتج مركزًا دلاليًا ثابتًا.
يدفع القارئ إلى الشك في اللغة نفسها.
يعمل عبر التأجيل والانزياح، أي أن المعنى لا يُعطى، بل يُرجأ، ويظلّ في حركة لا نهائية.
خاتمة:
“هلوساتُ حرفٍ” ليست قصيدة عن الكتابة فقط، بل عن اهتزاز الأرض تحت قدمي الكاتبة، وانكسار سلطة اللغة أمام هول العالم الجديد.
إنعام الحمداني في هذا النص تكتب من الجهة الأخرى للضوء، من تلك المسافة التي تفصل بين انبثاق المعنى وسقوطه.
قصيدتها لا تُفسَّر، بل تُستشعر، لا تُستوعب من القراءة الأولى، بل من التيه المُتعمّد في شعاب اللغة.
وهي بهذا المعنى، تضع قارئها أمام سؤال صعب:
هل ما زالت القصيدة قادرة على النجاة في عالمٍ رقميٍّ يحذف ” الاحاسيس”؟
أم أنّها، كما تقول، نُحرت… على مذابح العقول؟
القصيدة:
هلوساتُ حرفٍ
حرفٌ تجاوزَ المائةَ عامٍ،
يغفو على أريكةِ الزمنِ،
يعاني سباتًا مُدقعًا،
ينتظرُ الربيعَ عامًا بعدَ عامٍ… بلا فائدةٍ.
ذاكرتُهُ بدأتْ تتضاءلُ،
ربما أصابَهُ زهايمرُ آخرِ العمرِ،
تخاريفُ تخطُّ مسارَها
نحوَ شمسٍ آفلةٍ.
أوراقُ الكتابِ مُصفَرَّةٌ،
باهتٌ لونُها،
أضاعَتِ الفهرسَ
منذُ آخرِ ترقيمٍ…
لا أتذكَّرُ عددَهُ جيِّدًا.
تساقطتِ الأرقامُ مُعلنةً
نهايةَ المعادلةِ بالخسارةِ.
قيلولةٌ… ربما تُجدي بالغرضِ.
كوابيسُ تمتطي صهوةَ مناماتي،
أحاولُ الرجوعَ إلى الواقعِ…
بلا جدوى.
أهرولُ مُسرعًا
نحوَ خوارزمياتٍ سيئةِ الفهمِ،
تحذفُ أعشارَ الإحساسِ
بغبنٍ شديدٍ.
فكرٌ قلقٌ يشوبُهُ
سُحُبٌ من الدخانِ…
مُغادرًا… بلا خطيئةٍ،
كأنّ شيئًا لم يكنْ.
للتوِّ… عادتِ الذاكرةُ،
هرولتِ الحروفُ إلى عالمِ الكتابةِ.
التزمَ القلمُ الصمتَ،
تعطّلتْ لغةُ الاسترسالِ،
ونُحِرَتِ القصيدةُ
على مذابحِ العقولِ…