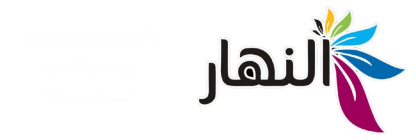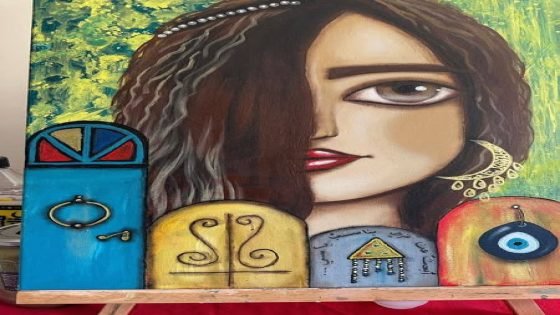تمثل أغنية “من غير ليه” (١٩٨٩) ذروة من ذُرْوات التجربة الغنائية العربية الحديثة، كتب كلماتها الشاعر مرسي جميل عزيز، لحّنها وأداها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في آخر إطلالاته الغنائية، عقب تأجيله لها لثلاث عشرة سنة -تقريبا- عقب موت عبد الحليم حافظ الذي كان مفترضا أن يكون صاحب الصوت الغنائي لهذا العمل لولا سبق القدر.
تمثل أغنية “من غير ليه” (١٩٨٩) ذروة من ذُرْوات التجربة الغنائية العربية الحديثة، كتب كلماتها الشاعر مرسي جميل عزيز، لحّنها وأداها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في آخر إطلالاته الغنائية، عقب تأجيله لها لثلاث عشرة سنة -تقريبا- عقب موت عبد الحليم حافظ الذي كان مفترضا أن يكون صاحب الصوت الغنائي لهذا العمل لولا سبق القدر.
جاءت الأغنية بمثابة خلاصة لمسيرة فنية طويلة، محمّلة بوعي وجودي يتجاوز حدود الغزل التقليدي بين عاشقين، من هنا يكتسب النص أهميته النقدية؛ لما يحمله من كثافة إيحائية، وحِيَلٍ جمالية تستحق الوقوف أمامها.
إذ لا يمكن تناول هذا النص وفق منظور تحليلي لكلمات عاطفية فحسب؛ بل بوصفه بناءً سرديًا قائمًا على استراتيجيات إيحائية تُنتج عالمًا من الوهم الجميل، عالمًا يتحرك العاشق فيه عبر لغة تتراوح بين الحضور والغياب، بين الكشف والاحتجاب، كما يلاحظ أن ثمة آليات متعددة تُسهم في تشكيله؛ بحيث يخرج من دائرة الغناء المباشر إلى فضاء أشبه بما وصفه “رولان بارت” الكتابة المزدوجة، التي تنفتح على المعنى، وفي الوقت نفسه تراوغ القارئ أو المستمع؛ فالشعور هنا ليس مجرد عاطفة، بل خطاب متشابك مع إيقاع الأسى والرغبة والتماهي مع الآخر…
ومنذ العنوان يقرر الصوت السردي دفع الاستفهام، الحيرة، التعجب، الاستنكار، برد واحد مقتضب: (من غير ليه)؛ فيصير العنوان عتبة مفسرة لحوار طال الاستفسار حوله..
هنا ينتظم النص في شكل سلسلة من الحيل ترسخ حتمية النتيجة الوحيدة في خطاب الحب بين اثنين.. في صيغة السؤال المستتر: ليه؟!
فتكون الإجابة
ـ من غير ليه!!
تظهر أمامنا الحيلة الأولى التي يعتمدها مرسي جميل عزيز، وهي خلق الصوت السردي الداخلي المتوازي مع صوت الغناء؛ فالخطاب موجه إلى “الحبيب”، لكنه في حقيقة الأمر خطاب استبطاني، في نوع من أنواع المونولوج الداخلي الذي يعلن عن العذاب واستعذابه في آن!
الصوت هنا ليس واحدًا، بل هو متشظٍ؛ إذ ينقل للمخاطب حقيقة ما يشعر به لكنه في العمق الطبقي للحوار يحاور ذاته، هذه الازدواجية في الصوت تجعل النص أقرب إلى ما أشار إليه ميخائيل باختين المنظر الروسي الشهير ( ١٨٩٥ – ١٩٧٥ ) في تعددية الأصوات
(Polyphony)
؛ حيث نسمع الحاضر فيشكل الغائب، ونلمح الصراع النفسي في لغة تبدو في ظاهرها يقينًا:
“عارف سر عذابي وحيرتي ده إيه يا حبيبي” ليست مجرد جملة خطابية، بل هي صيغة إيحائية تكشف الحيلة؛ فالمعرفة بالسر ليست لدى الآخر وحده، بل لدى الذات التي تحاول أن تعلن خضوعها، فتصطنع الإيهام بأن الحبيب يعرف الواقع كاملًا، بينما الحقيقة أن العارف الحقيقي هو المتكلم ذاته.
الميكانيزم الثاني، نجده يتمثل في التوتر بين الحتمية والاختيار؛ فترد العبارات:
“مش بإيدينا جينا”
و”القدر اللى هداني”،
كصيغ تُخرج التجربة العاطفية من كونها اختيارًا شخصيًا إلى كونها قدرًا، وكأن الحب قيد ميتافيزيقي لا فكاك منه، هذه الحيلة تشيع نوعًا من الإيهام الديني أو القدري؛ حيث يتحول الحب من تجربة فردية إلى تجربة كونية، مستندة إلى مشيئة علوية.
هنا نجد ما يشبه خطاب جان بول سارتر عن “سوء القصد”؛ إذ يتنكر العاشق لمسؤوليته عن اختياره بادعاء أن هذا الحب فرض عليه من الخارج، غير أنه في الوقت نفسه يستمد من هذا التنكر قوة سردية تجعله مطمئنًا إلى ثبات التجربة وصدقها.
الآلية الثالثة التي يسهل ملاحظتها، تكمن في استدعاء صورة “البيت” و”النجوم” و”الشمع” بوصفها استعارات كبرى للسكينة والاستقرار، لجأ مرسي جميل عزيز إلى زخرف الكلمات حتى قيل عنه جواهرجي الكلمة أو صنايعي الأغنية، فتكثر التشبيهات في كلمات أغنياته من نجوم وورد ونور، غير أن هذه الصور في نصوصه ليست محايدة؛ فهي تعمل على إعادة تشكيل العالم في ضوء العاطفة، فإذا كانت التجربة في جوهرها محفوفة بالشك والقلق (“يا عيون قلبي يا أحلى عيون، يلا نعيش وكفاية ظنون”)، فإن الحيلة البلاغية تكمن في خلق عالم بديل كامل الإيهام، حيث البيت مزدان بالورد والشمع، والنجوم الشاهدة على الحب، هذا العالم البديل هو بمثابة الفضاء الطوباوي، يتطابق مع ما كان يعرفه بلوخ (إرنست بلوخ ١٨٨٥ – ١٩٧٧) بكونه أحلام الحياة الأفضل أو “مبدأ الأمل”، أي إنتاج صورة مستقبلية مثالية تحاول أن تغطي على نقص الواقع؛ فهذا النص لا يصف الواقع بقدر ما يبني عالمًا إيحائيًا يقوم على الرفض الضمني للمعاناة وحاولة الانتفاض ضد اليأس.
ومن الأمور اللافتة؛ أن النص لا يقدّم الحب في صورته الفردية وحدها، بل يجعله فضاءً جماعيًا يطال الوجود ذاته: “لولا الحب ما كان في الدنيا ولا إنسان”.
هذه الجملة يمكنها أن تختزل الحيلة الكبرى للنص؛ إذ توسع التجربة الفردية لتصبح كونية، بحيث يتماهى الحاضر العاطفي مع أصل الوجود، وهنا تتقاطع اللغة مع ما يسميه بول ريكور “الميتافور الحي”، حيث تنقلب الاستعارة من صورة جمالية إلى رؤية كونية، تجعل الحب أصل الخلق، وتستبدل الغنائية العاطفية بمقولة أنطولوجية (للمزيد الخيال وأثره في نظرية التأويل عند بول ريكور. أيمن عبد اللطيف رضوان م. وادي النيل للدراسات والبحوث الإنسانية… ).
لنجد الإيهام هنا يعمل على مستويين الأول: المستمع الذي يتلقى النص بوصفه خطابًا مباشرًا موجهًا للحبيب، فيتأثر بشفافية اللغة، بينما الحقيقة أن هذا الخطاب منشغل بتوكيد الذات وتعويض نقصها عبر الآخر. المستوى الثاني: أن النص يخلق إيهامًا بالثبات والسكينة في حين أن بنيته الداخلية مشبعة بالخوف من الفقد (“حتى في عز عذابي بحبك”)!
إن الحيلة هنا تشبه ما يشير إليه لاكان من أن الرغبة لا تُدرك مباشرة، بل إدراكها من خلال الغياب؛ إذ يتجلى الحب في النص من خلال الخوف من زواله، من هنا فإن اللغة المشبعة باليقين (“من غير ليه”) ليست إلا قناعًا يخفي قلقًا وجوديًا عميقًا لدى الشاعر ويحمل على جدار من التسليم الموجع.
كما أن الإيقاع التكراري (“روح يا حزن روح”) يضطلع بدور ديناميكي شديد الأهمية؛ إنه أشبه بتعويذة دفع تحاول طرد الحزن عبر التكرار الإيقاعي للكلمة، هذا التكرار هو ما وصفه فرويد بالعمل “القهري” للتكرار، حيث تتجسد الرغبة في السيطرة على المجهول بإعادة نفيه مرارًا؛ فالحزن، وإن تم نفيه لغويًا، يظل حاضرًا كاحتمال، ما يجعل النص كله مشدودًا كوتر من إنكار الألم والاعتراف به.
الصوت السردي في النص إذن ليس بريئًا ولا واحدًا؛ إنه صوت مزدوج يعلن الحب واليقين ويخفي القلق والشك، والحيلة الأسلوبية تكمن هنا في جعل المستمع يصدق الوهم الجميل:
بيت بالحب، شجر ورد، نجوم، ألف شمعة. غير أن هذا البناء الطوباوي قائم على وعي خفي بالتهديد، لذلك لا يكف النص عن محاولة طرد الحزن واستدعاء الأمل، بهذا المعنى يمسي النص مثالاً واضحًا على قدرة الغناء العربي الكلاسيكي على الجمع بين الطابع الغنائي والبعد السردي – ليس المقصود السرد بمعناه الحكائي-، بل السرد كاستراتيجية لصياغة الذات داخل اللغة؛ حيث يلتقي الصوت الفردي بالرمز الجمعي، ويتحول الحب الفردي إلى معجزة كونية، والإيهام إلى آلية وجودية، تحاول مقاومة القلق من الغد ودفع المصير المجهول.
منال رضوان ناقد أدبي عضو لجنة التنمية الثقافية باتحاد كتاب مصر
Manal
إنه أشبه بتعويذة دفع تحاول طرد الحزن عبر التكرار الإيقاعي للكلمة، هذا التكرار هو ما وصفه فرويد بالعمل “القهري” للتكرار، حيث تتجسد الرغبة في السيطرة على المجهول بإعادة نفيه مرارًا؛ فالحزن، وإن تم نفيه لغويًا، يظل حاضرًا كاحتمال، ما يجعل النص كله مشدودًا كوتر من إنكار الألم والاعتراف به.
الصوت السردي في النص إذن ليس بريئًا ولا واحدًا؛ إنه صوت مزدوج يعلن الحب واليقين ويخفي القلق والشك، والحيلة الأسلوبية تكمن هنا في جعل المستمع يصدق الوهم الجميل:
بيت بالحب، شجر ورد، نجوم، ألف شمعة. غير أن هذا البناء الطوباوي قائم على وعي خفي بالتهديد، لذلك لا يكف النص عن محاولة طرد الحزن واستدعاء الأمل، بهذا المعنى يمسي النص مثالاً واضحًا على قدرة الغناء العربي الكلاسيكي على الجمع بين الطابع الغنائي والبعد السردي – ليس المقصود السرد بمعناه الحكائي-، بل السرد كاستراتيجية لصياغة الذات داخل اللغة؛ حيث يلتقي الصوت الفردي بالرمز الجمعي، ويتحول الحب الفردي إلى معجزة كونية، والإيهام إلى آلية وجودية، تحاول مقاومة القلق من الغد ودفع المصير المجهول.
* ناقد أدبي عضو لجنة التنمية الثقافية باتحاد كتاب مصر