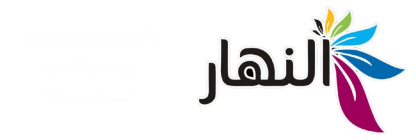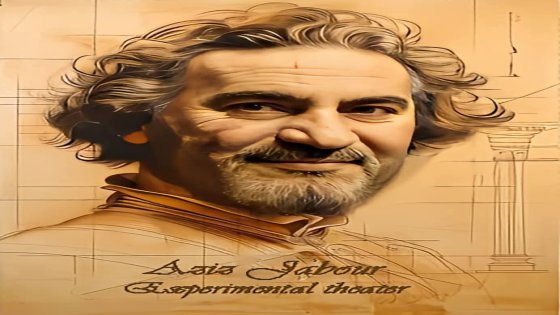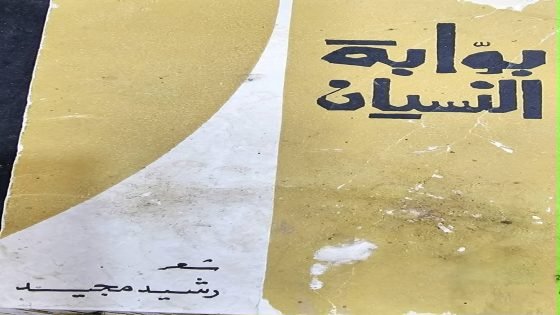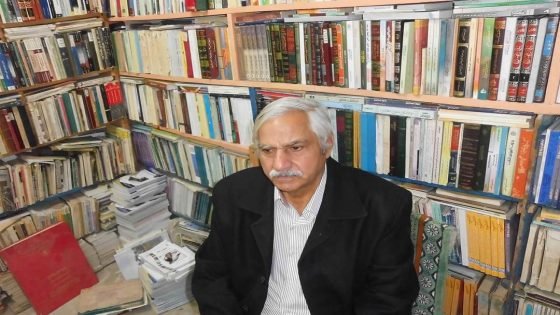عنوان الحكاية الاولى حكاية دواء… وصيدلانية..رقيقة
ما إن خرج من عيادة الطبيب، حتى وقف أمام صيدلية قريبة. دخل بخطى بطيئة،
قالت بخجل وهدوء:
– تفضل عمو…
أحسّ أن عينيها ليستا غريبتين. لم تكن النظرة عابرة، بل كأنها تخترق جدار ذاكرته المتعبة. تمددت صورة فتاة من زمن السبعينات أمامه، كانت تشبه هذه الصيدلانية بشكل غريب… نفس العيون، نفس الشفاه المرتبكة حين تبتسم.
مرّت الأيام، وصار يتردد على الصيدلية كثيرًا، يسأل أحيانًا عن دواء لا يحتاجه، وأحيانًا يكتفي بابتسامة وسؤال عابر:
– شلونج دكتوره
تسمرت عيونها به، لم يكن في داخلها، تساءلت: “ليش نظراته مو غريبة عليّ؟ وجهه كأنه من حكاية قديمة… من زمن أعرفه وما نسيته.”
هي تعرف، مثل ما كثيرون يعرفون، أن هناك من نحبهم من النظرة الأولى… أو ربما من الذاكرة القديمة التي لا نعرف متى زرعوا فيها.
ومرّت الأيام… صار يتردد على الصيدلية كثيرًا ، وفي إحدى المرات، جلس بهدوء وقال لها:
– تشبهين واحدة أحببتها في شبابي… سبحان الله، كأنك رجّعتيني إلها.
ابتسمت بلطف وقالت:
– وأنا أول يوم شفتك… حسّيت إنك مو غريب. يمكن لأن الوجوه اللي نرتاح إلها من أول نظرة، إلها مكان بداخلنا قبل حتى ما نلتقيها.
ضحك، ، ووقف قائلاً:
– شكراً على الدواء… والذكرى.
وظل يكرر مع نفسه المكان والحوارات مع الصيدلانية الرقيقة كلما مر منها
–(( وبعض الذكريات… تداوي أكثر من الأدوية.
– سبحان الله… مرة أحببت فتاة تشبهك إ
ابتسمت الدكتورة وقالت:
– يمكن أنا الدواء اللي نسيته من سنين!
ضحك، ثم سكت، وأدرك فجأة أن بعض الأدوية لا تُشترى… وبعض الحنين لا يُشفى.))
عنوان الحكاية الثانية*
اعترافات كاتب…
* حب مؤجل ونهاية مفتوحة.
في أواخر السبعينات، وبين قاعات الدرس وأحاديث الزملاء، وُلد حب صامت في قلب شاب خجول ، لزميلته الجميلة الهادئة. لم تدرِ به يومًا، ولم تُفتح نافذة بينهما، سوى سلام عابر ومجاملة بريئة.
مضت السنون، وافترق الجميع، لكنه بقي يحمل صورتها في ذاكرته… وجه لم يغب، حتى بعد أن تكسرت الملامح في زحام الحياة.
وبالصدفة، بعد عقود، وجدها على “فيسبوك”. أرسل لها طلب الصداقة، فوافقت. وعادت الأيام تمشي للوراء، لكنها لم تكن تدري أنها تُعيد فتح باب كان موصدًا منذ زمن بعيد.
صرح لها حبه بصراحة متأخرة. فاجأها، لكنها لم تغضب. كانت تتابع كتاباته وتعليقاته وتحاوره، وشيئًا فشيئًا أصبحا ثنائيًا ثقافيًا.
قالت له ذات يوم: “تكتب بروح شاعر، لكنك تضعف لغويًا أحيانًا.”
فردّ، كمن وجد خلاصه: “كوني شريكتي، ساعديني، لا أريد النجاح وحدي.”
وهكذا بدأت رحلة التعاون: قصص، مقالات، نصوص. كانت تلمّع جمله، وتضيف لمستهَا الخاصة. ازدهرت صفحته، كثر المعجبون، وأصبح أكثر حضورًا.
طلب منها أن يضع اسمها إلى جانبه، فقالت بخجل: “يكفيني أنك تكتب… فأشعر وكأني أنا من يكتب.”
تعلق بها أكثر، لكنه ظل يكرر: “كنتِ جميلة في شبابك…”
وكانت هذه الجملة تجرحها. أرادت أن يحبها كما هي، الآن، في هذا العمر، بهذا العمق، لا كذكرى قديمة.
قالت له ذات ليلة: “إذا لم ترَ جمالي الآن، فلا فائدة من حديثك عن الماضي…”
واستمرّا، رغم هذا الشرخ الصغير.
…وتوقفت الرسائل.
هو من بدأ بالعتاب، بكلمات قاسية لم يقصدها. أراد منها أن تبادله الحب كما في رواياته، أن تعترف له بشيءٍ صريح، لكنها اختارت الصمت، وهو لم يفهم أن صمتها أبلغ من الكلام.
مرت أيام، ثم أسابيع، ولم تأتِ منها أي رسالة.
وحين أدرك أنه أخطأ، كتب منشورًا مختلفًا عن كل ما سبق:
“بعض الغياب لا يُلام عليه الغائب، بل من دفعه للغياب… من ظن أن الكلمات وحدها تكفي دون احتواء.”
ثم بعث لها رسالة قصيرة:
“سامحيني… فكل ما كتبته بعدك، بلا طعم. افتقدك في النص، وفي الفكرة، وفي التصحيح. افتقدك كإنسانة كانت تضيء اللغة والمعنى. عودي، ولا تكتبي شيئًا… فقط كوني هنا.”
وأرفق مع الرسالة مسودة مقال غير مكتمل، وكتب في نهايته:
“ملاحظاتك؟”
ولأول مرة، لم يكن يقصد النص.
بل كان يقصد قلبه…
عنوان:الحكاية الثالثة مثقف وفنجان مرّ..*
جلس المثقف في زاوية المقهى، فنجان قهوته يتصاعد منه البخار كما تتصاعد من رأسه أسئلة لا تهدأ. دخلت قارئة الفنجان، جذبت أنظار الجالسين، تقدمت نحوه وقالت:
– أقرأ لك فنجانك؟
ابتسم بتردد، ربما يريد أن ينسى مؤقتًا أنه كاتب، مفكر، باحث… فقط ليكون إنسانًا عاديا يسمع شيئًا خارج منطقه اليومي.
ناولها الفنجان، وما إن قلّبته حتى بدأت:
– أنت رجل يحمل همًا كبيرًا… هناك كتابات لم تُقدّر، وناس لا تفهمك، تشعر أن لا أحد يراك كما يجب…
صمت، ثم قال بسخرية:
– هل قرأتِ الفنجان أم قرأتِ وجعي؟
ابتسمت وقالت:
– أحيانًا، الحبر لا يظهر إلا في قعر الفنجان.
ارتبك، شعر بغصّة… كم مرّة كتب، وكم مرة تجاهلوه؟ كم مرّة قال الحقيقة وسُجن في العزلة؟
تأمل في سخرية الموقف: هو المثقف، الذي يجتر الكتب واللغة والفكر، يجلس الآن أمام قارئة فنجان لتقرأ له ما يعرفه جيدًا… لكن لا أحد يسمعه.
فكر في نفسه: هل وصلت لمرحلة أحتاج فيها إلى قارئة فنجان كي أطمئن أنني ما زلت موجودًا؟
في النهاية، قال لها:
– شكرًا لأنك لم تضحكي من وجعي، كما فعلت الحياة.
نهض، ترك الفنجان مكانه…
ولكن هذه المرة، لم يكن الفنجان فقط ما فرغ… بل قلبه أيضًا.
عنوان: الحكاية الرابعة
حين يصبح الجهل كاميرا خفية*
في إحدى اللقاءات التلفزيونية، جلس فنان كبير، رائد في مجاله، بين يدي مقدم برامج شاب، يفتقر إلى أدنى درجات الإعداد والاطلاع. بدأ الحوار بسؤال غريب:
المقدم: “لو كنت كاتب معروف وعندك كتب، أو فنان تشكيلي عندك معارض، أو شاعر عندك دواوين، أو كاتب مسرحي، ماذا كنت راح تعمل؟ هل تفكر تعيش بس لتشتغل؟”
الفنان العريق، الذي كان ضيف الشرف لا الضحية، ابتسم بمرارة، وأجاب بهدوء لا يخلو من السخرية:
الفنان:”يا بني… أنا كل ما ذكرته وأكثر. كتبت، ورسمت، ووقفت على الخشبة، وصدرت كتبي، وسافرت بمعارضي، ونلت جوائز من هنا وهناك… لكن يبدو أن برنامجك لا يعرف ضيوفه، ولا يكلّف نفسه حتى قراءة سطر في سيرتهم.”
ثم أضاف بحزم:
“اذهب، ثقف نفسك. لا تعش في حياة ليس فيها ثقافة، لأن الجهل في مثل حالتك مهين لك، ولمن يشاهدك، ولي أيضاً.”
لحظات صمتٍ، وكأن الهواء انكمش في الأستوديو. وبدت الكاميرا كأنها توثق لحظة من “الواقع المؤلم”، لا “الكوميديا الخفية”.
فما حدث لم يكن مجرد فشل إعلامي… بل فضيحة للسطحية، وهزيمة للاحترام.
الحكايةالخامسة،،
“بين المسرح الإغريقي والمسرح التجاري… جدل لا ينتهي،
*بقلم: د.عزيز جبر الساعدي.
في إحدى الندوات المسرحية المغلقة، احتدم النقاش بين مجموعة من الكتّاب والمخرجين والنقاد حول هوية المسرح اليوم. هل لا يزال المسرح يحمل همّ الفكر الفلسفي العميق كما كان في الإغريق؟ أم بات أسير الضحك التجاري والنصوص السريعة التي تلهث وراء الجمهور؟
الكاتب الأول، المعروف بميوله الكلاسيكية، قال بحزم:
“أنا لا أكتب كي يُصفق لي، أكتب كي يَفكر الجمهور بعد أن يخرج. ما فائدة مسرحية تُنسى بعد ضحكتين؟ المسرح وُجد ليزعزع، لا ليُجامل”.
ردّ عليه الكاتب الثاني، بابتسامة ساخرة:
“وماذا عن الجمهور الذي لا يعود إن لم يجد ما يُفرحه؟ هل نكتب لفئة نُخبوية وننسى أن المسرح وُلد في الساحة العامة؟ الضحك لا يناقض القيمة، المهم أن يكون هناك صدق، مهما كان الأسلوب”.
هنا تدخلت المخرجة، التي تشرف على مشاريع مسرحية معاصرة:
“الناس تضحك اليوم كي تنجو من يومها. إن استطعتُ أن أُدخل الفكرة وسط الضحك، فهذا عندي انتصار مضاعف. لا أحد يمنعك من العمق، لكن لا تجعله مقبرة للمتعة”.
أما الناقد المسرحي، فقد جلس متأملاً وقال:
“نحن نُحمّل المسرح أحياناً ما لا يحتمله. المسرح ليس ديناً ولا طقساً منزلاً. إنه فن، يتنفس عبر الزمن، ويتغير مع الجمهور. الكلمة التي تبقى هي التي تجمع بين الوعي والإحساس”.
وفي نهاية النقاش، تكلم المسرحي المخضرم بهدوء، كما لو كان يلخّص كل ما قيل:
(وفيما يتهيأ الجميع للمغادرة، يتدخل “المسرحي المخضرم” الذي كان يجلس في الزاوية يستمع بصمت، يشرب قهوته بهدوء، ويقول)
دعوني أقول شيئاً يا أصدقائي…
كنتُ أظن أن المسرح يُكتب للخشبة، ثم أدركتُ أنه يُكتب للروح قبل كل شيء. لا الجدية وحدها تكفي، ولا الضحك وحده يشبع. الكلمة التي لا تترك أثراً، لا تنتمي للمسرح، سواء قيلت بدموع أو بنكتة.
نحن لا نُحاسب النص إن كان تجارياً أو فلسفياً… بل إن كان صادقاً. الجمهور ذكي، لكنه يتوه أحياناً. وإن لم نجد نحن التوازن بين الإمتاع والتأمل، فإن المسرح سيبقى خالياً، سواء صفقوا لنا أو لا.
(يصمت الجميع، وتغادر المخرجة أولاً وهي تبتسم، يلتفت الناقد نحو المسرحي المخضرم ويرهف السمع كما لو أنه يعيد النظر في كل شيء.)
*النهاية المفتوحة… المسرح لا ينتهي، لأنه انعكاس لصراعاتنا التي لا تنتهي.