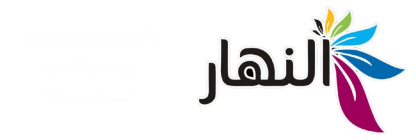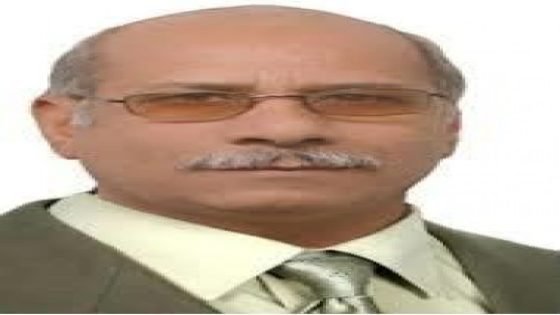تشتغل مجموعة عاشقات من ورق للشاعر حسين نهابة على ثنائية الفكرة والشكل لإنتاج الحكاية. فالشكلُ التدوينيُّ مرتبطٌ بالفكرة، والفكرةُ تأخذُ مميزاتِ الشكل، وكلاهما يُسقيان مجرى الحكاية التي تنطلق من عنوان النص إلى نهايته، باعتبار أنّ الترتيب الشكليّ يعطي دفعًا معنويًّا لانسياب الفكرة وفق تراتُب الأسطر. لذا، فإنّ التدوين الشعري في اشتغاله يأخذُ على عاتقه انهمار المفردات بطريقةٍ من السلاسة والتماهي مع فاعلية الحكاية. فالشكلُ يعني ربطَ الفاعلِ الشعريّ مع مفهوم سرديّة الشعر.
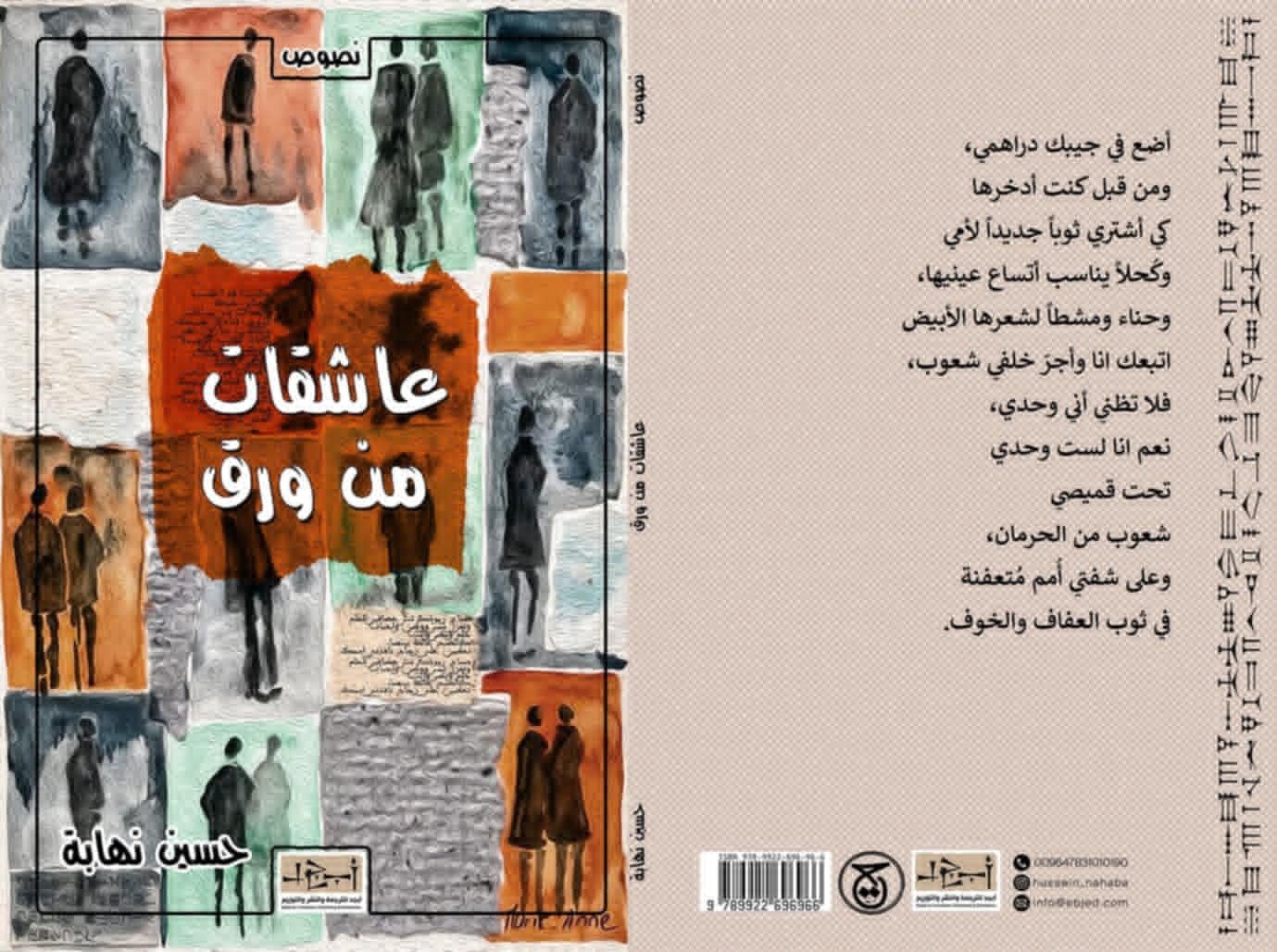
فاعلية العنوان
يأخذ العنوانُ الرئيسُ للمجموعة باعتباره البوابةَ التي تنطلقُ منها ثنائياتُ الاشتغال، مثلما تنطلق منها مفاعيلُ التدوين. فهو عنوانٌ ليس ضمن عناوين نصوص المجموعة التي بلغ عددُها 29 نصًّا، ممّا يعني أنّه أراد أن يكون بوّابةً كبيرةً تجمعُ الأبوابَ الصغيرة، وليس بابًا اختير من بين الأبواب كأجملها. ولو أخذنا قراءةً سيميائيّة لعناوين النصوص، لوجدنا أنّها تنتمي إلى فاعليةِ التقابلِ التراتُبي، التي ترتبط بالمركز العام/ العنوان الكُلّي. بمعنى أنّ جملة “عاشقات” قد تكون تلويحةَ فنٍّ معاصرٍ يُداعب العاطفةَ المتلقّية، مثلما تنطلق من فاعلية القصدية الشعرية. لكن ما اتصل بها (من ورق) يُحيل إلى الخيبة والخسران، ويمكن تفكيك فاعليّاته الاشتغالية إلى أكثر من إحالة:
أوّلًا: المفارقةُ بين “العشق” و”الورق”؛ فالعشق يدلُّ على حرارة العاطفة، واندفاع المشاعر، والتجسّد الحيّ للوله، أمّا الورق فيُوحي بالهشاشة، والسطحيّة، وربّما الزيف أو التمثيل. بمعنى أنّه يُنتج لنا مفارقةً شعريّة: كيف يكون العشقُ حقيقيًّا إن كان مصنوعًا من ورق؟ وكأنّ العنوان يقول: “هذا عشقٌ لا روح فيه… هذا عشقٌ مكتوبٌ لا معيش”، أو أنّه عشقٌ مؤجَّل، متخيَّل، أو حتى مُستهلَك.
ثانيًا: الدلالة الرمزيّة للورق، كونه مكانَ الكتابة والاعتراف، لكنه أيضًا مكانُ الخيال والتزييف. ولذا، فقد يُفهم على أنهنّ شخصيّات خياليّة، حبرٌ على ورق (ربّما بطلاتُ رواياتٍ أو قصائد)، عاشقاتٌ زائفات، يُشعلن نارَ الحبّ بالكلمات فقط، لا بالفعل، أو أنّهنّ ضحايا للحبّ المكتوب لهنّ، كأنّ أحدًا صاغَ لهنّ مصيرَ العشقِ دون رغبةٍ منهنّ.
ثالثًا: نبرةُ الأسى أو التهكّم، حيث يُوحي العنوانُ بنبرةِ أسى: هل صار العشقُ هشًّا إلى هذا الحدّ؟ أو بنبرةِ تهكّم: هل العاشقات اليوم من ورق؟ بلا حرارةٍ ولا لحمٍ ولا قرار؟
رابعًا: اشتغالٌ شعريٌّ مفتوح، حيث يشكّل العنوان عتبةَ نصٍّ قابلةً للتأويل، ويمكن أن يقود إلى نصوصٍ عن وهم الحبّ المعاصر. ولذا، فقد يكون أيضًا صرخة: كفاكم صُنع عاشقاتٍ من ورق، أو ربما يستحضر نساءً حقيقياتٍ سحقهنّ الحبر، أو اختبأن في ظلال القصيدة.
ويمكن القول إنّ العنوانَ يحملُ بُعدًا شعريًّا عميقًا، فيه توتّرٌ بين الحقيقة والزيف، بين الجسد والنص، بين النار والرماد. وهو يحمل جماليّته حتى في فاعلية القصيدة التي ترتّب الخيبة واليأس والنكوص… والصرخة أيضًا.
فاعلية الاستهلال وقيادة النص
يبدأ النصُّ الشعري من العنوان، لكنّ الاستهلال يُوضّح ماهيّة هذا العنوان وفاعليّة الاشتغال. فهو استهلالٌ استقباليٌّ للفكرة، وهو بابُ الاشتغال الشكليّ.
والنصُّ لديه يُرابط بين الشكل السردي وفحوى النص الشعري؛ فقصيدة النثر هنا فاعليةٌ تدوينيّة، شارحةٌ للفكرة، وضامنةٌ لقصدية الشعر.
بمعنى أنها تُمازج بين حالتي السرد والشعر لإنتاج القالب التمويهي، عبر استخدام لغةٍ ترتبط بهذا الاشتغال.
فالاستهلالُ أحدُ الاشتغالات التي تفضح القصدية، وتُرتّب الدخول إلى المستوى التأويلي.
وهذا متأتٍّ من وجود المستوى الإخباري.
وللاستهلال وظيفةٌ كاشفة لارتباط المبنى الكُلّي لفاعلية السرد وحكايته، وارتباطه بالأنثى التي ترتبط بالعنوان الرئيس.
ومن هنا فإنّ للاستهلال أكثرَ من معنى، كلُّها تقود إلى فاعلية الاشتغال على الفكرة التي يُريدها، أن تكون ذاتَ اتجاهٍ واحد، مرتبطٍ بتنوّع الانكسارات التي لها ارتباطٌ بكلمة (ورق) في العنوان الرئيس.
أوّلًا: الاستهلال الذي يأتي على شكل صرخة أو احتجاج
“لم تستطيعي يومًا
أن تحتوي وجعي
كرجلٍ قادمٍ من بلاد الحروب
والموت والفجيعة
أنا ابن مدنِ السَبَخ العقيمة
التي لا تنبت إلّا الحجر” استهلال نص: (ابن الفجيعة)
ثانيًا: الاستهلال الذي يأتي على شكل أُمنية
“هبيني رقعةً تناسب حجم جرحي
ورقّقي شقوقَ روحي
دثّريني بدفئك
فمنذ الحرب الأولى
لم أعرف امرأةً” استهلال نص(ارسمي وجهي)
ثالثًا: استهلال على شكل رجاء أو لحظة تأمل، مع انتقالٍ من المتكلّم إلى المخاطب، في اتجاه اشتغاليٍّ واحد:
“استعجلْ نهارَ اليباب
ليقرأَ مدوّناتك كلّ ليلة
كم يروق لي هذا الرَّب الأمين
حباني بأناملِك وشهوةِ انتظار!
وأعيش في حُلمٍ بديل” من استهلال نص: (الرَّب الأمين)
رابعًا: استهلال على شكل احتجاج، أو مرايا لكشف الزيف، يُوجَّه من الذات إلى الآخر/ هم، رغم كونه يأتي في شكل مناجاة سرد-شعرية:
“البارحة كان لي اسمٌ واحد
ووجهٌ واحد، ووجعٌ واحد،
اليوم صرتُ أبحث عن اسمي لأُرمّمه،
عنكِ، وعن وجهٍ مُسجّى
عند شارات الهزيمة” من استهلال نص (وجهه المتفرّد)
خامسًا: استهلال وصفيّ، يقود إلى شرح المستوى القصدي من النصّ، مبنيٌّ على إشاراتٍ قابلة للتأويل، تتصل بالانكسار الحاصل في الواقع الاجتماعي والسياسي، دون الوقوع في المباشرة:
“كانت أزقّة بغداد
مُترعةً بمساحيق الغسيل
وإطاراتٍ مهشّمةٍ لآباءٍ راحلين
وزينب ما تزال عاقرًا
تلوك الأُمنيات جهرًا
في انتظار الفانوس السحري” من استهلال نص (أزقّة بغداد)
سادسًا: استهلال استهجانيّ، ناقمٌ ومنتقدٌ للواقع الحاضر، يجعل من الماضي الفاعلَ الرئيس:
“في فجرٍ لم أعرفه بعد،
وغيرِ مُدوّنٍ في كتب التاريخ،
رحل أبي منتشرًا في كلّ بقاع الأرض الخصيبة
ترك لي لغةً مذعورة
وتذكرةَ حريّةٍ هاربة
وعهدًا مُعافى
وحبّاتِ رمانٍ تتفجّر
في عيون إخوته الصغار” من استهلال نص: (الأعور الأرعن)
فاعلية الحكاية وشاعرية السرد
تتركز أغلب نصوص المجموعة على تقابلية الأنا والآخر، سواء كان هذا الاخر انثى ام ذكرًا، أم هو ذاته يتحدث الى ذاته. وهي فاعلية التراتب الحكائي, فيأتي النص محلا بحكاية تراقب الفاعل السردي مثلما تعتمد على الفاعل الشعري. فهو مسكون بتنظيم اللغة وفق هذه المعيارية فاغلب النصوص لا تُبنى على خطابٍ غنائي محض كنوعٍ من الشعر العاطفي، بل تتجاوز ذلك إلى بناء حكائي/درامي داخلي يتوسل التوتر والصراع والتتابع، وهذه من سمات الاشتغال السردي داخل القصيدة الحديثة. ومن أبرز ملامح الاشتغال الحكائي:
أوّلًا: بنية خطابية سردية تبدأ من الحنين إلى الخيبة، وهذه تحتاج الى ترتب لفاعلية الخطاب المباشر
” آه لو تعرفين كم أتوق للقائكِ،
أنتِ أيتها الغائمة
في صحو عينيّ المتربصة بكِ
والمغتسلة بأيامي،
كقطة بيضاء، تعشق المطر” من نص ( العاشق المحاصر)
ثانيًا: الحكاية العاطفية التي تتحول الى نبرة اعترافية/ حكائية، تحمل ملامح التحول من الحلم إلى المأساة. إذ يُبنى النص على مسار عاطفي متدرج وفق معادلة اشتياق = رغبة = انقياد = صدمة =خيبة = حسرة نهائية:
” أعترف إني أعجز عن فهمكِ،
وأعجز أيضاً عن معرفة الفصل الذي
تمطر فيه عينيك
كعجزي عن معرفة موسم الحصاد” من نص (العاجز)
ثالثًا: دائما ما يكون في النص أكثر من شخصية من بينها الراوي/ الشاعر. والأخر هو أو هي. بمعنى وجود العاشق الذي يرسل الاعتراف والآخر المستلم لهذا الاعتراف، لذلك نرى أن النصوص في أغلبها تحكم الى ضمير المتكلم، وهناك في أغلبيها امرأة ويكون هناك دوما عامل التوتر وفاعلية البوح:
وعدتُ، مثلما أتيت،
محملاً بحضارة الوجع،
وكلّ سنين يوسف العجاف،
وبطاقة حمراء،
أن أظلَ أكتبُ الى لا امرأة” من نص(مدن من ورق)
رابعًا: الحكي وجود راو/ والراوي هنا هو الضمير المتكلّم وهو العاشق الخائب، ليكون بطلا في النص، على شكل ضحية محاصرة، يريد أعادة صياغة فاعلية ردة الفعل من مقابل الفعل الذي حصد الخذلان:
“هذا الماء لا يروي،
فأسقني قليلاً من رضابك
لأرتوي،
أعيني شفاهي الظمأى
على الركوع
والطاعة
والارتماء،
وأبعدي عن منجمي
كل الولاة القادمين
من أقاصي السراي
وكل الأفّاقين الحيارى
في دفن ألغاز ظمئهم” من نص (عطش)
خامسًا: من فاعليات الحكاية وجود المكان والزمان في تشكيلها، وهي دلالة التفاعل السردي مع النص الشعري، لذا يكون الزمن ليس بفاعلية اللحظة، بل زمن التحوّل والخراب، والمكان ليس حضورًا حسيًا فقط، بل حالة وجدانية مفقودة::
” كرجل قادم من بلاد الحروب،
والموت والفجيعة
أنا ابن مدن السبخ العقيمة،
التي لا تنبت إلاّ الحجر
في قلوب الرجال” من نص ( ابن الفجيعة)
سادسًا: في النص خاتمة تقترب من الحكاية السردية: وهي خواتم فاعلة تؤدي الى استثمار التراكيب اللغوية الشعرية المحملة بالشاعرية، حتى وان كان فيها قنوط كبير وخيبة أمل، ويجعل هذه النهاية مفتوحة على عدد من التأويلات:
” فلا أميّزُ وجهي فيهما
من وجه التي
ترمِ النرد بحكمة ذئب
وتنهِي لعبتها مُعلنة
عن ميتتي الأخيرة” من نص(اخوتي والنرد)
إن نصوص الشاعر نهابة تتميز بفاعلية الحكاية، وثنائية الفكرة والشكل، ليس بمعنى وجود خطّ زمني تقليدي، بل باعتبارها تجربة وجدانية حكائية، مثلما فيها الفاعل الدرامي من أجل نمو النص وفكرته، لهذا فان بنية الاشتغال تتكرر عنده في اغلب النصوص بتقنيات مرتبة تصاعديا.