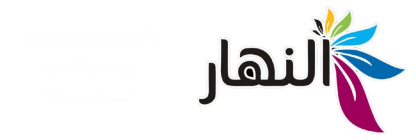حاورته / أسيل تركي
في زمن تتسارع فيه التحديات الصحية والنفسية، وتزداد فيه الحاجة إلى العقول النادرة التي تكرّس حياتها للعلم والإنسان، يبرز اسم العالم الدكتور عادل عبد الرحمن الصالحي كواحد من أبرز الروّاد في ميدان علوم العلاج النفسي والعصبي، ليس فقط في العراق، بل على المستوى العربي والدولي. هو الأستاذ والباحث والمخترع، الذي جمع بين الحس الإنساني العميق والعقل العلمي المنهجي، ليقدّم للبشرية إنجازات غير مسبوقة في فهم وعلاج اضطراب طيف التوحد.
في هذا الحوار الحصري، نفتح صفحات من سيرة حافلة بالابتكار، ونغوص في رؤى علمية تؤسس لمرحلة جديدة من التغيير، حيث لا تقتصر النظريات على قاعات المحاضرات، بل تمتد لتصبح سياسات وقائية وعلاجية قابلة للتطبيق.نتحدث اليوم إلى مؤسس نظرية EcoReproSpectrum، مكتشف بصمة التوحد الدماغية، وصاحب براءات اختراع ومنها تركيبة علاجية طبيعية لعلاج التوحد وهي قيد التجريب، والذي لا يرى في العلم غاية بحد ذاته، بل وسيلة لخدمة الإنسان، وتضميد جراح من يعانون في صمت.
في هذا اللقاء، يحدّثنا الدكتور عادل الصالحي عن رحلته، رؤاه، اكتشافاته، وطموحاته، ويضع بين أيدينا خلاصة تجربة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود من العطاء العلمي والإنساني…
- من هو الدكتور عادل الصالحي؟
أبدأ بتعريفي كإنسان قبل كل شيء، فأنا كعادل الصالحي، أؤمن بأن رسالتي في الحياة هي نشر الخير، وترك أثر إنساني وعلمي نافع يُسهم في خدمة البشرية، لا سيّما أولئك الذين يعانون في صمت. إلى جانب مسيرتي الأكاديمية، أنا كاتب ومؤلف وشاعر، وكنت رساماً محترفاً خلال فترة دراستي الجامعية في ثمانينيات القرن الماضي، كما أن لي شغفاً بالتصميم الفوتوغرافي والهندسي والمعماري. وعلى الصعيد الشخصي، أعتز بدوري كأب وزوج وربّ أسرة وجَدّ، وأرى في العائلة مصدر الإلهام الأول في حياتي.
أما من الناحية الأكاديمية والمهنية، فأنا أستاذ مشارك واستشاري في علوم العلاج النفسي والعصبي وباحث ومكتشف ومؤلف ومخترع، وأشغل منصب مدير قسم الصحة النفسية في مركز البحوث النفسية – هيئة البحث العلمي، في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. كما أرأس الجمعية العراقية للعلاج النفسي.
أمتلك خبرة تزيد عن 34 عاماً في العمل العلاجي والبحثي، وألفت أكثر من 22 كتاباً ومؤلفاً علمياً في مجالات متعددة، إلى جانب نشر العديد من البحوث والدراسات المحكمة في مجلات علمية دولية مرموقة. ومن أبرز إسهاماتي تطوير برامج علاجية وتجريبية مبتكرة، بينها تركيبة علاجية طبيعية واعدة لتحسين حالات التوحد، ما زالت قيد التجربة والتقييم العلمي، ونسأل الله التوفيق في نتائجها.
- ما الذي يحتاجه الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد؟
تتعدد احتياجات الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد بحسب المستوى الذي ننظر منه، وتشمل ثلاثة محاور رئيسة:
- على صعيد الدولة: يحتاج ذوو الهمم ممن يعانون من التوحد إلى استراتيجية وطنية متكاملة تبدأ بالتشخيص المبكر، وتوفير مراكز متخصصة مؤهلة، وتدريب الكوادر على أحدث الأساليب العلمية في التأهيل والعلاج. كما تبرز أهمية دعم العائلات نفسياً ومادياً، وربط مخرجات البحث العلمي بالتطبيق العملي على أرض الواقع. وقد قدّمنا بالفعل الاستراتيجية الوطنية العراقية للوقاية من التوحد والحد من انتشاره، وهي رؤية شاملة قابلة للتنفيذ على المستوى الوطني والعربي والدولي، ونأمل أن يتم تبنيها رسمياً وتعميمها قريباً بإذن الله تعالى.
- على صعيد العائلة: تُعد الأسرة الركيزة الأولى في التعامل مع الطفل، وتحتاج إلى تثقيف نفسي حقيقي، ودعم عاطفي واجتماعي مستمر، وتدريب متخصص على كيفية احتواء الطفل والتعامل معه بأساليب علمية قائمة على الفهم لا القمع. كما أؤكد على أهمية إجراء فحوصات ما قبل الزواج أو ما قبل الحمل، لتقليل فرص إنجاب طفل مصاب بالتوحد لا قدّر الله، ضمن إطار وقائي علمي.
- على صعيد الطفل المصاب: يحتاج الطفل إلى تقييم دقيق وتشخيص علمي حقيقي، يتبعه برنامج تأهيلي متكامل متعدد الأبعاد، يشمل التدخلات اللغوية والسلوكية، وتنمية المهارات الاجتماعية، والعلاج الحسي، والدعم الذاتي، إلى جانب برامج غذائية صحية داعمة. الأهم من ذلك هو احترام الفروق الفردية في قدرات الطفل، والعمل على مساعدته في الوصول إلى أعلى مستوى ممكن من الاستقلالية والاندماج.
- ما أبرز اكتشافاتك في مجال علاج المصابين باضطراب طيف التوحد؟
حقيقة وبحمد الله وفضله، كانت لي العديد من الاكتشافات العلمية الرائدة في مجال التوحد، والتي أُنجزت ضمن إطار بحثي مكثف ومترابط، ونُشرت في مجلات عالمية مصنفة ضمن الفئة Q1. ومن أبرز هذه الاكتشافات:
- تأسيس نظرية EcoReproSpectrum، وهي نظرية الجيل الرابع عالمياً في تفسير الأسباب الحقيقية لازدياد اضطراب طيف التوحد، من خلال ربط التلوث البيئي بتدهور الصحة الإنجابية وحدوث طفرات de novo الوراثية. هذه النظرية مدعومة بسلسلة من الأبحاث المحكمة، وليست مجرد دراسة واحدة.
- اكتشاف العلاقة الارتباطية القوية بين تدهور جودة الحيوانات المنوية لدى الذكور خلال الـ24 عاماً الماضية وبين ارتفاع نسب التوحد.
- اكتشاف العلاقة الارتباطية بين تدهور الخصوبة والصحة الإنجابية لدى الإناث خلال نفس الفترة، ودورها في زيادة حالات التوحد.
- تطوير تركيبة علاجية تجريبية طبيعية بالكامل ضمن براءة اختراع مسجلة رسمياً، أظهرت نتائج واعدة جداً في المحاكاة، حيث حققت نسب تحسّن فاقت 70%، وما زالت قيد التقييم في المرحلة التجريبية.
- اكتشاف بصمة التوحد في الدماغ عبر التحليل الإكلينيكي والنفسي العصبي، مما أسهم في تعزيز دقة التشخيص وتحديد التخصصات العلاجية اللازمة.
- إنشاء برامج علاج وتأهيل منزلي شاملة، مصممة بشكل فردي لكل طفل بحسب حالته وبيئته، لتكون بديلاً علمياً فعالاً في المناطق التي تفتقر إلى مراكز متخصصة.
- معرفة الأنواع المناعية الفرعية للتوحد (Immune Subtypes)، مما يساعد في تطوير بروتوكولات علاجية مخصصة لكل نمط بيولوجي.
- اكتشاف الارتباط بين فصائل الدم وعامل Rh وبين خطر الإصابة بالتوحد، وهو من الاكتشافات النادرة عالمياً.
علماً أن كل هذه الاكتشافات تُعد من النوع الأول عالمياً، ولم تُسبق علمياً من أي جهة بحثية أخرى في هذه الصيغة التكاملية، مما يجعلها مساهمة فريدة في فهم وتطوير آليات الوقاية والعلاج للتوحد.
- ما الذي تفتقر إليه الجامعات اليوم لتطوير العملية التعليمية من وجهة نظركم؟
تواجه الجامعات في عالمنا العربي، وفي العراق بشكل خاص، تحديات حقيقية تعيق تطور العملية التعليمية والبحثية. من أبرز ما نفتقر إليه هو الربط الفعلي بين البحث العلمي والتطبيق العملي؛ فكثير من المشاريع البحثية القيّمة تظل حبيسة الأدراج، دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، بسبب غياب آليات التكامل مع مؤسسات الدولة وقطاعات الصناعة والصحة والمجتمع المدني.
كما أن ضعف التمويل وقلة دعم الباحثين يشكلان عقبة حقيقية أمام تطور الابتكار، إذ يواجه الكثير من الباحثين صعوبات في تأمين الموارد اللازمة لتطوير أبحاثهم أو الاستفادة من نتائجها.
ومن التحديات الجوهرية أيضاً غياب الاستقلالية الأكاديمية في بعض المؤسسات، وضعف الحوافز للباحثين الشباب، وعدم وجود بيئة محفّزة على الإبداع والمبادرة. نحن بحاجة إلى سياسات تعليمية واضحة تشجّع على النشر العلمي العالمي، وتربط الترقية الأكاديمية بجودة البحث وأثره المجتمعي، وليس فقط بعدد الصفحات أو المجلات.
ولا يمكن أن تنهض الجامعات دون شراكات فاعلة مع مؤسسات علمية دولية، تتيح تبادل الخبرات، وتطوير برامج بحثية مشتركة، وتفتح آفاقاً جديدة للطلاب والباحثين.
وأخيراً، المطلوب ليس فقط إنتاج المعرفة، بل تطبيق مخرجات البحوث في واقع الناس، وربطها بحلول عملية لمشكلات المجتمع. حين يتحقق ذلك، ستتحول الجامعات من مؤسسات تعليمية تقليدية إلى محركات حقيقية للتنمية المستدامة والتغيير الإيجابي.
- ما هي طموحاتك المستقبلية؟ وأين ترى نفسك اليوم؟
أطمح إلى تأسيس مركز بحثي إقليمي متكامل ومتخصص في التوحد والاضطرابات النمائية، يكون بمثابة مرجعية علمية متقدمة في العالم العربي، ويجمع بين البحث العلمي الرصين، والتقييم والتشخيص متعدد المحاور، والعلاج التأهيلي الشامل المبني على الأدلة، بالإضافة إلى تدريب الكوادر المختصة وتأهيل الأسر. هذا المركز سيكون منصة لتطوير بروتوكولات علاجية متقدمة، وبناء قاعدة بيانات وطنية وإقليمية تساعد في رسم السياسات الصحية المستقبلية المتعلقة بالتوحد والاضطرابات المرتبطة به.
كما أعمل حالياً على تنظيم مؤتمر علمي دولي مستقل، يستضيف نخبة من العلماء والباحثين من مختلف دول العالم، لعرض نتائج أبحاثي، وخاصة نظريتي EcoReproSpectrum، التي تكشف الجوانب المناعية والوراثية للتوحّد. يهدف المؤتمر إلى تحفيز حوار علمي بنّاء، وتبادل الخبرات، ووضع أسس جديدة للتعاون البحثي الدولي.
أرى نفسي اليوم في موقع مسؤولية علمية ووطنية كبيرة، أعمل من خلاله على ربط المعرفة الأكاديمية بمشكلات المجتمع الواقعية، والمساهمة في تحويل العراق إلى مركز إقليمي رائد في المجالات الطبية النفسية والعصبية. رؤيتي تتجاوز الإنجاز الفردي إلى إحداث تغيير حقيقي في حياة الأسر، وتعزيز ثقافة التقبل والدعم والتأهيل، وبناء مجتمع أكثر وعياً واحتواءً لذوي اضطراب طيف التوحد.
- ما هو السؤال الذي تمنيت أن يُطرح عليك؟
السؤال الذي لطالما تمنيت سماعه هو:
))كيف يمكن تحويل النظريات العلمية إلى سياسات وطنية ملموسة تسهم في وقاية المجتمع من الأمراض النفسية والنمائية..؟))
لأن هذا السؤال يُجسد جوهر عملي ورسالتي البحثية، التي لا تقتصر على النشر الأكاديمي أو التنظير النظري، بل تسعى بعمق لتحويل المعرفة العلمية إلى أدوات حقيقية لصناعة القرار الصحي والاجتماعي. لقد بذلت سنوات طويلة في تأسيس نظريات مدعومة بأدلة وبحوث ميدانية، مثل نظرية EcoReproSpectrum، والتي تربط بين التلوث البيئي، وتدهور الصحة الإنجابية، والطفرات الوراثية الجديدة (de novo mutations)، بوصفها عاملاً مركزياً في ارتفاع معدلات اضطراب طيف التوحد. هذه النظرية ليست فقط إضافة معرفية، بل خُططت منذ البداية لتكون مرتكزاً لوضع بروتوكولات وقائية وتشخيصية وعلاجية قابلة للتنفيذ على مستوى الدولة.
للأسف، لا تزال الفجوة واسعة بين مخرجات البحث العلمي ومتخذي القرار في الكثير من بلداننا، ولهذا فإن أحد أهدافي الكبرى هو بناء جسر عملي بين المختبر والواقع الميداني، عبر تقديم استراتيجيات وطنية قابلة للتطبيق، وتدريب الكوادر على تنفيذها، وبناء قواعد بيانات لدعم صناعة القرار، والمشاركة الفعلية في صياغة سياسات الصحة النفسية والتنموية.
فالعلم إذا لم يُترجم إلى أثر ملموس في حياة الناس، يبقى ناقصاً مهما بلغت درجة تعقيده. وأنا أؤمن بأن مسؤولية الباحث الحقيقي لا تقف عند حدود النشر، بل تبدأ من هناك.
- ما رؤيتك لتطور علاج التوحد في الدول المتقدمة؟ وما الذي ينقصنا لنصل إلى مستواهم؟
في الدول المتقدمة، يُعد التعامل مع اضطراب طيف التوحد نموذجاً متكاملاً للجمع بين التطور العلمي والاستثمار المجتمعي طويل الأمد. هذه الدول تعتمد على البحث العلمي بوصفه الأساس الأول لبناء البرامج العلاجية والتأهيلية، وتخصص ميزانيات ضخمة لتطوير أدوات التشخيص المبكر، وتوسيع نطاق التدخل متعدد التخصصات، وإنشاء منظومات دعم مجتمعي وأسري مستدامة.
تُولي تلك الدول اهتماماً بالغاً بتدريب وتأهيل الكوادر في مجالات علم النفس العصبي، العلاج الوظيفي، علوم السلوك، والتكنولوجيا المساندة، ما يجعل من رحلة العلاج عملية تراكمية تبدأ منذ السنوات الأولى من حياة الطفل، وتستمر ضمن إطار شمولي وليس حلاً وقتياً.
فضلاً عن ذلك، توجد سياسات عامة واضحة المعالم تُشرك الأسرة بشكل مباشر في العملية التأهيلية، وتعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتمنح المجتمع المدني دوراً رقابياً وخدمياً فاعلاً. كما تمتلك تلك الدول بنية تحتية رقمية متقدمة لجمع وتحليل البيانات، مما يتيح لصانعي القرار تعديل السياسات والبروتوكولات العلاجية بشكل مستمر بناءً على الأدلة الواقعية.
أما في منطقتنا، فنحن لا نفتقر إلى العقول أو الطاقات، بل نفتقر إلى بيئة حاضنة حقيقية. التحدي الأكبر يتمثل في ضعف الإرادة المؤسسية، وغياب السياسات التطبيقية، وندرة الدعم المالي المخصص للبحث العلمي، إلى جانب ضعف ثقافة الاستفادة من نتائج الأبحاث في صناعة القرار.
وللوصول إلى مستوى الدول المتقدمة، نحن بحاجة إلى:
- إطلاق برامج وطنية لتدريب الكوادر المحلية وتأهيلها وفق المعايير العالمية.
- تحديث المناهج والممارسات العلمية في الجامعات ومراكز التدريب.
- بناء منظومات تشخيص مبكر مبنية على أسس علمية دقيقة.
- تطوير قاعدة بيانات وبحوث وبائية تساعد في فهم الواقع المحلي.
- والأهم من ذلك، ربط البحث العلمي بصياغة السياسات الصحية والاجتماعية، وضمان متابعة تطبيقها على أرض الواقع.
حين ننجح في ذلك، يمكننا أن نحلم بحدوث نقلة نوعية حقيقية في التعامل مع اضطراب التوحد، لنكون ليس فقط ضمن الدول المتقدمة، بل من المساهمين في التقدم العالمي بهذا المجال.
- هل هناك حكمة تؤمن بها وتشكل مرجعاً في مسيرتك المهنية والإنسانية؟
نعم، الحكمة التي أؤمن بها وترافقني في كل خطوة من حياتي تقول:
“ليس المجد أن تصل وحدك، بل أن تفتح الطريق لغيرك وتمنحهم النور ليستكملوا المسير.”
فالعلم الذي لا يُنير دروب الآخرين، ولا يُترجم إلى أثر في حياة الناس، يبقى ناقصاً مهما بلغت قيمته النظرية. الإحسان في العمل، والنية الخالصة لخدمة الإنسان، هو ما يجعل لكل إنجاز معنى، ولكل تعب قيمة.
- ماذا تقول لمن يهاجمك أو يحاول التقليل من علميتك أو تشويه سمعتك؟
من يسير في طريق التغيير الحقيقي، ويطرح أفكاراً غير مألوفة، ويكشف حقائق قد تزعج البعض، لا بد أن يتعرض للهجوم. هذه سُنّة الحياة والعلم والتاريخ. وأنا على يقين بأن الهجوم لا يوجّه نحو الفراغ، بل نحو التأثير، ولا يُلاحق إلا من أحدث فرقاً وكسر المألوف.
أنا لا أُنكر أن التشويه قد يكون مؤلماً، خاصة عندما يتجاوز حدود النقد العلمي إلى الإساءة الشخصية أو الافتراء، لكنه لا يهز قناعاتي ولا يُثنيني عن طريقي.
أواجه ذلك بالثبات، وبالعمل المتواصل، وبنتائج علمية منشورة في أعلى المنصات المحكمة، وبشهادات الواقع واعترافات منصفين من الداخل والخارج.
لا أرد على كل متجاوز، لأني أؤمن أن الصمت أحياناً أبلغ من ألف رد، وأن أعظم ردّ هو الاستمرار في الإنجاز. فليتكلم من شاء، وليشكك من شاء، فالمعادلة محسومة: الحقيقة تحتاج وقتاً، لكنها لا تسقط أبداً.
أمّا من يحاول تقليل من علميتي أو إنكاري، فأقول له:
العلم لا يُقاس بالصوت المرتفع، ولا بعدد المتابعين، بل بجودة ما يُقدّم، وبعدد من استفاد، وبقدرة الفكرة على أن تعيش بعد صاحبها.
رسالتي أسمى من أن تُشوَّه، وطموحي أوسع من أن يُحاصر، وضميري مطمئن بأن ما أقدمه نافع، نقي، وموجّه لوجه الله سبحانه وتعالى وخير الإنسان.
وفي النهاية، أترك التاريخ والعلم والنتائج هي التي تتكلم.
وأثق أن من يهاجم اليوم، سيقف غداً – ولو بصمت – احتراماً لما بُني بصبر، وثُبّت بصدق.
- ما هي رسالتك في الحياة؟
رسالتي في الحياة أن أزرع أثراً لا يُمحى، وأن أكون صوتاً للعلم الصادق، ويداً تمتد لمن يعاني في صمت، وعقلاً لا يرضى بالجمود ولا يسكت عن الحقيقة.
أؤمن أن الإنسان لا يُقاس بما يملك، بل بما يقدّم.
وأن الله يبارك في العمل الذي يُقصد به الخير، حتى وإن تأخر اعتراف الناس به.
أسعى أن أُسخّر علمي وخبرتي لخدمة من لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم، خاصة الأطفال المصابين بالتوحد، وأن أكون حلقة وصل بين المعرفة النظرية والتغيير العملي في حياة الناس.
رسالتي أن أترك علماً ينتفع به، وسبيلاً واضحاً للذين يأتون من بعدنا، وأبني جسراً بين الحلم والممكن، بين الصمت والأمل، بين الألم والشفاء.
وفي الختام، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكم على هذا الحوار الهادئ والعميق، وعلى منحكم لي هذه المساحة للتعبير عن رؤيتي ومشروعي الإنساني والعلمي... شكراً جزيلاً..