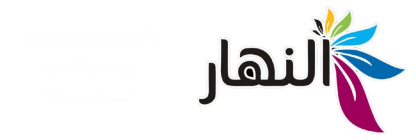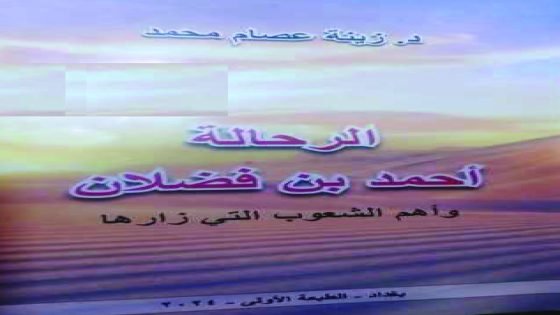في روايته “توهمت أني.. أحلم”، يقدم الروائي فريد الطائي نصا سرديا متداخلا بين الواقعي والوجداني، تتبع فيه رحلة شاقة ومركبة لطبيبين عراقيين يهربان من قبضة الدكتاتورية نحو أفق أكثر حرية، لكنه لا يخلو من المرارة والانكسار. لا تنتمي الرواية إلى أدب الرحلات بالمفهوم الكلاسيكي فحسب، بل تتقاطع معه وتجاوزه لتقدم ما يمكن تسميته بـ”أدب العبور”، حيث الانتقال بين الأمكنة ليس غاية سياحية أو ثقافية، بل وسيلة للنجاة وتحقيق الذات، ومجالا لكشف الصدمات والتمزقات النفسية والاجتماعية في بلاد الغربة.
*التحليل
بعد تعرض طارق للاعتقال في بغداد، ومروره بتجربة تحقيق قاسية بسبب دفتر دوّن فيه أفكاره دون أن ينشرها أو يبوح بها، تقرر مصيره بالفرار. بعد الإفراج عنه، قرر أن يحقق حلمه القديم بالسفر وإكمال دراسته في الطب في إنكلترا، فاصطنع جواز سفر مزور واصطحب صديقه محمد في رحلة محفوفة بالمخاطر، ابتدأت بعبور الحدود العراقية إلى عمّان.
*عبور لا إقامة
اعتمد فريد الطائي في روايته على نمط “العبور”، لا الإقامة، وهو ما يجعل العمل يلامس أدب الرحلات من زاوية غير تقليدية، إذ لا يقيم الشخصيات في الأمكنة، بل يجعلها تمر عبوراً، وتمرر معها أسئلتها وأزماتها. تنقل السرد بين ثلاث محطات: عمان، وتونس، وطرابلس، مع التركيز على التجربة الوجودية والنفسية أكثر من الجغرافيا والتفاصيل الاجتماعية.
*المحطة الأولى: عمان
مع اجتياز طارق ومحمد الحدود ووصولهما إلى العاصمة الأردنية، يبدأ الراوي بوصف المدينة:
“مدينة بيضاء جبلية، تجمع بين القديم والحديث، بشوارعها المرتفعة وأزقتها المتعرجة… الساحة الهاشمية، المدرج الروماني، ازدحام الناس من مختلف الجنسيات، حلويات حبيبة والكنافة الشهيرة…” (ص87).
رغم هذا الاستهلال البصري الغني، يتوقف الوصف سريعا، وينقلنا الروائي مباشرة إلى مطار عمان، استعدادا للسفر إلى تونس، دون منح القارئ فسحة كافية لاكتشاف المدينة أو ثقافتها من خلال عيون المغتربين.
المحطة الثانية: تونس – عبور خاطف
يقتصر حضور تونس في الرواية على جملة عابرة: “أبهرهم الطريق بعد بزوغ الفجر، المظلل بالأشجار العالية” (ص88)، بينما ينتقل طارق ومحمد سريعاً بسيارة أجرة إلى طرابلس، وكأن تونس مجرد معبر لا أكثر، رغم ثرائها الاجتماعي والثقافي الذي كان من الممكن توظيفه دراميا.
المحطة الثالثة: ليبيا – المستقر المؤقت
في طرابلس، تبدأ مرحلة جديدة من السرد، حيث يعمل الصديقان كطبيبين في مستشفى، ويتعرفان على شخصية محورية هي “صالح” رجل الأعمال الليبي، الذي يسهم في دمجهما في الحياة الليبية. هنا، يظهر الطائي قدرة وصفية لافتة لبعض ملامح الحياة الليبية، رغم أن تركيزه ظل منصبا على الحبكة الخاصة بمحمد وفاتن، وزواجهما المفاجئ ثم وفاة محمد إثر مرض مفاجئ.
ينجح السرد في نقل مشاهد الحياة اليومية:
- مشهد الصيادين: “وجوههم سمراء متعبة، أخاديدها تحكي عن الشقاء، وملامحهم مطبوعة بالشمس والماء” (ص97).
- تجربة الخمرة المحلية: “لم يتذوقا مثل هذا الشراب من قبل… مذاقه عسل، عالم تخييلي، كلمات تنبع من مخابئ الروح” (ص103).
- إشارات عابرة للآثار الرومانية المنتشرة في طرابلس، ومسارات التاريخ على الشاطئ (ص108).
تتجلى لمسة الطائي الأنثروبولوجية بشكل أوضح في وصفه لمظاهر عيد الفطر في طرابلس: “صوت الجوامع، ازدحام الشوارع، الأطفال في ملابسهم الزاهية، الزيارات بين الجيران، الشوارع نابضة بالفرح”، وكذلك حين يمر على تعثر الرواتب وتأثير البيروقراطية على المغتربين الأجانب (ص115).
في المشهد الختامي، ينتقل طارق إلى مدينة ساحلية (لم تسم)، تبعد ساعة واحدة عن طرابلس، ويندهش من سحرها وجمالها، بينما يصفها صالح قائلاً: “الناس هنا يعشقون الحياة، النساء، الخمر، القمار، التسكع على الشاطئ” (ص158).
كل ذلك يشي بحياة متناقضة، فيها الترف واللهو مقابل التعب والضياع.
الخاتمة:
رواية “توهمت أني.. أحلم” لفريد الطائي لا تروي فقط رحلة طبيبين هاربين من القمع، بل تكشف عن تشظي الهوية والمنفى الداخلي الذي يحمله الإنسان معه أينما حل. عبر محطات العبور من عمّان إلى طرابلس، يرسم الطائي خريطة قلق روحي وثقافي، يغلب فيها الهاجس الوجودي على التوثيق المكاني. وبين الحب، الموت، الحنين، والتوجس، يكتب الطائي نصا عن وطن ضائع يسكنه أبطاله في ذاكرة المدن، لا في جغرافيتها. ورغم بعض الاختزال في وصف العواصم الثلاث، إلا أن الرواية تسجّل لحظة إنسانية معقدة في زمن عربي متشظ، يدفع فيه الحالمون إلى العبور بدل الاستقرار، وإلى التوهم بدل الحلم.