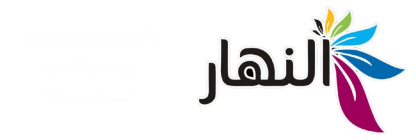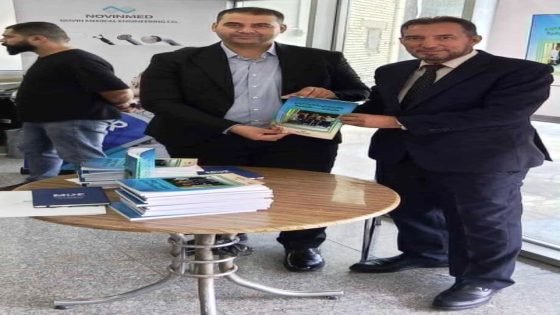دراسة بنيوية .. فنيّات صناعة المجهول في “سؤال النار” لعلي لفتة سعيد
قراءة / : أ.د. حمّام محمد
حين أبدأ الكتابة عن روايةٍ ما، لا يُخالجني أنّ البحث في عناصرها السردية المتفق عليها هو قُدُسِيَّةٌ في المجتمع الإنساني، وإنما أحاول أن أوجّه سؤالًا ناريًّا يُشبه جوهر السؤال الذي أفاضت به رواية الكاتب العالمي علي لفتة سعيد في “سؤال النار” الصادرة حديثا عن دار اسكرايب المصرية. وكان سؤالي: هل وُفّق عليّ في تسمية سؤاله بـ”سؤال النار”؟ وما مدى حضور “النار” في معجمه التعبيري؟ هل هو تفريغٌ من كل عَطَبٍ، أو خالٍ من آثار التعجّب أو الإطراء في عمل هذا الرجل الذي يشهد له الجميع بالإبداع؟
كما قلت، فإنّي أتعامل مع النقد كقصة تطال الجوهر الأصيل، كما لو أنّ عليّ لفتة يريد العودة إليه في الأزمنة الرائعة التي ساهمت فيها حركة بابل وآشور وغيرها من الحركات التي أيقظت جنس الكتابة. فكلّما اقتربنا من الأصل، اشتعلت النار، حسب ظنّ النمرود حين أوقد أُوارَها ليُشغل الناس بها بتكليم إبراهيم. ولكن لما كان الأصل قويًّا ومرتبطًا بمرجعية قرآنية، كانت النار عليه بردًا وسلامًا.
ومهما كانت أخطاؤنا أو مسارعتنا في اتخاذ القرار ذكيّة، إلّا أنّها قد تُخطئ أو تُصيب. ولهذا، سنعمد الآن إلى تطبيق اتجاهات الكاتب المعروفة في الرواية.
اتجاه الإشكالية والبحث في غموضها:
يتمثّل هذا الاتجاه في استحضار التذكّر الكياني ومحنة التعريف بالذات بعد موت الأب وتفحُّم جسده، حيث ظنّ الكاتب أنّها قَتَامةُ الصراع، فجاء سؤال الشظية لما نُعايشه من صراعات. فالكاتب يطرح هذا الجزء، الذي في نظره مؤلم، كأحد دعائم تكوين سؤال النار القادم، رغم أن وضعه المستقرّ واضح، وهو ما يُعبّر عنه بقوله:
“نعم، أصابني التردّد والخوف الذي لم يصل إلى حدّ الرعب، أو بالأحرى جعلني مُصابًا بالقلق، أعيش في حالتين متناقضتين: الأولى مع أمي وزوجتي ومكان عملي حيث العشرات إن لم أقل الآلاف من الناس الذين ألتقيهم.”
حين تشكّلت إشكالية الدمار، تحدّث القاصّ عن شظيّة الموات في كل لحظة، لأنّه عاصر زمن التفخيخ، فكان من الطبيعي أن يشعر الإنسان بالكراهية، وأن يرى كلّ ما يحيط به مفجوع القيمة ومنزوع الدسم. ووجد أخيرًا إشكاليّته في الكتب المُؤنِسة، وتاه في القراءة وعلومها، ممّا أضفى نوعًا من التثاقف على الشخصية المحورية، وهو حال شخصياته عمومًا، وكأنه يتحدث عن نفسه. وهذا ما يُؤكده قوله:
“وأنا ألوذ بكل الكتب التي قرأتها، حتى خُيّل لي أنّي مهووس بها، وتعلّقي بها صار أشبه بمن أُصيب بداء القراءة لنوعٍ معيّن، مثل داء من يعشق الكتب ويشتريها وإن كان فقيرًا لا يملك إلّا ما يسدّ به رمقه.”
وذلك شِيمةٌ في العربي منذ القدم، يجمع العلوم ولو كان به خَصاصَة.
ويُضيف بُعدًا من الحكمة في موضوع التراث والثقافة بنظرة إيجابية لا تخلو من نقدٍ ليس قاسيًا على الإنسان، بل على ما يُدوَّن. انظر إلى قوله:
“ما هو مُدوَّن ليس صحيحًا، بل سبب كوارثنا اليوم هو أخطاء التدوين وتناقض المُدَوِّنين.”
اتجاه التعبير عن المدينة أو الاحتواء:
المدينة هنا هي بغداد، والمسافة “ألف سنة ممّا نعدّ”…
الوطن مغروس في الروح والجسد، وهو ما هام فيه صاحب سؤال النار حين يتطلّع من نافذته إلى بغداد، فيرى العالم مقلوبًا على بشائر التثاقف في هذا البلد، الذي حلّ فيه وولد فيه.
يظهر مقياس الوعي في النهم المعرفي من خلال المطالعة المستمرة للروائي، الذي يرى عالم رواياته في مكتبة مكتنزة بالمعارف وأسرار الحروف. إنها خيار كلّ المثقفين في العالم. وهو الجانب المهم الذي لا تظهر آثاره إلّا عندما تندمج الفرص وتُظهرها الكتابة، مرّة في شكل لوعة، ومرّة في صورة بيانية، تجدها أجمل عطية من ممالك القِرْم حين تتراءى لمستكشفي العرب.
يواصل الراوي اعتناقه للقراءة، وكأنه يقول: “أنا لا أكتب، بل أقرأه في خيالي”. فقد أضاف بُعدًا قرائيًّا لقراءته السطحية لمدوّنة الكتب. إنه يقرأ من صُوَره المُلتقطة في عقله المتناصي، وإلا لاعتبرنا ما يقرأه نوعًا من الأخيلة. وهذا ما لم نعتده من علي لفتة، الطارق لكثير من المشكلات الاجتماعية والنفسية.
اتجاه الوجود الوالدي والتديّن:
هنا يدخل الراوي إلى حقيقة الوالدين، وكيف رفعهما العليُّ مكانًا عليًّا من الإحسان. رغم أن الوالد متوفّى، فإنّ الأم كانت مثالًا للحياة القديمة والحالية، التي اختلطت عليه فيها كل الصور. لم يقرأ لنا صفحات مشرقة من كتاب الأم ذات الوجه الدائري الجميلة في نظر والده، بل قرأ القراءتين معًا: قراءة الوالدة، وقراءة المكتوي الباحث في سؤال النار.
ومعيار التديّن له محلّ في سؤال النار، حين أشار إلى وقت الظهيرة برسم طريقة الصلاة، وتوشّح بلباس الملائكة، وهو ما جعلني أقول — ولا أزال — إنّ أسلوب عليّ المعرفي يريد أن يطرق كلّ النواقص والنقائص في مثالب الحياة التي تعيشها شخوصه. وهو ما يُعبّر عنه من خلال تفاصيل قراءاته المتعددة.
إنّ لون المُثاقفة في هذا الفصل هو لون أرجواني، له علاقة بمجموعة الكتب المُجمّعة منذ عصر بابل إلى يومٍ تُرشَقُ فيه بالمصداقية. فـسؤال النار بدأ يستقيم مع قول الصدق أو الكذب…
الرواية في شموليّتها سردٌ ضافٍ بأفقٍ جديد يواكب الرواية الحداثيّة المُخضرمة بأشياء منقولة من الماضي العريق للرواية العراقية. إنّ أزمة صناعة المجهول هي وليدة القراءة المتعمّقة في التخييل المستقبلي غير المنفصل عن القراءة الرقمية لعالم الإبداع الرقمي، وإن كانت النقولات هي ذاك الشك الفلسفي الذي يحاول علي لفتة من خلال شخوصه، وبعضٍ من عتباته الكثيرة، أن يُرمز دلاليًّا لمُعضِلة الراوي التقليدي.
فأساس تقدّم الرواية يجب أن يمسّ في شموليته الواقع المعرفي الرقمي، عندها فقط يمكن أن نتحدث عن طموحٍ تصنعه أسئلة الفلسفة… الألم، الذاكرة، والهوية، فيما يحاول علي لفتة سعيد أن يُمسك بجمر الحياة ليصوغه نصًّا يستعصي على الاحتراق.
وهناك ايضا ما يمكن الغوص في متاهات التخفّي والنُّشوز الفلسفي في رواية “سؤال النار”.
*ناقد جزائري