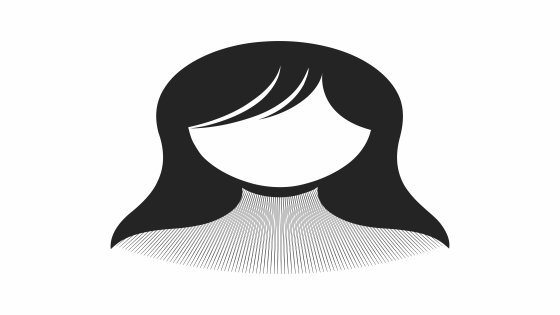من يقترب من عالم شوقي كريم في القصة القصيرة، يدرك سريعًا أنه لا يكتب الحكاية بوصفها حدثًا، بل بوصفها رعشة. القصة عنده ليست ورقة تُطوى، ولا حيلة تفضي إلى نهاية مفاجئة، بل كوة يطلّ منها على مناطق مظلمة في النفس، تلك التي يحاول الإنسان إخفاءها بضحكة أو انشغال يومي. ولعلّ أول ما شدّني إلى كتاباته القصصية هو ذلك الإحساس الذي يتركه في القارئ: إحساس بأن العالم ليس مستقرًا كما نظن، وأنّ تحت الجلد دائمًا ما يتحرك خوف صغير، قلقٌ لا اسم له، لكنه حقيقي بما يكفي ليوقظك في منتصف الليل.لقد جاءت القصة القصيرة إلى شوقي في لحظة كان يبحث فيها عن لغة لا تطيل الوقوف عند التفاصيل، بل تلامسها ثم تمضي، مثل يدٍ تمسح جدارًا قبل أن تترك عليه أثرًا لا يزول. كان يريد فنًّا يشبه حياته: سريعًا، ملتهبًا، لحظيًا، لكنه عميق كجرح قديم. وهكذا، صارت قصصه أشبه بومضات، كل ومضة تنير مشهدًا داخليًا، ثم تنطفئ، لتترك القارئ مع الظلال التي خلفتها. لا أذكر أنني قرأت له قصة قصيرة دون أن أشعر أنّ المشهد الذي بناه لا يزال يواصل حياته بعيدًا عن الورق، كأن الشخصيات التي مرّت أمامي لم تذهب، بل بقيت تنتظر في زاويةٍ ما من الذاكرة.ما يميّز شوقي في هذا الفن هو تلك القدرة على إعادة تشكيل اللحظة العادية حتى تتحول إلى مرآة قاسية. رجل ينتظر، امرأة تنظر من نافذة، طفل يُفتش عن شيء لا يعرف اسمه… لحظات بسيطة، لكنها في يده تتحول إلى فضاءات كاملة، تملؤها الرهبة والشفقة، ويوشك القارئ أن يضع أصابعه فوق قلبه خشية أن يسمع العالم خفقانه. القلق في قصصه ليس قلقًا مباشرًا، بل قلق ينمو من الداخل، من تلك الأسئلة التي لا تُطرح، لكنها تتحرك على أطراف الكلمات.
وأعترف أن في لغته القصصية ما يشبه الشعر، لا بشكله الظاهري، بل بروحه. الجملة عنده ليست مجرّد وسيلة للمعنى، بل كائن حي، يتنفس، ويتقدّم بحذر، كأنها تخشى أن تطأ أرضًا مملوءة بالألغام. أحيانًا، أقرأ له سطرًا واحدًا، فأشعر أنّ وراءه ليلًا كاملًا من التفكير، وكأن اللغة تخاف أن تكون صريحة أكثر مما ينبغي. لقد علّمني شوقي، من خلال قصصه، أنّ الشعر ليس وزنًا وقافية، بل نظرة، وأن القصة القصيرة يمكن أن تحمل في ضيق مساحتها ما لا تحمله الروايات الطويلة.ما يفعله في قصصه يشبه ما يفعله العرّاف حين يضع يده فوق كتفك ويخبرك بشيء تعرفه مسبقًا لكنك تخشاه: يعريك بلا خشونة، ويفضح عتمتك دون أن يرفع صوته. لهذا، حين أعود إلى قصصه، أشعر أنّني أعود إلى نفسي، إلى تلك الطبقات التي أحاول نسيانها. كان يكتب عن الإنسان وهو في أضعف حالاته، لحظة انكساره، لحظة تردده، لحظة إدراكه أنّ الحياة لا تنتظره كي يستعدّ لها. ولأن شوقي ابن بيئته الأولى، فإن أبطاله غالبًا ما يخرجون من الأزقة ذاتها، من الشوارع التي رأيناها معًا، من وجوه الفقراء الذين عرفنا قسوتهم ولطفهم في آن.
لا يخلو عالمه القصصي من الحزن، لكنه ليس حزنًا يائسًا؛ إنه حزن الإنسان الذي يعرف أن الألم جزء من تكوينه، وأن النجاة ليست وعدًا، بل محاولة دائمة. وربما لهذا تحديدًا تبدو قصصه صادقة، لأنها لا تعد القارئ بشيء، ولا تدّعي أنها تمتلك جوابًا لأي سؤال، بل تمنحك أسئلتك أنت، وتجعلك تراها من جديد. القلق الذي يزرعه في نصوصه لا يهدف إلى إرباكك، بل إلى أن يستدرجك نحو تلك المساحة التي تخاف مواجهتها.لقد وجد شوقي في القصة القصيرة المكان الذي يصغي فيه إلى نفسه أكثر من أي مكان آخر. وحين يكتبها، أشعر أنه يكتب بخيط رفيع بين الصمت والصراخ. وهو خيط لا يستطيع السير عليه إلا من يعرف هشاشة الروح، ومن جرب أن يحمل العالم في جملة واحدة.، يمكن القول إن القصة القصيرة كانت لشوقي ليس مجرد نوع أدبي، بل كانت حقلًا لاكتشاف ذاته، ومرآة لرؤية العالم كما هو: ناقصًا، مضطربًا، جميلًا رغم كل شيء. وفيها، أكثر من أي فن آخر، استطاع أن يلتقط ذلك الوميض الخفي الذي يسبق السقوط، وذلك الارتجاف الصغير الذي يسبق الكلام. هي عوالم اكتشاف القلق… لكنها أيضًا عوالم اكتشاف الإنسان.ولأن شوقي لم يكن يومًا كاتبًا يبحث عن البهرجة، فإن قصصه تنشأ من تلك المناطق التي يتجنبها معظم الكتّاب: المناطق التي لا بطل فيها، ولا معجزة، ولا ضوء يلمع في آخر النفق. كان يصرّ دائمًا على أن الحياة الحقيقية لا تشبه النهايات السعيدة، وأن القصة القصيرة، تحديدًا، هي الفن الذي يسمح لك بأن ترى الأشياء قبل أن تتهذّب، قبل أن تُصاغ في قالب جميل. لذلك، تجد في قصصه رائحة الأزقة، صدى الخطى المرعوبة، نظرة المرأة التي تخشى الفضائح، وارتباك الرجل الذي يعرف أنه ضحية يومه لا مؤلفه.القصة عند شوقي ليست استعراضًا، بل اعتراف. اعتراف على الورق بما لم يجرؤ أن يقوله علنًا. وربما لهذا السبب تبدو بعض نصوصه وكأنها كُتبت في لحظة واحدة، دون مراجعة، كأنها صرخة خرجت فجأة، لكنها صرخة يعرف صاحبها جيدًا ما الذي يريد أن يبوح به.
كان يحدثني أحيانًا عن شخصياته كما لو أنها تزوره، تجلس إلى جانبه، وتطلب منه أن يمنحها فرصة لأن تُسمع. قال لي مرة: “أنا لا أخلق الشخصيات… أنا فقط أفتح الباب لها.” وكانت تلك الجملة كافية لأفهم أن القلق الذي يكتبه ليس قلقه وحده، بل قلق أولئك الذين نلتقي بهم يوميًا دون أن نسمع صوتهم الداخلي.
ولأن القصة القصيرة تحتاج إلى اقتصاد في اللغة، كان شوقي يختار كلماته كما يختار الجراح أدواته: بحذر، وبمعرفة أن حركة صغيرة قد تغيّر المصير كله. جملته قصيرة، لكنها مشحونة بطاقة كامنة، مثل وتر تُمسّه الأصابع مرة فيرتجف مرتين. وكان يؤمن أن الإيحاء أهم من الشرح، وأن المساحة البيضاء حول النص ليست فراغًا، بل جزء من الحكاية. لذلك، تجد نفسك، بعد القراءة، تكمل القصة بنفسك، كأنك شريك في كتابتها، لا مجرد متلقٍّ لها.ما يعجبني في قصص شوقي أكثر من أي شيء آخر هو تلك القدرة على الإمساك باللحظات الهاربة: لحظة تردد، لحظة ندم، لحظة غضب مكتوم تحت الجلد. هذه اللحظات الصغيرة، التي لا يراها الكثيرون، تتحول في يده إلى مشاهد كاملة. وأحيانًا، أستعيد قصة من قصصه كما لو كانت صورة فوتوغرافية: رجل يقف عند زاوية شارع، لا يفعل شيئًا سوى النظر إلى شيء لا نراه نحن. لكن ما يهم هو ما في داخله، ذلك العالم المضطرب الذي يحمله في صدره. وهذا، في رأيي، هو السحر الحقيقي في كتابته: القدرة على تحويل الداخل إلى مشهد خارجي، دون أن يفقده عمقه أو غموضه.
وبين كل قصة وأخرى، يظل القلق هو الخيط الذي يجمعها، لكنّه ليس قلقًا عدميًا أو بلا جدوى، بل قلق الإنسان الذي يعرف أن الأسئلة أهم من الإجابات. لهذا، تبدو قصصه أحيانًا قريبـة من صلاة بلا طقوس؛ دعاء خافت يخرج من فم شخصية لا تعرف لمن تتوجه به، لكنها تقوله لأنها لا تجد مفرًا من قوله. ولعل أجمل ما في قصص شوقي أنه يمنح القارئ ذلك الإحساس النادر بأن هناك شيئًا مهمًا يحدث في الأعماق، شيئًا يوشك أن يتغير، حتى لو لم يتغير العالم نفسه.
ولكي نفهم عالمه القصصي حقًا، علينا أن ندرك أنه لم يتعامل مع القصة بوصفها “فنًا صغيرًا” كما يصفها البعض، بل بوصفها مختبرًا لصوت الإنسان الداخلي. ولأن شوقي عاش حيوات كثيرة داخل نصوصه، وحمل ذاكرة مدينة بأكملها فوق صفحة واحدة، فقد صار القلق عنده ليس حالة عابرة، بل مفتاحًا للدخول إلى جوهر الإنسان. وهذا ما يجعل قصصه تدوم. فهي لا تقوم على حدث صاخب، ولا على حبكة معقّدة، بل على تلك الحقيقة البسيطة التي يخاف الجميع من مواجهتها: أننا نعيش حياتنا ونحن نحمل أكثر مما نقدر على حمله، وأن الصوت الذي يهمس في داخلنا لا يتوقف، مهما حاولنا إسكاته.هكذا، حين أنهـي قراءة قصة من قصصه، أشعر دائمًا بأنني خرجت من غرفة ضيقة إلى فضاء مفتوح، لكن الهواء فيه أثقل قليلًا، لأنني حملت معي أسئلة جديدة. وربما هذا هو ما أراد شوقي الوصول إليه منذ البداية: ألا يطمئن القارئ، بل أن يُنصت. وأن ينصت جيدًا.ولأن السرد عند شوقي ليس حكاية تُلتقط من الهواء، بل حفرٌ طويل في أرض الذاكرة، فإن كل نص يبدو كأنه يستعيد شيئًا مفقودًا، شيئًا ضاع بين دفاتر الطفولة وصيحات الشوارع الأولى. كان دائمًا يقول لي إن الحكاية ليست ما يرويه الكاتب، بل ما يسكنه. ولهذا السبب بالذات، تبدو رواياته كأنها محاولات جريئة للتصالح مع خوف قديم، أو لمواجهة صمت لم يجد مكانًا يُقال فيه. القلق في نصوصه ليس قلق السرد، بل قلق الكاتب نفسه، وهو يفتّش عن طريق وسط غابة من الأسئلة.لقد كانت تجربة شوقي السردية، منذ بداياتها، رحلة نحو الداخل، نحو تلك المناطق التي لا يجرؤ الكثيرون على الاقتراب منها. يكتب بوعي من يعرف أن أي جملة قد تفتح بابًا لا عودة منه، وأن السرد الحقيقي ليس الذي يقدّم أحداثًا، بل الذي يقدّم روحًا. ولأن روحه مثقلة بالأمكنة والوجوه، تجد السرد عنده محملًا بثقل إنساني لا يُخفى. شخصياته لا تمشي على الأرض فقط، بل تمشي فوق ذاكرته، وتترك بصماتها على قلبه قبل الورق.وحين يكتب عن المكان، لا يصفه، بل يستحضره. مدينة الثورة مثلًا، لا تظهر عنده كخريطة أو كخط هندسي، بل كنبض، كرائحة تعبق في النص، كصوت بعيد يواصل دورانه في الخلفية حتى آخر صفحة. إنها ليست مكانًا، بل قدرًا. قدر يلاحق الشخصيات ويؤثر في مصائرها، كما لو أن الجدران نفسها تمتلك ذاكرة وحزنًا قديمًا. وحين ينتقل إلى أمكنة أخرى، يبقى ذلك الظل العميق مصاحبًا له، لأن الكاتب لا يترك مدينته الأولى، مهما ابتعدت المسافات.السرد في عالم شوقي يشبه السير فوق سطح يتغير كل لحظة. ليس هناك أرض ثابتة، وليس هناك يقين يطمئِن القارئ. كل يقين يُفتح فيه على سؤال، وكل إجابة تنتهي بباب ثالث. وهذا ما يجعل نصوصه أقرب إلى حوار طويل بين الكاتب وذاته، بين الإنسان وما يهجره، بين الخوف وما يجرؤ على مواجهته. وربما لهذا تحديدًا يشعر القارئ، حين يغوص في رواياته، أنه دخل متاهة لا يريد الخروج منها، لأن المتاهة هنا ليست ضياعًا، بل اكتشافًا.
وأعرف أن البعض يقرأ نصوص شوقي بحثًا عن الحكاية، لكنه يفوّت جوهر تجربته. الجوهر ليس في “ماذا حدث؟” بل في “كيف يحدث العالم داخل الإنسان؟” ولهذا يتداخل السرد عنده مع الذاكرة، مع الأوهام، مع الكوابيس، ومع الأحلام التي لا تكتمل. نصوصه ليست خطية، لأنها لا تعترف بزمن واحد. الزمن عنده يتشظى، يتراجع، يقفز إلى الأمام، ثم يعود إلى نقطة لم ينتبه القارئ لوجودها أصلًا. وكأن الكاتب يريد أن يقول إن الإنسان ليس زمنًا، بل تراكب أزمنة، وإن الحقيقة ليست لحظة، بل تراكم لحظات.ولأن شوقي يمتلك ذلك الحدس الغريب بالظلال، فإن النص لديه كثيرًا ما يبدو كأنه مكتوب في ضوء خافت، ضوء يكشف ولا يفضح، يلمع ولا يصرخ. يخلق أجواءً يتجاور فيها الصمت مع الضجيج الداخلي، وتتشابك فيها أفكار الشخصيات مع ما لم تقله. ولعلّ هذا هو ما يجعل القارئ يعود إلى رواياته أكثر من مرة، لأنه يشعر أن كل قراءة تكشف له طبقة جديدة، وأن المعنى ليس جاهزًا، بل ينتظر من يقترب منه بالشجاعة الكافية.وفي منتصف كل هذا القلق السردي، يظل هناك خيط دافئ يكاد لا يُرى: خيط إنساني، يمرّ بين الجمل كنبض خافت، يجعل نصوصه، مهما كانت قاسية، تحمل قدرًا من الحنان. حنان الكاتب الذي يعرف هشاشة الإنسان، ويحاول، ولو في جملة واحدة، أن يخفف عنه.هكذا يكتب شوقي: لا يروي العالم، بل يكتشفه. لا يصف الحياة، بل يعرّيها. لا يتباهى بالسرد، بل يستخدمه كأداة ليواجه بها نفسه. لذلك، لا تكتمل قراءة نصه إلا حين يدرك القارئ أنه هو نفسه دخل في عملية اكتشاف، وأن هذا القلق الذي يظنه قلق النص، هو في الحقيقة قلقه هو.السرد عند شوقي كريم حسن ليس أسلوبًا، ولا تقنية، ولا مدرسة. إنه حالة. حالة يقف فيها الكاتب والإنسان وجهًا لوجه، بلا أقنعة، ويقول: هذا أنا… وهذه حياتي… وهذه الحكاية التي لا تزال تبحث عني.!!