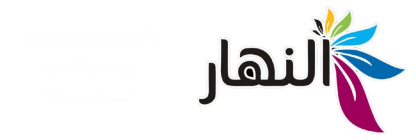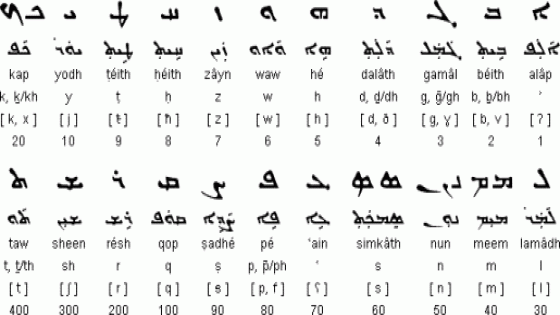علّمني الحسين أن الله تعالى لا يتجلى فقط في القَدَر الجميل لكن ايضا في الجُرح الجمي الجرح الذي لا يُنكر ولا يُجمَّل
صار الحسين حيًا من جديد لا يحتاج إلى نص بل إلى قلب وها أنا أعترف: لقد عرفت الحسين من جديد لا في الكتب بل من قلب أمي
أمي دون أن تقول شيئًا، أعادتني إلى الحسين أعادت زرعه في داخلي كجوهر مقاومة وكتمثيل للصبر وكصوت للمظلوم في كل الأزمنة
أنقذني الحسين من الإلحاد لا لأنه حمل لي برهانًا فلسفيًا على وجود الله ولا لأنه وعدني بجنة بل لأنه أعاد ترتيب علاقتي بالمطلق
رياض العلي
ليست التحولات الوجودية الكبرى ابنة الضوء، ولا تولد في لحظات الصفاء الذهني كما نتخيل. أحيانًا، تتسلل تلك التحولات بهدوء مريب، كأنها تشق طريقها في العتمة، لا ضوء فيها سوى بصيص داخلي خافت لا تراه الأعين. إنها لا تأتي حين نتهيأ لها، ولا حين نظن أننا بلغنا مرحلة “الاستعداد”، انها تولد غالبًا في الهشاشة القصوى، حين تتكسر يقينياتنا بصمت، وتتآكل أعمدة المعنى من داخلنا، دون أن يشعر من حولنا بشيء.
في تلك اللحظات ينهار الإيمان كعقيدة وكمعنى شامل للحياة. تتوقف الكلمات عن أداء وظيفتها، وتتفتت الصلاة إلى مجرد إيماءات رتيبة لا تسند الروح. يصبح الحديث عن الله تكرارًا باهتًا لعبارات حفظناها دون أن نعيشها، ويغدو الضمير صوتًا واهنًا، متعبًا من كثرة ما صرخ دون مجيب.
في قاع تلك التجربة، يبدأ شيء جديد بالتكوّن، لا يُرى من الخارج، لكنه يحدث على مستوى عميق لا يمكن الإمساك به بالكلمات: السؤال. سؤال وجودي ينهش الداخل: من أنا؟ لماذا أنا هنا؟ وهل ما أفعله، وما أؤمن به، له أي معنى حقًا؟ هل الله حاضر في هذه الفوضى أم أن غيابه هو الحقيقة الوحيدة؟
إنها لحظة لا يعود فيها الإنسان محايدًا تجاه إيمانه، انما يصير على تماسّ حادّ معه، كتلامس الجرح بالملح.
رحلتي لم تكن عودةً إلى الدين، هي تفكيك مؤلم لكل ما كنت أظنه “ثابتًا”. لم يكن طريقي إلى الإيمان مدفوعا بالحنين إلى المألوف، ولا بالرغبة في الاطمئنان، لكن بانهيار كل شيء جعلني يومًا أشعر أنني أفهم العالم. كنت أقف في الظلام، لا لأهرب من الله، لكن لأبحث عنه في الأماكن التي لم يُعلمني أحد أن أنظر إليها. لم أبحث عن إجابة سهلة، ولا عن لحظة خلاص. كنت فقط أحاول أن أصمد دون أن أنهار تمامًا.
العتمة التي مررت بها هي امتلاءً خانقًا بأسئلة متراكمة. كنت أجرّ نفسي من يوم إلى آخر، أعيش كأنني أراقب نفسي من بعيد، أرى انطفاء الإيمان القديم، وأشعر بكل مرحلة من مراحل موته. ومع كل ذلك، لم أكن أكره الإيمان، لكنني كرهت الصورة المشوّهة لله التي صاغها لي الخطاب الديني، كرهت فكرة الإله الذي يتفرج على الخراب، ولا يُحرّك ساكنًا.
وفي تلك الهوة، لم أجد إجابة، لكنني وجدت السؤال الحقيقي. وهذا وحده، آنذاك، كان كافيًا لأن أبقى واقفًا، وإن بارتجاف.
- الهاوية: حين تفقد الأسئلة براءتها
لم تكن تجربتي هذه حدثًا فجائيًا، ولا موقفًا فلسفيًا اختبرته على سبيل الفضول أو التمرّد المؤقت، ولم تكن حتى نتيجة قراءة لكتب الماديين أو مفكرين مارقين عن الدين. لقد كانت تجربة تراكمية، تَشكّلَت في الخفاء، نَمَتْ في المساحات التي تجاهلها الجميع: بين الصمت الطويل الذي يحيط بالأسئلة، وفي النظرات التائهة في وجوه المساكين الذين فقدوا كل شيء دون أن يجرؤ أحد على أن يقول لهم: “الله معكم”.
ربما سيبدو الأمر غريبًا، بل صادمًا للبعض، لكن عليّ أن أقولها بصراحة: تلك المواقف الحاسمة التي اتخذتها لاحقًا، تلك اليقظة القيمية والنقدية التي تشكّلت داخلي كانت ثمرة سلسلة طويلة من المواجهات الصامتة مع نصوص قرأتها، وفكرت فيها، ثم اصطدمت بها بقسوة.
بدأ الأمر حين شرعتُ في قراءة عدد من كتب التفسير والحديث التي طالما قُدّمت لنا على أنها ذخائر لا تُمس، نصوص مقدسة بالمعنى غير القابل للشك. قرأت تفسير الطبري، والكشاف للزمخشري، وصحيح البخاري وصحيح مسلم، وغيرها من الكتب التي قيل لنا إنها تمثل ذروة الفهم الديني، وخلاصة العقول المؤتمنة على الدين. كنت أبحث عن المعنى، عن إجابات عميقة لأسئلة باتت تؤرقني، عن ذلك الوضوح الداخلي الذي ينتج عن الفهم، لا التلقين.
لكن ما وجدته كان مختلفًا تمامًا عن توقعاتي. كانت تلك الكتب، رغم أهميتها التاريخية والموسوعية، تقدم في كثير من المواضع إجابات ساذجة، سطحية، لا ترقى لمستوى الأسئلة التي كان العقل يطرحها. شعرت أن النصوص تحاور زمنًا آخر، عقلًا آخر، وأنها كتبت لجمهور كان يسلّم. جمهور يبحث عن الطمأنينة في التسليم. ومن هنا بدأ الشرخ: كيف يُمكن لأسئلة وجودية عميقة، تتعلق بالعدل، والمصير، والإله، والمعنى، أن تُجاب بتفسيرات أقرب إلى التبرير منها إلى الفهم؟
الأسوأ من ذلك، أنني اكتشفت ــ بشكل تدريجي ومؤلم ــ أن بعض الأحاديث المنسوبة للنبي لم تكن إلا اختراعات بشرية صيغت في ظروف سياسية واجتماعية معينة، ثم صُدّرت إلينا باعتبارها من صميم النبوة. لم يكن الأمر مجرد أخطاء فردية، بل بدا كمنظومة من الإسناد والتوثيق والتقديس تمكّنت من تحويل الرواية إلى عقيدة، وتحويل الرواة إلى أوصياء على الضمير الجمعي. كان من الصعب أن أصدّق أن كثيرًا من هذه “الأحاديث” لا تخدم إلا السلطة، أو التقاليد الذكورية، أو التقسيم الطبقي، أو حتى نزوات الرواة أنفسهم.
شعرت، وأنا أغوص أعمق في تلك الكتب، أن ما سُمّي بـ”العلم” الديني هو أحيانًا علم السلطة، وأن الكثير مما كُتب لم يكن بحثًا عن الحقيقة، انما هو بناءً لمؤسسة معرفية مغلقة تحرس نفسها بنفسها، وتمنح ذاتها شرعية داخلية لا تقبل السؤال من خارجها. بل إن بعض التفسيرات كانت تستخفّ بالعقل إلى حدّ مخجل، فتُسقِط المجاز على الواقع، وتحوّل الرمزي إلى حرفي، ثم تطلب منك أن تؤمن، أن تسلّم، وأن تُكفّر كل من يجرؤ على فتح نافذة للشك.
وهكذا، كانت قراءتي لتلك الكتب معركة داخلية. معركة بين ما وُرثته كحقائق نهائية، وما بدأ يتكشّف لي كنظام من التأويلات الموجّهة. معركة بين العقل الذي يستفيق، والنص الذي يُقال له: “لا تسأل.” ومن وسط هذا الصراع، بدأت أشكّل موقفي ضد اختطاف الدين ،وضد تسييجه بحراس المعرفة المزيّفة.
كان هذا الموقف بالنسبة لي ليس إنكارًا لله بقدر ما كان يأسًا من آله صنعه البشر . لا شيء أكثر إيلامًا من أن تبحث عن الله فلا تجده، أو أن تجده صامتًا، مشلول الإرادة، أمام كل هذا الكم من البشاعة التي يتقيّؤها العالم كل يوم. كنت أرى صور الأطفال الجائعين ، الأمهات الباكيات، المدن التي تحوّلت إلى سجون ومقابر، ولا أسمع سوى الخطب الدينية الفارغة، والآيات تُردد كأنها حجاب ضد الرؤية لا مفتاح للفهم.
لم تكن الأسئلة التي تملكتني أسئلة فلسفية باردة؛ لم تكن مجرّد حوارات داخلية حول وجود الخالق أو طبيعة الشر، كانت أسئلة مغموسة في الدم والرماد، تنبت من جراح الناس وتتمدد في صمتهم المقهور. كنت أرى الظالم ينجو ببطشه، والمظلوم يُدفن بصمته، وأتساءل: ما وظيفة الإله إذًا؟ لماذا يبدو وكأنه يتآمر مع المنتصر دائمًا؟ لماذا لا يتدخّل، أو على الأقل، لماذا لا يعتذر عن غيابه الطويل؟
كان كل ما حولي يتآمر على فكرة الخير. الكلمات التي طالما اعتبرناها من “المُسلّمات” بدأت تتهشّم واحدة تلو الأخرى. الحق؟ من يملكه؟ العدل؟ لمن يُمنح؟ الرحمة؟ لمن تُمنع؟ كانت المفردات الكبرى التي شكّلت قاموس طفولتي تنهار أمامي، لا لأنني رفضتها، لكن لأنها أصبحت عاجزة عن تفسير الواقع الوحشي الذي نعيشه.
في تلك اللحظة، لم يعد الإلحاد خيارًا أو قرارًا واعيًا. كان النتيجة الطبيعية لمسار طويل من الخذلان الروحي. وجدت نفسي هناك، في العراء، بلا قشرة دينية تحميني، بلا يقين، بلا دفء المعتقد. كنت مكشوفًا بالكامل، هشًا كقشرة جرح طري، أقف أمام كون لا يكترث، صامت، مظلم، يتساوى فيه القاتل والضحية، وتُغتال فيه المعاني كل لحظة دون عقاب.
الظلال الذي عشته كان حزنًا على غياب الله. لم أصرخ نافيًا وجوده، لكني بكيت بصمت لأنني لم أعد قادرًا على تصديق من يدّعون التحدث على لسانه . كنت أريد أن أراه، أن أشعر به، أن أسمعه يقول لي: “أنا هنا”. لكن الصمت كان طاغيًا، والقسوة كانت تملأ كل فراغ حاولت أن أملأه بالصلاة.
وما زاد من قسوة التجربة، أنني كلما التفتّ إلى من يُفترض أنهم ممثلو الإله على الأرض، وجدتهم إما فاسدين، أو غارقين في وهم العظمة، أو مشغولين بإثبات صحة طقوسهم بدل الانتصار للمظلومين. تحوّلت المنابر إلى مسارح للخطابة، والدين إلى شعارات مكررة، أما الله فبقي معلقًا بين الغياب والاتهام.
في تلك الهاوية، فقدت الأسئلة براءتها. لم تعد تبحث عن معرفة، أصبحت صيحات احتجاج أخلاقي على عالم غير عادل، وعلى إله لا يُحسن التدخل.
كنت أبحث عن عدل، عن رحمة، عن معنى. وعندما لم أجد تلك المعاني في الله كما عُرِّف لي، توقفت عن تصديقه. ولم تكن هذه خيانة، انما كانت، في جوهرها، صرخة استغاثة لم تجد من يجيب.
- اللقاء بكربلاء: حين يصبح التاريخ حيًّا
في ذروة الانهيار، حيث يصبح العقل حائرًا والقلب مكسورًا، لم أكن أبحث عن إجابة تشفي، ولا عن معجزة تُبدّد ظلام الشك. كل ما أردته هو أن أجد خيطًا رفيعًا يشدّني إلى الحياة، شيئًا يشبه الأمل يمنعني من السقوط في فراغ بلا قاع. كنت أقرأ كثيرًا لأن المعرفة في لحظات الألم تصير أحيانًا شكلاً من أشكال التنفس.
وبين صفحات الفلسفة الوجودية، وصور الضحايا في الحروب الحديثة، وبين ضجيج مدونات تحكي عن الخراب البشري، وقع في يدي في تسعينيات القرن الماضي كتاب عن مذبحة كربلاء . لم أكن أتوقع شيئًا، كنت أظنها مجرد قصة قديمة، محفوظة على ألسنة الخطباء، مشبعة بالمبالغة، خالية من الجدوى، قصة أعرفها منذ طفولتي كأنها طقس من طقوس العادة. لكن شيئًا ما كان مختلفًا هذه المرة، شيءٌ جعل التاريخ يتنفس، ويتحول إلى نبض حيّ.
كان كتاب الملحمة الحسينية لمرتضى مطهري أول كتاب قرأته عن الحسين خارج المنابر، خارج لغة الوعظ، خارج الصراخ الذي ألفناه في المجالس. كان نافذة، وكنتُ أنا المتعب من كل شيء، أقف عند حافتها متأملًا ما لا يُقال عادة. حصلت على هذا الكتاب مغلفًا بورقة قديمة ممزقة من مجلة ألف باء، لا تشير إلى شيء، لا عنوان، لا غلاف، فقط أوراق مضمومة بخيط مهلهل، لكنها كانت تحمل سرًا غيّرني.
الذي أعطاني الكتاب لم يكن شخصًا عاديًا، كان ابن عمتي، حسنين. المختلف منذ صغره، الصامت أكثر من اللازم، يقرأ كثيرًا ولا يتحدث كثيرًا. لم يكن يحب الشعارات، لكنه كان يحمل داخله نارًا هادئة لا تنطفئ. حين سلّمني الكتاب قال لي فقط: “اقرأه، بس لا تعيره لأحد.” وكأن الكتاب سلاح، وكأن القراءة فعل من أفعال التمرّد.
قرأت الملحمة الحسينية بتوتر وشغف، وكأنني أتعلم الحسين من جديد. كان مطهري يقدم الحسين بوصفه سؤالًا مفتوحًا على المأساة، على الوعي، على الثورة، على مسؤوليتنا نحن، نحن الذين نعيش في زمن يعيد إنتاج كربلاء كل يوم بشكل مختلف. كانت كلمات الكتاب تتغلغل في داخلي كأنها تشق طريقًا نحو جذور مهملة في الذاكرة والضمير.
لكن ما لم أفهمه حينها، أو ما تجاهلته ربما، هو أن هذا الكتاب كان ممنوعًا. وأن امتلاكه، في بعض الأمكنة وبعض اللحظات، يكفي لاتهامك بأنك خارج على الجماعة، أنك لست في الصندوق، أنك تحمل في قلبك نية مشبوهة. وحسنين، الذي لم يفعل سوى أن وجد طريقه إلى الحسين على طريقته، أُعدم لاحقًا. أُعدم لا لأنه فجّر شيئًا أو خرب شيئًا، لكن لأنه قرأ، لأنه فكر، لأنه قال لا.
ومن سخريات القدر أن والد حسنين، زوج عمتي، هو يعقوب أبو علي الخياط، الذي كان واحدًا من أعرق الماركسيين في البصرة، ويمتلك واحدة من أكبر المكتبات فيها، وهو من أمدّني بالعديد من الكتب الناقدة للدين.
اعدم حسنين في مديرية أمن البصرة، لكن الكتاب بقي. بقي وفيًا لذاك الصوت الذي يُقتل كلما أراد أن يقول الحقيقة. ومنذ تلك اللحظة، صار كتاب الملحمة الحسينية ليس مجرد أثرًا مطبوعًا، صار شاهدًا: على من رحلوا لأنهم فكروا، وعلى من بقوا ليكتبوا، ويشهدوا، ويواصلوا الدرب.
ما قرأته لم يكن مجرد إعادة سردٍ لمعركة. لقد بدأت التفاصيل تُخاطبني بلغة لا تشبه اللغة. خروج الحسين من المدينة لم يعد فعلاً تاريخيًا محفوفًا بالخطر، صار إعلان تمرد على كل منطق الاستسلام. حوار الحسين مع الحر الرياحي لم يعد موقفًا عابرًا، صار تجسيدًا مؤلمًا لصراع الإنسان مع ضميره، ذلك الصراع الذي نعيشه كل يوم حين نختار بين الطاعة العمياء والحق الثقيل.
نظراته الأخيرة نحو ولده علي الأكبر، لم تكن فقط مشهد وداع، كانت تمزقًا لروح الأب في أقسى اختبار للحب والتضحية. والسيدة زينب وهي واقفة أمام الطاغية، لم تعد مجرد امرأة تُكمل الرواية، أصبحت رمزًا لصوت لا ينكسر، للكرامة حين تُجلَد، وللثبات حين يصير البكاء ترفًا لا وقت له.
ثم جاء المشهد الذي كسرني تمامًا: جسد بلا رأس، محمول على رمح، والنخيل صامت كأنه شاهد خجول. لم أبكِ لأني مؤمن، ولم أرتجف لأنني تبت، لكن لأن الألم في تلك القصة كان إنسانيًا بشكلٍ لا يُحتمل، عاريًا من الزينة الدينية، خالصًا كما هو. شعرت كأن الحسين لم يُقتل قبل أربعة عشر قرنًا، كأنه يُقتل في هذه اللحظة، في كل مكان تُذبح فيه الكرامة، ويُجهز فيه الطغيان على الصدق.
في تلك اللحظة، رأيت الحسين كبوصلة أخلاقية. فهمت أنه لم يحمل السيف طمعًا في العرش،لكن رفضًا للخنوع. أنه لم يخرج ليقاتل، انما ليقول: “لا” بأعلى صوته، حين اختنق الجميع بالصمت. كان الحسين يقاتل من أجل المعنى، لا النصر؛ من أجل أن تظل كلمة “الحق” قابلة للنطق، ولو من تحت الرماد.
شيئًا فشيئًا، بدأ التحول الداخلي. لم يكن تحولًا دينيًا بالمعنى الضيق، كان ثورة في ترتيب الأسئلة. لم أعد أبحث عن الله كسلطة تضمن لي الخلاص، لكن كمعنى ينبت من الألم، كشعور يدعوني لمقاومة الظلم. اكتشفت أن مقاومة الشر ليست مشروطة بامتلاك إجابات نهائية، لكنها تبدأ حين نقرر ألّا نصمت.
كأن الحسين، في تلك اللحظة، كان يقول لي من داخل جراحه:
“لا بأس إن لم تفهم كل شيء. لا بأس إن ظلّت أسئلتك معلّقة. لكن إيّاك أن تصمت حين يُذبح المظلوم. لا تنتظر الوحي لتصرخ. الصرخة هي الوحي.”
حينها فقط، بدأت أشعر أن ثمة جذوة نور تشتعل في داخلي. صغيرة، خافتة، لكنها حقيقية. بدأت أرى أن الإيمان يولد دائمًا من الوجع العميق، من المرارة التي تصهر القلب، فتجعله أكثر قدرة على رؤية النور حين يجيء.
- الحسين: المعنى الذي لا يموت
حين أمسكت بسيرة الحسين، كانت يدي تمسك بجذوة نار، شيء أشبه بالنبض الحيّ، كنت أستمع لصوت يأتي من أعماق قلبي المبعثر. لم تكن تلك اللحظة عودة تقليدية إلى الإيمان، ولم تكن رجوعًا إلى المساجد، أو استسلامًا لوراثة دينية أضعنا فيها التفكر لحساب الطقوس. كانت شيئًا آخر، أعمق وأصعب وأصدق: كانت بداية إعادة بناء الذات من تحت الركام، لا على أساس الخوف من الجحيم أو الطمع في النعيم، لكن على أساس المعنى… ذلك الذي لا تمحوه الخسارات.
لقد أدركت مع الحسين أن الإيمان الحقيقي يُولد من القدرة على الوقوف وسط الغموض بشجاعة، من رفض الشر حتى حين يبدو كأنه قدَر، من اختيار الصدق حتى حين يكون الثمن الرأس. لم يعد سؤالي: “أين الله حين يُظلم الأبرياء؟”، لكن صار: “أين أنا؟ ماذا أفعل أنا أمام هذا الظلم؟”. وهنا، في هذا التحول الجوهري، بدأت ملامح الإيمان تتخلق من جديد كحريّة داخلية، كمسؤولية ذاتيّة أمام الجراح التي يئنّ بها هذا العالم.
لم أعد أرى الله سبحانه سجينًا في خطاب العُلماء أو رهينة عند الطقوس، صار الله تعالى موقفًا أخلاقيًا، يسكن في ذاك الذي يقول “لا” للظلم رغم ضعفه، في تلك الدمعة التي تنزل من عين أم ثكلى ولا تجد من يجففها، في ذاك الجسد الذي يُقتل وهو يعلم أن موته سيكون الحياة للكرامة في زمن طويل. صار الله حاضرًا في الساحات لا في الأبراج، في الجراح لا في الأجوبة، في المقاومة لا في الصمت ، في ذلك الوقت، وجدت نفسي أمام أصعب قرار اتخذته في حياتي. كنت جنديًا في الفوج الثالث، التابع للفرقة 11، حين وردنا أمر مباشر من آمر الفوج: قصف قرية “العريثم” لأن أهلها أحيوا ليلة العاشر من المحرم، ليلة الحسين، على طريقتهم الخاصة. لم يكن الأمر مجرد مهمة عسكرية عابرة، كان امتحانًا صارخًا للضمير، وكأن على كل واحدٍ منا أن يختار: أن يكون قاتلًا بأمر، أم إنسانًا بعصيان.
جلست تلك الليلة في ظلمة المعسكر، أتأمل الصمت المشحون الذي خيّم على وجوه الجنود. كانت الأوامر واضحة، والتهديد ضمنيًا لا يحتاج إلى تفسير. لكن شيئًا ما في داخلي بدأ يتمرّد. ليس فقط لأنني كنت أعرف القرية، لكن لأنني شعرت، للمرة الأولى، أن البندقية التي أحملها لم تعد موجّهة ضد عدو في الجبهة، لكن ضدّ ناس يشبهون أمي وأبي، ضدّ أطفال قد يكونون نائمين الآن تحت سقف طيني، ضدّ أناس قرروا أن يتذكّروا مظلومًا قُتل قبل قرون، فاعتُبروا متمرّدين.
في خضمّ هذا التوتر، اجتمعت سرًّا مع ملازم ماجد، رجلٌ كان هادئًا دائمًا، صامتًا على غير عادة الضباط، لكنه حين تكلّم تلك الليلة قال عبارة واحدة فقط: “لا أريد أن أكون شاهد زور على دمي.” وفهمت ما يعنيه. ثم انضمّ إلينا العريف ماجد عبعوب، وهو شاب من البصرة، بعينين دائمتي الحيرة، قال وهو يطأطئ رأسه: “هاي قرانا… إذا قصفناهم، منو يبقى؟”
كنا ثلاثة، لكن شعورنا بالذنب كان يكفي لجيش كامل. وتحت جنح الظلام، اتخذنا القرار. لم يكن قرارًا بطوليًا كما يُكتب في الروايات، كان فعل نجاة أخلاقي. هربنا. تسللنا من بين الخيام والرقابة والعيون التي تتجسس، ومشينا ساعات في الظلمة نرتجف من الخوف، لا من الموت بل من الخيانة… أن نخون أرواحنا.
لم نكن نعرف إلى أين نذهب. لكننا كنا نعرف تمامًا مما نهرب. نهرب من أن نكون أداة في محو آخر، من أن نمحو قرية لأنها فقط تذكّرت كربلاء، من أن يُقال عنّا لاحقًا أننا نفّذنا أوامر، ودفنّا ضمائرنا في حفرةٍ مشتركةٍ مع الأطفال الذين لم يولدوا بعد.
بعد ذلك الهروب الذي غيّر مجرى حياتي، لم أعد كما كنت. لم أعد قادراً على مواجهة العالم بالوجه القديم نفسه، ولا على ممارسة الحياة بنفس اللغة. شعرت أنني بحاجة إلى الاختفاء، لا هربًا من الناس، لكن بحثًا عني. فعزلت نفسي طواعية في أقصى غرفة من غرف بيتنا القديم، تلك الغرفة التي كانت أشبه بخزانة منسية، لكنها تحوّلت بالنسبة لي إلى معبد داخلي، أو كهف أختبر فيه إعادة تكويني من الصفر.
كانت عزلة قاسية، موحشة، وأحيانًا خانقة. لكنها، رغم ذلك، كانت ضرورية. كنت أشعر أنني أحمل في داخلي صدمة مزدوجة: صدمة ما كدت أشارك فيه، وصدمة النجاة منه. ولأنني لم أعد أثق بالكلمات التي يرددها الناس، ولا بالحكايات التي تُسرد على ألسنة الإعلام والسلطة، قررت أن ألجأ إلى الكتب، إلى الصمت، إلى القلم. قرأت كثيرًا، بشكل نهم، وكأنني أريد أن أملأ فجوة عمر بأكمله. وكتبت كثيرًا، ليس فقط لأُفصح، لكن لأبني داخلي من جديد.
في تلك العزلة تشكّل في داخلي ما يمكن أن أسميه لاحقًا “نمط التفكير النقدي”، لكنه في بدايته لم يكن إلا رفضًا داخليًا، صامتًا، لكل ما ورثته من مفاهيم جاهزة ومسلمات تلقنتها قسرًا. بدأت أنظر إلى السلطة بعينٍ مريبة، لا تراها فقط ككيان سياسي، لكن كمنظومة تمارس الهيمنة على المعنى، على الذاكرة، على التاريخ نفسه. أدركت أن السلطة لا تكتب التاريخ لتوثّقه، انما لتبرّر حاضرها وتُشرعن مستقبلها. وأن قراءتها للأحداث نوع من السيطرة الرمزية يُعاد فيه تشكيل الضحية كمجرم، والمجرم كبطل.
أعدتُ قراءة كتب تاريخية كتبها أعوان السلطة، وكنت أضع عليها هوامش صغيرة، أحيانًا غاضبة، وأحيانًا ساخرة، لكنها كانت دائمًا حادة. شعرت أن الكتابة على الهامش مقاومة صامتة، بلغة لا يسمعها أحد سواي، ضد خطابٍ يُراد له أن يكون مطلقًا ومحصنًا من الشك. وكلما عدت إلى تلك الهوامش بعد سنوات، كنت أتعجب من تلك القدرة النقدية التي نضجت في داخلي رغم صغر سني آنذاك. كنت أندهش من تلك الجرأة في التشكيك، من رغبة المعرفة بوصفها شكًّا لا ينتهي.
في تلك الغرفة كنت أمارس بناء الذات من خلال الهدم: هدم ما سلّموه لي باعتباره الحقيقة، وإعادة ترتيب العالم من منظور يخصني، لا تفرضه السلطة، ولا يُملى علي من مؤسساتها.
ثم، في لحظة لم أكن أتوقّعها، رأيت الحسين في وجهٍ لم يخطر لي من قبل… رأيته في أمي.
لم تكن أمي تملك خطابًا فكريًا، ولا قرأت يومًا كتابًا في الفلسفة أو التاريخ، لكنها كانت تحمل في داخلها ذلك الإيمان النقي، العميق، الذي لا يُجادل ولا يُبرّر، لكنه يتجلى في الأفعال، في التفاصيل، في الدعاء الصامت، وفي دمعة تنزل كل محرم دون ضجيج. بعد سنوات من الشك، ومن محاولات إعادة تعريف كل ما ورثته، وجدتني أعود، لا إلى صورة الحسين كما تُقدّمها المنابر، انما إلى حضوره الحي في قلب أمي، حضور متجذّر لا يحتاج إلى وساطة.
أمي، دون أن تقول شيئًا، أعادتني إلى الحسين. أعادت زرعه في داخلي كجوهر مقاومة، وكتمثيل للصبر، وكصوت للمظلوم في كل الأزمنة. رأيت فيه، من خلال حزنها وحرقتها وحنانها، معنى مختلفًا تمامًا: لم يكن الحسين فقط من خرج على الظلم، لكن هو من علّمني كيف أحب الحق حتى لو كنت وحدي، وكيف أظل وفيًا للقيم التي قد يدفع الإنسان حياته ثمنًا لها.
كان في نظرات أمي، في صوتها حين تذكره، نوع من التقديس غير المُصطنع، لا يشبه ما يُقال في الخطب، بل أعمق من ذلك بكثير. كانت تربط الحسين باليومي، بالمأساة المتكررة، بالناس الذين تم سحقهم تحت جحيم الحصار، لا لأنهم حملوا سلاحًا، بل لأنهم قالوا “لا”.
وكأن حب الحسين كان يُزرع فيّ من جديد، لا كما عرفته سابقًا من خلال الروايات الرسمية، لكن كما شعرت به أمي، وكما عاش في داخلها. وللمرة الأولى، أحسست أنني لم أكن أعرف الحسين حقًا. كنت أعرف اسمه، تاريخه، المعركة، الروايات… لكنني لم أعرفه كنبض داخلي حيّ، كما عرفته وهي تدعو باسمه، وتبكيه، وتعلّق على جدار مطبخها راية سوداء صغيرة وتقول لي: “هو المظلوم.”
في أمي، صار الحسين حيًا من جديد لا يحتاج إلى نص، بل إلى قلب، وها أنا أعترف: لقد عرفت الحسين من جديد، لا في الكتب، بل من قلب أمي.
لم يجبني الحسين عن “لماذا يحدث الشر؟” — وهذا السؤال لم يجد له أحد جوابًا منذ أن سقط أول دم بشري في التاريخ — لكنه منحني شيئًا أعظم من الإجابة: منهجًا للوقوف في وجه الشر طريقة للعيش رغم الأسى، وكأن وجودنا الأخلاقي هو أقوى أشكال الحضور الإلهي في العالم.
علّمني الحسين أن الله تعالى لا يتجلى فقط في “القَدَر الجميل”، لكن ايضا في الجُرح الجمي، الجرح الذي لا يُنكر ولا يُجمَّل، الجرح الذي يُحمل بشرف. أن الإيمان معركة داخلية ضد الركون والخذلان، ضد التصالح مع القبح، ضد تبرير البشاعة باسم “الابتلاء”. علّمني أن الصمت حين يُقتل الحق ليس تديّنًا، لكن خيانة لله ذاته، وأن الإنسان لا يكون قريبًا من الله بكثرة سجوده، انما بقوة صموده.
هكذا أنقذني الحسين من الإلحاد لا لأنه حمل لي برهانًا فلسفيًا على وجود الله ولا لأنه وعدني بجنة بل لأنه أعاد ترتيب علاقتي بالمطلق. علّمني أن الله لا يعني الطمأنينة دائمًا، لكن يعني المعنى. أن وجود الله دعوة للمقاومة وسط الألم. أن الإيمان لا يعني أن تكون آمنًا، بل أن تكون صادقًا، ولو كلّفك ذلك كل شيء.
مع الحسين، لم أعد أبحث عن يقين ساذج، لكن عن حقيقة تعاش، لا تُقال. عن موقف، لا فتوى. عن ضوء، لا جدل.
أنقذني الحسين لأنني لم بت أرى الله كمنقذ كصوت داخلي يدعوني إلى أن أكون إنسانًا. وهذا، في زمن مثل زمننا، أعظم معجزة.
- الإيمان الذي يولد من الرفض
لست اليوم كما كنت. لا أزعم امتلاك الحقيقة، ولا أتكئ على يقين جامد يرتاح إليه العقل وينام عليه القلب. لا أردد إجابات محفوظة، ولا أرفع شعارات مطمئنة. ما أملكه الآن ليس أكثر من إيمان هشّ، لكنه حيّ. إيمان لم يولد في المسجد، ولا في كتب التفسير، ايمان ولد في لحظة تمزّق، في انكسار داخلي لم أجد فيه شيئًا أتشبث به… سوى الحسين.
أؤمن اليوم لأنني تعلمت كيف أعيش مع الاسئلة ، أؤمن بإله لا يُختزل في نص، ولا يُحتكر في مذهب، ولا يُسجن في صورة موروثة. إله لا يظهر كمنتصر دائم، لكن كجريح يقف مع المظلومين، مع الحفاة، مع أولئك الذين لا صوت لهم. إله يشبه الحسين: عطشان، محاصر، مطعون، لكنه لا ينحني.
اكتشفت أن الإيمان الأصيل يُولد من التجربة. من صرخة تُطلقها وأنت في العتمة، وتجد أنها ترتدّ إليك نورًا. من رفضك للظلم، حتى حين لا تعرف ما ينتظرك بعده. من شجاعة أن تكون صادقًا، حين يكون الكذب هو الطريق الأسهل.
الحسين صار البوصلة لأنه إنسان كامل في لحظة انكسار. لأنه قال “لا” وهو يعلم أن ثمنها الدم، فدفعه. لأنه لم يساوم، ولم يهادن، ولم يبرر. في عالم يحترف تزييف القيم، بدا الحسين وكأنه الحقيقة الوحيدة التي لم ينجح العالم في تشويهها.
هكذا أنقذني الحسين: لأنه دلّني على الطريق إلى الله. علّمني أن الإيمان ليس راحة، بل مسؤولية. ليس نهاية، هو بداية بحث لا ينتهي. علّمني أن أجمل صور القرب من الله تكون في التمسك بالكرامة وسط العتمة، في رفض الانحناء حين يُطلب منك الصمت، في أن تظل إنسانًا حتى لو لم تُفتح لك أبواب السماء.
أنقذني الحسين، لأنه منحني حقّ أن أبحث، أن أشك، أن أتألم، دون أن أفقد الإيمان. علّمني أن الله لا يُعرّف فقط بالكلمات، لكنه يُعاش في الوقوف، في الدموع، في قول “لا” حين يكون كل شيء من حولك يقول “نعم”.
ولهذا، حين يسألني أحد: كيف خرجت من الإلحاد؟ لا أقول: وجدت الله.
بل أقول: وجدت الحسين… فبدأت أبحث عن الله خالق الجمال والحب.