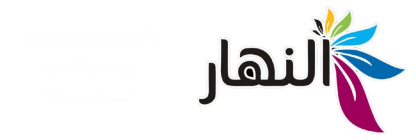استهلال
يعد الشعر العراقي الحديث أحد أبرز أشكال التعبير الأدبي التي نشأت في سياق تحولات اجتماعية وسياسية، مر العراق بها، خلال القرن العشرين، بيد أن هذا الشعر لم يكن مجرد انعكاس باهت الظلال للأحداث بل كان رد فعل حيوي يرصد ديالكتيك الواقع السياسي والاجتماعي، بل وحتى الاقتصادي المتغير؛ هنا حيث سعى الشعراء إلى تطوير أساليب جديدة تعبر عن همومهم الوطنية وتطلعاتهم نحو الحرية والمستقبل في محاولة لعلاج الجسد المثخن، في هذا السياق، تميز الشعر العراقي بالتجديد في الشكل والمضمون، وهو ما جعل شعراء العراق ينطلقون في مجالات فنية متجددة.
لكن هل يبدو الواقع الآن مختلفا عن ذي قبل خاصة بين الشواعر العراقيات، قولًا واحدا: لا… فكما نذكر بمزيد من الشجن المغلف بالدفء الشاعرة لميعة عباس عمارة، التي تعتبر واحدة من الأيقونات في الشعر العراقي الحديث، كانت قصائدها دائمًا تعكس المعاناة والآمال في ظل الظروف الصعبة التي مر العراق بها، فمن خلال قصيدتها الشهيرة “أغنيتي”، -على سبيل المثال- استطاعت لميعة أن تعبر عن الفجيعة والدمار الناتج عن الحروب، بينما حافظت في الوقت نفسه على روح التفاؤل والتمسك بالحياة والجمال.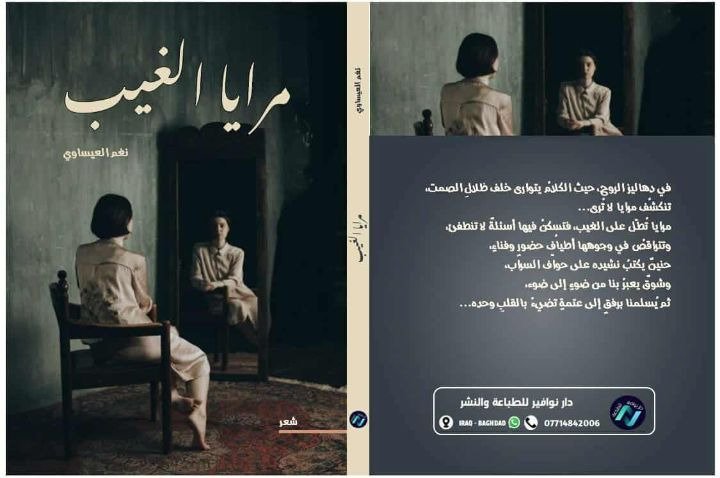
هذه الثنائية بين الألم والأمل كانت سمة بارزة في شعرها، مما جعلها واحدة من أبرز الأصوات النسائية في الأدب العربي المعاصر.
وهي الثنائية ذاتها التي صاغت بها الشاعرة العراقية نغم العيساوي منجزها الشعري مرايا الغيب
الاستراتيجية السيمولوجية لإنتاج المعنى في مرايا الغيب
يتيح عنوان ديوان العيساوي “مرايا الغيب” إمكان قراءة معمقة تستند إلى منهج سيمولوجية القراءة كما بلورها ميشيل أوتن، في إحدى أشهر دراساته؛ حيث لا يُقارب العنوان بوصفه لافتة دلالية محايدة، بل باعتباره عتبة نصّية تُؤسس لحقل من التوقعات القرائية وتفتح أفقًا من التوتر بين الدال والمدلول، إنّ حضور مفردة “مرايا” يوحي بآلية انعكاس؛ أي علاقة جدلية بين الذات والنص، بين الظاهر والباطن، وترسخ لحتمية وجود اليد القاطعة لمسافة ما بين العتمة والضوء، في حين أن “الغيب” يحيل إلى منطقة عصيّة على التعيين، تُقاوم الامتلاك وتؤسس لمعنى مؤجَّل ومعلَّق، ومن ثم يتبدّى العنوان باعتباره بناءً مزدوجًا؛ مرآويًا يتمثل في غواية الوضوح، وغيبيًا يكرّس الإيهام ويقذف بالقارىء إلى منطقة رمادية من التخييل.
وفق مقاربة أوتن، فإن القراءة هنا تتأسس بانفتاح العلامة على شبكات دلالية تتجاوز معطياتها المباشرة، فـ”المرايا” ليست مجرد سطح عاكس؛ بل علامة سيميولوجية تستبطن فعل القراءة ذاته، حيث القارئ يعيد إنتاج النص بوصفه انعكاسًا لتجربته، أما “الغيب”، فيعمل على خلخلة هذا الوضوح، ويمنح النص كثافة إيحائية تشحن الخطاب الشعري بطاقة رمزية، لذا فإنّ هذه الجدلية بين الشفافية والإيهام تؤسس لما يسميه أوتن “اقتصاد المعنى”، أي التوازن بين ما يُمنح وما يُحجب.
من هذا المنظور، لا ينغلق العنوان على دلالته الأولية، بل يستدعي قارئًا يتشابك مع النص عبر سلسلة من الاستنباطات والتأويلات.
“مرايا الغيب” ليست مجازًا تصويريًا فحسب بل هي علامة فوق-نصية، تُلخّص استراتيجية شعرية ترتكز على إنتاج المعنى من خلال مفارقة دائمة بين المرئي واللا مرئي، الموجود حتى وإن كان غائمًا والمتوقع حتى وإن لم يأت!
من ثم يغدو العنوان هنا عتبة لا تقدم ضمانًا للمعنى، بل تُعلن منذ البدء أنّ النص محكوم بفتنة الغياب وحوارية ذلك التعدد الدلالي.
وعبر مقدمة نثرية موحية تحاول الشاعرة خلالها تقديم رحلة إنسانية من المهد إلى اللحد، وكأنها تمهد أن يكون كتابها الشعري المحتوي على بضع وستين قصيدة حياة كاملة بين العشق الإلهي والانجرار في دوامات الحياة الدنيا فتقول:
في دهاليز الروح حيث الكلام يتوارى خلف ظلال الصمت، تنكشف مرايا لا ترى، مرايا تطل على الغيب، فتسكن فيها أسئلة لا تنطفىء،
ثم ننتقل بين دفتي العمل نحو تعميق ذلك الشعور بمحاولة الشاعرة الانفلات بكل ما هو أرضي والالتصاق بما هو سماوي، تلك المراوحة بين ثقل الجسد وانعتاق الروح تتبدى لا بوصفها تنصلا للنفس المأزومة بقد كونها محاولة التحرر ورفض استقبال الصمت كسجن بقدر كونه فسحة من التأمل بين الذات وضدها
من أبرز الأمثلة نجد ذلك المقتطف من قصيدة
تراتيل الصمت
في صمت يفوق الصمت
تتبدد حروف اليقين
وتنهار أبراج المعنى التي شيدها غرور العقل
فلا يبقى سواي
عارية أمام فراغ أزلي
يعلمني أن الوجود أعمق من كل تعريف
في مقاربة هذه القصيدة من منظور سيمولوجية القراءة السالف الإشارة إليه، يمكن النظر إلى النص بوصفه اشتغالًا كثيفًا على توتر العلامة بين الحضور والغياب، فالتكرار المراوغ لمفهوم الصمت، منذ المطلع “في صمت يفوق الصمت”، لا يكتفي بوظيفة الإيحاء؛ إنما ينهض كعلامة ميتانصية تستبطن فعل الكتابة ذاته، هنا لدي العيساوي، إذ يتحوّل الصمت من دالٍّ على الفراغ إلى فضاء مولِّد للمعنى، إن هذا “الصمت” يمسي بنية نصية تضع القارئ في مواجهة المفارقة؛ كيف يُمكن للصمت أن يتكلم بل وأن يترنم ويرتل أي يصدر نغمات محددة لا تضل الأذن سماعها!
وأن يتجاوزه النص أيضًا؟
وفقًا لميشيل أوتن؛ فإن القارئ هنا لا يُستدعى إلى تلقي دلالة مكتملة، بل إلى ممارستها عبر انفتاح العلامة على الاحتمال والتأجيل. يتبدّى ذلك في صورة تشي بالتشظي والتشرذم “تبدد حروف اليقين”، حيث تنسف القصيدة سلطة اللغة وتُفكك استبدادها، كاشفة عن عجزها أمام تجليات الوجود، إن انهيار “أبراج المعنى” التي “شيدها غرور العقل” يشير إلى تفكيك البنية العقلانية المهيمنة، بما هي إنتاج رمزي يطمح إلى الثبات، لكن القصيدة كنصل حاد يعرِّي زيفه، ليظهر المعنى، وأنه ليس سوى بناء كرتوني ينهار أمام خبرة الوجود القصوى، بل القاسية في أحكامها، هنا يتجلى ما يسميه أوتن بـ”اقتصاد المعنى”؛ أي ذلك التوازن الدقيق بين ما يقدمه النص من إشارات وما يحجبه، بحيث يتولد فعل القراءة من هذه الجدلية.
إن اللحظة المفصلية للقصيدة تظهر في إن اللحظة المفصلية للقصيدة تظهر في انكشاف الذات “عارية أمام فراغ أزلي”، إذ يتحول الغياب ذاته إلى حضور كثيف، والفراغ إلى نص بديل يُنتج معرفة وجودية لا تُصاغ بالكلمات وإنما بالمباغتة، على هذا النحو، تُمثل القصيدة انتقالًا من وهم المعنى اللغوي إلى تجربة ميتافيزيقية تُفضي إلى “تعريف” جديد للوجود؛ إنه أعمق من كل تعريف فلا ترهقوا أنفسكم في ملاحقته؛ بل اهربوا إلى ذواتكم علكم تجدونه هناك يقرع وينتظر، وهنا تكتمل دائرة القراءة السيميولوجية، إذ تتجاوز العلامة وظيفتها الإشارية؛ لتصبح أثرًا مفتوحًا يجادل القارئ، ويُدخل النص في حوارية لا تنتهي بين القول والصمت، بين ما يُرى وما يُحجب وإنما بين الواقع الغائم والغد المجهول