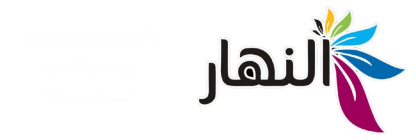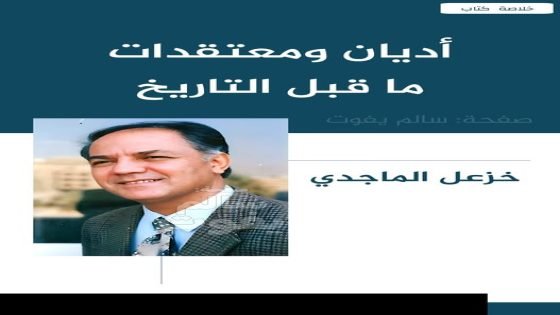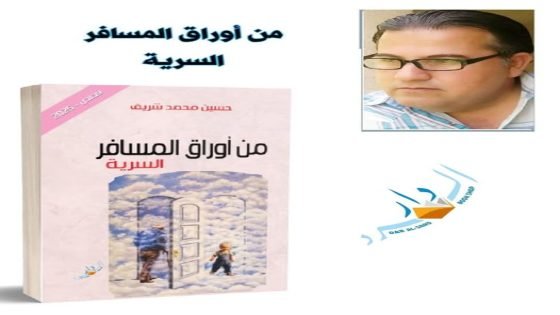“يرى د. خزعل الماجدي أن تاريخ الأديان هو في جوهره تاريخ الروح الإنسانية منذ بداياتها الغامضة وحتى تشكّلها الحضاري.
فالإنسان، منذ أن انتصب على قدميه وغادر الغابة، حمل معه بذور الحسّ الديني والرهبة والدهشة أمام الوجود.
يسعى الكتاب إلى إعادة بناء المشهد الروحي لإنسان ما قبل التاريخ عبر تتبع رموزه وآثاره ومعتقداته، ليبرهن أن الدين ليس طارئاً على الوعي الإنساني، بل هو أقدم أنماط التعبير عن الذات والكون والمقدّس.
هذا العمل يشكّل المقدمة الفلسفية والأنثروبولوجية لتاريخ الأديان كلّه، إذ يربط العصور الحجرية بعصور الميثولوجيا والحضارة الأولى، وصولاً إلى الديانات التوحيدية الكبرى، بوصفها امتداداً لتجربة إنسانية روحية طويلة ومتطورة.
المحاور الرئيسية
- الدين كتاريخ للروح
ينطلق الماجدي من قول الشاعر سان جون بيرس: «لا تاريخ إلا تاريخ الروح»، ليؤسس لرؤية تعتبر الدين أعمق أشكال التعبير عن الوجود الإنساني.
فالتاريخ الحقيقي، في نظره هو تاريخ التجربة الروحية للبشر، تلك التي تتجلى في الطقوس، الرموز، المعتقدات، والخيال الأسطوري.
الدين، إذن، هو «الخزان الأكبر للروح البشرية»، حيث تجمّعت فيه أرقى مكاشفات الإنسان لذاته وللكون.
- عصور ما قبل التاريخ: من الإنسان الصياد إلى الإنسان المتأمل
يُقسّم الماجدي دراسة الأديان البدائية بحسب العصور الحجرية:
العصر الحجري القديم: حيث ظهرت بوادر الإحساس بالمقدس في الدفن والرموز الحيوانية والخصب، وتمثلت في عبادة الأم الكبرى والطوطم الحيواني.
العصر الحجري الوسيط: اتسعت الرؤى الروحية وبدأ الإنسان يربط الطبيعة بقوى غيبية متجددة، فظهرت الممارسات السحرية والطقوس الجماعية.
العصر الحجري الحديث (النيوليتي): مع ظهور الزراعة والاستقرار، تحوّل المقدس إلى إلهٍ محليٍّ حامٍ للخصب والمطر والنبات، وبدأت ملامح التنظيم الكهنوتي الأولى.
العصور المعدنية: شهدت تبلور الرموز الكبرى للإله والسماء والشمس، وكانت تمهيداً مباشراً لأديان الحضارات الكبرى في سومر ومصر.
هذا التسلسل يبيّن أن الدين لم يكن وليد الخوف فحسب، بل هو نتاج الوعي التدريجي بالكون وبالموت وبالأمل.
- من أديان الطبيعة إلى أديان الحضارة
بعد استعراض الأديان الحجرية، ينتقل الماجدي إلى ما يسميه «العصور التاريخية للأديان»:
حيث بدأت الألوهية تتخذ ملامح أكثر تحديداً، وتظهر المؤسسات الدينية والنصوص المقدسة والأساطير الكبرى.
ويربط المؤلف هذا التحول بظهور الكتابة، معتبراً أن الكتابة كانت لحظة وعي ديني عميق لأنها سمحت بتدوين كلمة الإله، وتحويل الروح إلى نصّ.
من سومر إلى مصر القديمة، ومن حضارات الشرق الأدنى إلى الهند واليونان، تتشكّل ما يسميه الماجدي “الشبكة الروحية الكبرى”.
- الأديان البدائية المعاصرة بوصفها مرايا للماضي
لا يتوقف الماجدي عند الماضي فحسب، بل يرى في الأديان البدائية المعاصرة (الإفريقية، الأسترالية، والأمازونية) شواهد حيّة على أنماط التفكير الديني الأولى.
فهي تحتفظ بـصور بدئية للروح والطقس والرمز، يمكن من خلالها إعادة فهم كيف كان الإنسان الأول يعيش صلته بالمطلق والطبيعة والمجتمع.
- المنهج: قراءة الآثار وتأويل الرموز
يعتمد المؤلف على منهج أنثروبولوجي – تأويلي يجمع بين علم الآثار وتاريخ الفن وعلم الأديان المقارن.
فهو لا يقرأ الأدلة المادية قراءة مادية فحسب، بل يسعى إلى استنطاقها روحياً: أي النظر إلى الرسوم والنقوش والكهوف كـ«نصوص مقدسة صامتة» تعبّر عن دهشة الإنسان الأولى أمام الكون.
الخلاصة النهائية
يمثل «أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ» مدخلاً تأسيسياً لفهم الأديان بوصفها تطوراً للوعي الإنساني لا مجرد منظومات طقسية.
يُعيد الماجدي الاعتبار إلى الإنسان البدائي كمبدع للرمز والمقدس، لا ككائن خائف من المجهول فقط.
فالدين، في رؤيته، هو السيرة الخفية للروح الإنسانية منذ البدء — رحلة الإنسان من الدهشة إلى العبادة، ومن الطوطم إلى الإله، ومن الرمز إلى الكلمة.
يجمع الكتاب بين الأنثروبولوجيا، والفلسفة، والشعر في محاولةٍ واحدة لاستكشاف أصل الإيمان الإنساني وجذوره العميقة في قلب التاريخ والروح.”