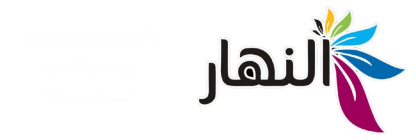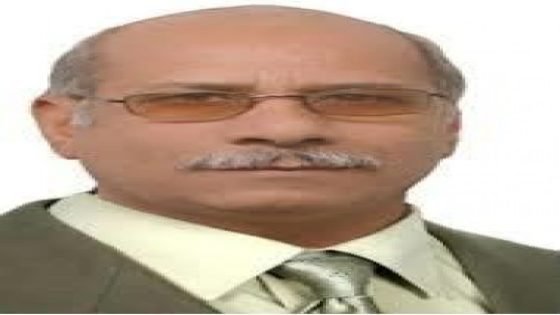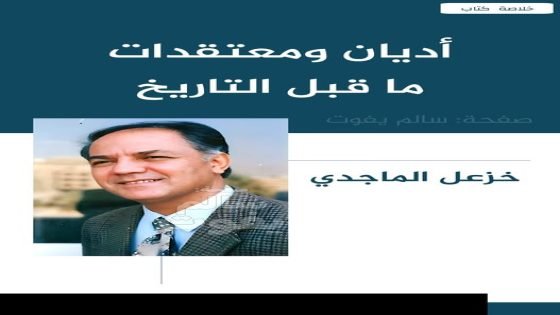في رواية (نوائح سومر) للروائي عبد الستار البيضاني، والصادرة ضمن منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، تبدو وكأنها استدعاء الماضي، من خلال عملية مقاربة إزاحية للعنوان، وإنّها أي الرواية ستكون مهتمّة بتلك النوائح التي تعني الكثير للمتلقي العراقي الذي جبل على (النواح)، ولهذا قد يجد جذبًا عاطفيًا في هذا العنوان، لكن المتلقّي سيجد أن العنوان لم يكن بابًا رئيسيًا للرواية يدخل منها المتلقي إلى مدينة الرواية، ولم يكن يافطةً عليا معلّقةً للاستدلال على جاذبية العنونة فحسب، بل هو المصير الأخير أو الباب الخلفي لفكرة الرواية. فالمتلقي سيبحث عن جمع النواح في النوائح وهو المجبول على النواح على كل شيء بدءًا من ولادته، حتى مماته وما بينهما من سلسلة طويلة من النوائح. لتبدأ اللعبة السردية في الرواية من الاستهلال، حيث يضعنا البيضاني على لسان راوٍ المنيب عنه بصيغة المتكلم، يضعنا في فترة زمنية ومشتغلاً على المستوى الإخباري في التنويه الأولي لعمليات التفكيك المتصلة بالعنوان من لحظة الدخول الأولى:
“خرجت مسرعًا من بيتنا باتجاه الشاعر العام وأنا حائر، وقلق، أين أضع الدرهم الذي منحه لي والدي؟”
في الزمن الخارجي للاشتغال السردي يتبين من كلمة (الدرهم) حيث سيكون محصورًا بين الستينيات والسبعينيات، حيث كان الدرهم في العيد يساوي راتبًا، أو أنه عيدية كبرى كما هو الوصف الحكائي في الرواية.
تنبني الرواية على أساس فعل الطفولة الأول. النظر إلى العالم المحيط. استدعاء الزمن كله الذي عاشه بطل الرواية / الراوي. ليكون مهادًا للصراع والفعل الدرامي، محاولة لتأطير استغلال الطفولة التي تعطي تفاصيلها القلقة من خلال الفصل الأول أو القسم الأول حيث قسم الروائي اشتغالها على خمسة عشر فصلًا، تشتغل على استدعاء الماضي أو أنها تفكك الماضي برؤية ثلاثة عيون. العين الأولى هي عين الطفل الذي أهداه أبوه درهمًا. وعين الصبي/ الشاب الذي يسمع ويرى ويراقب الحياة ويجمع الذاكرة لوجوه وأصدقاء وأفكار وشخصيات عديدة، والعين الثالثة هي عين الشاب الذي دخل الحرب. وهذه العيون تجمعها عين واحدة هي عين الراوي الذي يسرد كل ما له علاقة بالأحداث التي تمتد على مساحة الزمن الطويلة التي انفرشت على خمسة عشر فصلًا من فصول البحث عن صيغ الرسم الأولى للحالم العراقي الذي يبدأ مع الولادة وينتهي مع الممات بل ويستمر بذلك النواح الذي صار (نوائح) بتعدد الأشخاص والأماكن والأزمنة والذي له امتدادات القبول والمعارضة والقناعة والتمرد. فيذهب السرد في متنه الحكائي إلى استدعاء الشخصيات العديدة التي تحفل فيها الحكاية. فينشر الاشتغال على المستوى التصويري الوصفي لما هو كائن في المكان والموضح للزمان:
“المحلات في هذا السوق عبارة عن صرائف مبنية من أعمدة الخشب، والبواري” (ص 8). ومن ثم تظهر الشخصيات الأولى التي تربط بصبغة العنوان ودلالته ليست التاريخية بل هو الربط الأسطوري:
“على الدكة تصف وحيدة بضاعتها يوميًا بشكل ثابت لا يتغير، قدر المنيوم كبير مليء باللبن الناشف الذي يبدو وكأنه طافح إلى الأعلى مثل رغوة مسحوق غسيل متجمدة” (ص 9).
إن التحولات التي تبث في المبنى السردي والتي تعتمد على ذات المستوى الإخباري المتسيد من قبل الرواية هي محاولة لربط الأحداث بماضيها وحاضرها الذي تعيشه الشخصية المتكلمة / الراوية، والمتنقلة بين العيون الثلاثة، حيث الولوج إلى ارتباطات الناقع المغمّس بين الاجتماعي والسياسي والمرتبطان بالنواح حيث يتم نزع ثياب الواقع للكشف عن الألم الذي ينتاب القاع. والذي يأتي مرة على شكل متن حكائي ومرة على شكل حوار الذي كان واحدًا من أعمدة الاشتغال السردي المرتبط بالنظر الخاص لهكذا (واقعيات):
“- الوحدة، والحرية، والاشتراكية.. هذه أهداف مترابطة جدليًا… طبعًا أنت تعرف معنى جدلي؟
نعم.” (ص 52)
ولهذا يكون الاشتغال عبر التنقلات الزمنية، مرتبطًا بما تمتلك العيون الثلاثة من عمليات مواربة وكاشفة وطافحة بالواقعية تمامًا. وهي تنقلات لا تريد الكشف عن الواقع بطريقة من يريد أرشفته أو جعله وثيقة مجردة بقدر ما يريد الكشف عن مسامير هذا الواقع في التأثير على عملية النواح. فالمتن الحكائي يسير بذات الاتجاه الذي يسير عليه المبنى السردي، والعكس صحيح. لأن الحكاية هي لب الفكرة والفكرة هي نتائج استخلاص التفاعل المادي والمحسوس في تراتبية العلاقة في عملية نمو الصبي الذي يتم الكشف عن (أزمانه):
“تغير كل شيء في المكان، إلا دكان علي الكردي، بقي شاهدًا على أثر كان هنا، مثلما بقي عليّ نفسه” (ص 97).
ولهذا نجد أن التصاعد الدرامي محكوم بالتصاعد الحكائي، والتصاعد الحكائي محكوم بتنوع الصراع، والصراع مرتبط بالشخصيات وتنوعها. وكلها الشخصيات والأمكنة والأزمنة التي تنقل من مرحلة (الدرهم) إلى الحرب وما تلاها من متغيرات تصب في صالح التصاعد أو تطور الأحداث، وهو الأمر الذي ينعكس على المستوى الإخباري الذي يبقى في حالة مراقبة لمجريات الأحداث ذاتها وبذات اللغة التي تريد ربط الظاهر بالمخفي فيما لم يره أحد من قبل من هذه الفاصلة الزمنية. وهي ارتفاعات سردية تقود إلى جلوس الفصل السردي على مكانة مرتفعة من رؤية المشاهد الكلية التي لها ارتباط بالتصاعد الدرامي والأحداث التي تجعل هذا التصاعد هو الغاية:
“بظهور نتائج الامتحانات الوزارية للدراسة الإعدادية، ومعرفة المعدلات التي حصلنا عليها. انتهت مرحلة الأحلام والطموحات المعلقة في الهواء، وبدأت مرحلة التعامل مع الواقع.” (ص 120)
عن هذه الفاصلة الزمنية هي فاصلة المتغير في البحث عن لحظة التفاضل بين الماضي للشخصية والماضي للواقع. وهي لحظة احتكام كلية في المرايا القادمة بعد أن كانت مرابطة المتن الحكائي ترتبط بالماضي. حيث نجد أن الحوارات ذاتها هي مقياس حجم الواقع مثلما هي مرايا السرد وتطوراته السيكولوجية:
“في هذه الأثناء دخل زبونان من أبناء المنطقة نعرف قربهما من الملة هاني، أراد عيسى أن يستأذننا بأن يحلقهما قبلنا، لكن ناظم قاطعه:
غدًا ننهض مبكرين.. لا نستطيع التأخر أكثر…” (ص 147)
مهارات السرد
عبد الستار البيضاني يجيد اللعبة السردية من خلال ارتقاء بمنسوب الصراع. ومن خلال تأطير الواقع بالدراما، وجعل الفاعل الفكري هو الحاصل النهائي. فالرواية لا تقاس على أنها رواية احتجاج فحسب بل هي نقل المرايا من واقعها المخفي إلى جعلها مرايا تتحرك في الشوارع لكي يراها الجميع. ليقول لهم أنه لسان حالهم. وأن البطل والشخصيات الأخرى هي أنتم جميعًا. ولهذا نجد أن المستويات السردية اتخذت عددًا من النقاط:
أوّلها: المستوى الإخباري الذي كان هو البطل الأول بين المستويات السردية الأخرى. كون الرواية لا تنبني على أساس البعد الرمزي بل إلى أسطرة الواقع ليكون أكثر دقة في التوصيف (النواح)، فهو معني بالأخبار لكي يطارد النواح في العلاقات وتطورها. في المأساة وتعاليها، في الخفايا وثقلها، في الواضح منها وقوته.
“ليل أيام الإجازة كان أصعب من النهار بالنسبة لي، كنت أحاول أن أقضيه في البيت، غير أن بيوتنا الضيقة، تكون خانقة في ليالي الصيف.” (ص 190)
ثانيها: المستوى التصويري الذي يبقى روحًا داخل المستوى الأول، فالمتن الحكائي يتابع ويراقب ويستلّ، لذا يبقى المستوى التصويري فاعلاً في الإتيان بمساحة الزمن وتوضيح المكان:
“تكاد تكون حديقة المستشفى هي الحديقة الوحيدة في المدينة، أنشئت مع بناء المستشفى الجمهوري في منتصف الستينيات.” (ص 65)
ثالثها: المستوى الدرامي الذي يمنحه الإخباري قامة الحضور من خلال تصاعد الأحداث ذاتها المرتبطة بالشخصية الرئيسية منذ طفولتها على (عسكرتها) وانشغالها بالصراع السياسي والديني والفكري ومحاولة توضيحه لكي هو المحتوى العام المؤدي إلى الربط مع النواح بسلسلة من الأحداث المتتالية، وخاصة الصراع السياسي كونه هو الذي يعطي المدد الزمنية ويعطي تغيرات الملح المكاني:
“حتى دبابات الانقلابيين لم تستطع المرور في الشوارع، إلا بعد أن خدعت الجماهير برفع صور الزعيم عليها للإيحاء بأنهم من أنصاره وضد المؤامرة.” (ص 104)
رابعها: مستوى النهاية الذي يكون هو عقدة الرواية في متنها الحكائي ومبناها السردي. وهو مستوى قاد كل العمليات الأخرى للوصول إلى البوابة الخلفية للعنوان/ حيث الكشف عن النواح ليس بدلالته الواقعية الموجودة أصلًا في الجمل (النائحة) أو السرديات في المستوى الدرامي بل لارتباط النواح بالجذور السومرية أيضًا، حيث يتم التداخل:
“يا يمة الحلو للموت زفيته
يا يمة الأخو للموت زفيته.” (ص 246)

وهذا يقود إلى الواحد الكلي الذي يعطي مفاتيح الدخول بين ظلفتيه العنوان لتبيان الأثر التفاعلي. لكن صوتيهما كان يضيع بصدى “أحاا.. حااا.. أنفاسي كانت تتسرع مع إيقاع.. أحاااا… أأحاااا.. آاااخ…” (النهاية)
إنها رواية وإن بدأت بصوت واحد، لكنها نقلت أصوات الزمن المتغير على ذات المكان المتنقل والذي أخذ مساحة العقود وجبر الخواطر والتعامل العاطفي مع الإرث الحزين الذي يتداخل مع الشخصية العراقية. لتكون نوائح سومر وكأنها مرآة للجميع يمكن أن يرى الآخرون حكاياتهم فيما إذا ما سلطوا ذاكرة المرايا أمامهم تحت هدأة التفكير، ليكون المسكوت عنه مباحًا، ويكون حاصل جمع المرايا خيبات المواطن الممتدة من الأسطورة إلى الأسطرة.